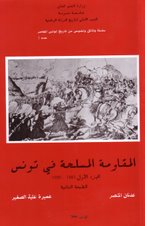Merci à Bassem et à crazyfrog d'avoir réagi à un article qui traduit plus une exaspération et une révolte qu'une réflexion sur la question. j'admets que je suis allé un peu loin dans cette expression d'éxaspération, et que j'ai failli jeter l'enfant avec l'eau du bain... vos réactions me donnent envie de revenir sur cette problématique, pour rectifier le tir... une chose est pourtant sûre, la réflexion sur ce genre de questions n'est jamais définitive...
La réaction de Bassem Khlaf
http://bassemkhlaf.space-blogs.com/
Si je savais quelque chose qui me fut utile et qui fut préjudice à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fut pas à ma patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et que fut préjudiciable à l’Europe ou bien qui fut utile à l’Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. MONTESQUIEU Cher Adnan, Je viens de lire ton exaspération et ta révolte contre la mondialisation. Et contre une certaine élite, qui se dit « très moderniste » qui a vendu son âme à un occident, qui n’est pas disposé à faire aucun effort, pour aider les opprimés contre des pouvoirs tyranniques.Le ton était fort et dur, ce n’est pas ton style. Et peut être c’est ce qui explique un certain simplisme dans ton exposé.Est il judicieux d’hiérarchiser, voir d’opposer les droits ?Qui décide que la cause des homosexuels est ou non une priorité ?Posons la question à un homo. Et voyons ce qu’il pense. A moins qu’on considère qu’i s’agit d’une infime minorité, et que les droits se traitent en fonction du nombre des opprimés. C’est généralement l’attitude de l’homme politique. Et le rôle de l’intellectuel est justement de lui rappeler, qu’il s’agit là d’un aveu d’échec.Je comprends ton exaspération vis-à-vis d’une pseudo élite, qui justifie tout acte, toute position et toute proposition du moment qu’elle provient de l’occident. Seulement, ce n’est pas pour autant qu’il faut jeter le bébé avec l’eau du bain.Les droits ne sont guerres opposables. Là une leçon que l’occident qu’on aime, qu’on prenne pour exemple, l’occident des lumières nous a donné.Je comprends aussi, cher Adnan, ta révolte contre une mondialisation sauvage, capitalistique, ou l’intérêt des maîtres du monde prime sur tout le reste. Par leurs égoïsmes et leurs ignorances, on assiste à la destruction pure et simple de ce monde. De la terre.Faire ce constat est une chose. Appeler à un retour en arrière en est une autre.Qu’on le veuille ou pas, La mondialisation s’est installée et pour un bon moment. C’est le sens de l’histoire. Refuser cette réalité, revient à se condamner à rester à la marge de l’histoire. Et être sujet de cette mondialisation et jamais acteur. Montesquieu, disait dans son chef d’œuvre DE L’ESPRIT DES LOIS : « considérés comme habitants d’une si grande planète, qu’il est nécessaire qu’il y ait différents peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux ;et c’est le DROIT DES GENS. Considérés comme vivants dans une société qui doit être maintenu, ils ont des lois dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés ; et c’est le DROIT POLITIQUE. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux ; et c’est le DROIT CIVIL. »
Depuis, l’homme a fait du chemin, comme il ne l’a jamais fait dans son histoire. Et cette « si grande planète » comme disait Montesquieu est devenu un petit village.Il est évident qu’on s’achemine vers un ordre mondial ou le DROIT DES GENS n’aura plus raison d’être. C’est dans cette optique qu’il faut raisonné. Montesquieu d’aujourd’hui, aurait dit : Si je savais quelque chose qui me fut utile et qui fut préjudice à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fut pas au MONDE je la regarderais comme un crime.
La réaction de crazyfrog
http://exipestien.blogspot.com/2007/09/propos-de-la-mondialisation.html
A propos de la mondialisation
Après la lecture de l'article de Mr Adnen Mansar à propos de la mondialisation, je me permet d'exprimer mon avis et ma perception vis à vis de cette mondialisation. Elle n'est pas à mes yeux une incarnation diabolique comme tend à exprimer Mr Mansar, mais une manifestation d'une certaine accélération de l'histoire humaine, basée sur l'information.
La mondialisation ne représente qu'une étape -celle en cours- de la globalisation: un énorme processus évolutif qui a commencé à l'aube de l'humanité et qui n'a cessé d'agir de manière transparente et inaperçue jusqu'à ce qu'il est devenu assez marquant, définissant ce que nous appelons "mondialisation". Ce processus est traduit par une tentation continue à franchir les barrières "naturelles" et ethnique, à connaitre les autres, à les dominer.. Je prend ici, à titre d'exemple loin d'être restrictif, les conquêtes d'Alexandre le Grand: ne s'inscrivent elles pas dans cette vision globalisante et dans cet énorme processus d'évolution des sociétés?
L'Homme n'a pas cessé ses mouvements à travers le monde. Différentes civilisations et différentes cultures se sont rencontrées. A chaque fois, c'était la conquête et la guerre les principaux moteurs de ces échanges. A chaque fois, il y avait des interaction culturelles qui ont marqué plus ou moins sérieusement les groupes concernées et participé à l'évolution des traditions et des moeurs. L'identité d'une société n'est alors que le résultats de siècles d'évolution et une combinaison d'apports d'origines assez complexes, et elle ne cessera d'évoluer. La notion d'identité, à caractère nationaliste, n'a eu droit à ses moments de gloire que grâce à une instrumentation politique visant à réunir les foules autour de l'idée d'une destinée commune, alors que les réalités historiques sont plus que réfutant cette justification.
Ce qui marque la mondialisation en tant qu'étape historique de la globalisation, c'est l'avènement des "nouvelles" technologies de l'information. Commençant par le téléphone et le télégraphe et finissant par Internet et ses différents paradigmes, ces moyens ont réduit de façon plus que significative le temps que prend une information pour arriver, notamment aux décideurs, chefs de guerre, dirigeants d'entreprises..
L'information est au coeur de cette mondialisation qui en tire son énergie inépuisable. Elle a toujours été le moteur de l'histoire humaine même. C'est la vitesse de passage de cette information qui détermine notre perception du temps, donc de l'histoire. Si on a l'impression aujourd'hui que le temps s'écoule plus rapidement qu'auparavant, c'est parce que notre conscience traite un nombre énorme d'informations par rapport à ce qu'il en était usage. Si on admet que les actions humaines sont des réactions par rapport aux informations qu'on reçoit, on pourrait imaginer l'accélération de l'histoire que cela pourrait engendrer. Pour illustrer, imaginons un échange entre deux leaders, loins l'un de l'autre de quelques milliers de kilomètres. L'un voulant imposer des conditions à l'autre afin d'avoir un pretexte de déclarer une guerre dès que l'autre commet une faute à son égard. Plaçons la situation dans deux époques: la notre et 5 siècles auparavant .. Le temps que prendrait l'échange de lettres -avant une déclaration de guerre - dans l'époque lointaine pourrait s'étendre sur des mois.. Alors qu'à notre époque, il suffit d'échanger quelques pauvres "sms" en quelques minuscules minutes pour pouvoir le faire.. Bien sûr, ce n'est qu'une illustration simpliste et ironisante. Regardez l'exemple de la "petite" crise boursière le mois d'août, si les informations concernant la chute des prix de l'immobilier aux Etats Unis ne s'étaient pas propagées avec une telle vitesse et une telle ampleur, serait on passé par cette crise? certes non! Nous sommes ici face à une compression du temps, ou plutôt une intensification des actions humaines dans le temps.
La mondialisation n'a fait qu'accélerer l'histoire, ce qui se passait durant des siècles se passe aujourd'hui dans quelques heures. Dans un monde ou tout se virtualise de plus en plus..