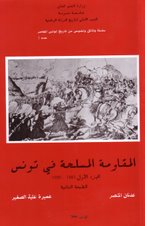في "مقام الرفق"
عدنان المنصر
مقال صادر بصحيفة الموقف بتاريخ 19 جوان 2009
في تفاعلها على مقالي الصادر على جزئين بالموقف تحت عنوان "في مقام الحيرة"، تعرضت الصديقة رفيقة البحوري إلى بعض النقاط التي شدت انتباهها ملاحظة حصري النقاش مع مؤلفة "حيرة مسلمة" في فضاء الأفكار بتقديم قراءة فيها الكثير من "اللطف والمنطق". قدمت الصديقة رفيقة البحوري قراءة لقراءتي فوجدتني حائرا أنا أيضا، ربما كان ذلك من حقها. جاء مقالها كلاما على كلام على كلام، وهو تمرين صعب لا أظنه متاحا لكثير من الناس. ورغم أننا نختلف قليلا و كثيرا في مقاربة بعض المسائل إلا انها لم تكن أقل رفقا بي مفضلة النقاش الرصين على إغراء التشخيص.
نعم، بإمكان المرء أن يختلف مع كل الناس أو مع جزء منهم في مقاربة مسألة ما غير أن المحافظة في خضم هذا الاختلاف على الاحترام الواجب للمختلف هي الرياضة الأصعب. ذلك أن في الأمر قدرا من التجرد ليس متاحا للكثيرين قوامه الفصل بين الفكرة وصاحبها، وهو من هذا المنطلق سباحة ضد الجاذبية وتنسيب للتناقضات ووضع لها في إطارها الطبيعي الذي يجب ألاّ تغادره تحت أية دواع مهماسطا إغراؤها .
كم يحتاج كثيرون إلى من يقدم لهم المثل في احترام الآخر والتعايش مع الاختلاف وربما التناقض، لأنه لا بديل مضمون العواقب لذلك سوى الإقصاء والعنف وربما لاحقا القتل. من هو القاتل في الأصل؟ إنه ذلك الممارس للإقصاء في شكله الأكثر حيوانية، يعتقد أن التناقضات تزول بمجرد غياب المتناقض معهم. يمارس كثير من الناس هذا النوع من القتل كل يوم أحيانا وينام بعضهم قرير العين بعد ذلك، دون أن يخطر بباله أنه يستحق عقابا ما أو أن ما أتاه يستدعي إحساسا ولو عابرا بالذنب.
من الواضح أن تقلص الفضاء العمومي يجعل من مناقشة هذا الصنف من القضايا أمرا كثير الهامشية رغم مركزيته في عملية بناء وعي التعايش، وهو ما يجعل كثيرا من المهتمين بهذا الشأن يلجؤون إلى الفضاء الافتراضي، على الفايسبوك أو غيره، وهي عملية تعويض لا تغني من الواقع المعيش لمسائل التعامل مع الاختلاف شيئا ولا تنبت في صحراء المجتمع أية أشجار ثابتة الأصل. ذلك أنه عندما تكون التربة فقيرة و الانجراف قويا، فإن الصحراء تحتل في كل يوم فضاء كان إلى مدى قريب أخضر مشرقا محولة إياه إلى يباب تعوي فيه ذئاب الإقصاء المتعطشة إلى دماء "الخصوم".
كم نحتاج إلى أن نرفق ببعضنا البعض، ولكن مقام الرفق يحتاج تربية وسلوكا خاصين، وهو منزلة لايدركها إلا من استطاع التخلص من ربقة النرجسية المتعالية. وعلى عكس ما يعتقد كثيرون فإن الرفق بالمختلف لا يمحو الاختلاف بل يضعه في إطاره الطبيعي الوحيد، ذلك أن الهدف منه يبقى دائما التعايش وتفويت الفرصة على ذئاب الفكر الأحادي وضباع الإيديولوجيا المريضة أن تأتي على أخضر المجتمع ويابسه. لا يطلب من أحد أن يتخلى عن أفكاره ولا حتى أن يطرح عنه رداءه الإيديولوجي، بل أن يقتنع فقط أن الخصم ليس شرا مطلقا وأن تعميم الكراهية لا يعد سوى بالخراب.
ينفتح العالم في خضم ذلك كله ويزيد اتساعا، تتزاحم الأجيال على مائدة الإبداع الإنساني فتحقق من الفتوحات المعرفية والإنسانية ما لا ينكره إلا الجاحدون. غير أن مسارا ثانويا ولكن مدمرا يتشبث بتلابيب البقاء وعوض أن يتمتع بشمس الإنسانية ودفء التواصل، يزيد انغلاقا وتقوقعا في أنفاق النرجسية المقيتة والإيديولوجيا الرثة.
إن ثقافة الإقصاء إنكار للحق في الاختلاف، و جحود للطبيعة، ومرض فتاك ينتشر بيننا كانتشار الخلايا الخبيثة في الجسم الغض. يصر البعض على أن لا يرى أعراض هذا الوباء إلاّ لدى الخصوم ويصيح مفتخرا بسلامته وعافيته وحصانته المفترضة ضد جميع الأوبئة، وهذا في الحقيقة من أول أعراض الإصابة. غير أنهم ينكرون إصابتهم بالعدوى ويرفضون التداوي و اتباع أبسط تعاليم الوقاية. في الغالب يفيقون متأخرين جدا وقد يكابرون برفض الفحص حتى في ساعة الاحتضار .كم يبدو الأمر مؤسفا !
كم ينبغي أن يبذل من جهد للإقناع بأن الإصابة ليست وقفا على جمهور دون آخر وأن الصواب والعقل ليسا ملكية خاصة أو أصلا تجاريا؟ ينظر المرء في خطاب بعض القوم فيرى الآليات نفسها، بل المفردات عينها أحيانا، فيتوقع في كثير من الحالات النتيجة الحتمية ذاتها: سقوط مدو في هوة الانغلاق السحيقة. فعندما تنعت أستاذة خصومها "بالجراثيم" ماذا يمكن أن ننتظر من مريديها؟ وعندما ترى بعض "التقدميات جدا" في حرية الملبس والمعتقد "ردة"، ماذا يمكن أن نتوقع من "الرجعيات"؟ وعندما تسام المجموعة كل صنوف الشتائم والتحقير والتسفيه لها ولثقافتها وجذورها بدعوى التخلف عن نخبتها الرائدة، ماذا عسانا نأمل من "الدهماء" المسكينة؟ لو تمعن هؤلاء في دروس التاريخ لرأوا أن هذا السلوك نفسه هو ما منع آباء الفكر لديهم من الانغراس في تربة هي طيبة رغم أنوف الجميع، فضلا عن أن تزهر أشجارهم و تينع ثمارها. لكنها المكابرة الناجمة عن اليأس من مغادرة دائرة الهامشية الضيقة تتحول في الغالب سلوكا انتحاريا على مذبح "الفكر النير". حتما إن الانتحار أقل ألما من الموت البطيء !
يمارس الكل أو بعضه التكفير بدرجة أو بأخرى، ففي حين يرمي جزء من الناس بخصومهم خارج دائرة الإيمان معتقدين أنهم المخولون لمسك دفاتر الجنة والسعير، يقوم آخرون في المقابل بطرد الأولين من فردوس حداثتهم وتنويرهم منكرين عليهم حتى صفتهم البشرية وملحقين إياهم بمرتبة الكائنات المجهرية الخبيثة. مثل وهابية السلفيين تماما، تبدو وهابية الحداثويين جذرية لا تقبل من "الفتاوي" إلا أكثرها تشددا ولا تاريخية، ومثل تكفيريي الضفة الأخرى بالضبط يبدو هؤلاء متعطشين للاستئصال وقد ولغ بعضهم في دماء القوم ردحا من الزمن حتى أصبحوا يتلذذون ذلك، لا يستطيعون من طبيعتهم الثانية تحررا ولا فكاكا.
يضطرب النبض وتتصاعد الحمى ويقاوم الجسد المصاب ماوسعته المقاومة قبل أن يسعف بترياق التعايش، فيبدأ في طرح جراثيم الكراهية وفيروسات الحقد غير المبرر. تتحول الاختلافات إلى طاقة يحيا بها الجسم ويشرق احتراما وتسامحا فيدخل في حضرة الإنسانية الرحبة وينطلق مجددا في مسار إبداعه الخلاق.
أحلم هو أم وصفة-أكسير؟ كم في الهروب إلى أحلام اليقظة من عزاء لكوابيسها المزعجة القاتلة لإرادتنا في الحياة ! وكم من وصفة أهملت لمرارة في الطعم أو لعسر في الابتلاع والهضم أو لأعراض جانبية أخرى فذوت أجساد ومرضت نفوس وتبخرت طاقات وعم خراب.