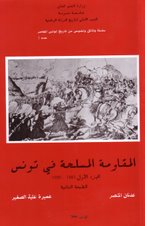الاحتضار المؤلم للديكتاتورية في رومانيا
أعمدة الاستبداد السبعة
عدنان المنصر
: صدر هذا المقال في صحيفة الموقف التونسية بتاريخ 22 جوان 2007 (العدد 411) ولكنه تعرض خلال ذلك لعمليات حذف وقص أثرت على مضمونه. لذلك فإن هذه النسخة هي النسخة الكاملة للمقال وهي التي صدرت بجريدة القدس العربي اللندنية بتاريخ 7 أوت 2007
الرابط:
http://www.alquds.co.uk/index.asp?code=qp18
من المثير ملاحظة التطور الهائل الذي مرت به بعض الأنظمة السياسية التي كانت إلى حد قريب نموذجا متفقا عليه في الاستبداد والطغيان. ورومانيا تشكل بلا أدنى شك مثالا لهذا التطور, فقد انتقلت في فترة وجيزة من دولة تمارس السلطة فيها طغمة تدعي تطبيق الحلم البروليتاري في مجتمع عادل بلا طبقات، إلى دولة ذات مؤسسات منتخبة وذات دستور يسمح بأوسع مشاركة سياسية ممكنة ويضمن كل الحريات الديمقراطية التي تصورتها الليرالية السياسية. فقد رزح الشعب الروماني تحت أبشع أنواع الدكتاتورية طيلة حكم الرئيس الأسبق شاوسسكو لمدة فاقت الخمسة عشر عاما (1974-1989)، ولكن أحدا لم يكن يتوقع سقوطه بتلك الطريقة. ففي ظرف ثمانية أيام، من تاريخ بداية المظاهرات المناهضة له في 17 ديسمبر 1989، إلى تاريخ محاكمته السريعة وإعدامه في 25 ديسمبر 1989، انتهى أمر زعيم احتكر مع زوجته إيلينا كل الوظائف وسام شعبه كل أنواع القهر والمهانة. هل كان نظام شاوسسكو يتوقع أن ينهار بتلك السرعة وهو الذي أعاد المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي انتخابه بالإجماع أمينا عاما له ورئيسا للبلاد قبل بضعة أسابيع فقط ؟
لم يكن الأمر ليتم بهذه السهولة لولا التفهم الذي أبداه بعض أركان النظام الذين فهموا عمق التحولات العالمية في تلك الفترة فسارعوا إلى نفض أيديهم من معلمهم العظيم وقائد البلاد المفدى حتى يتسنى لهم تنظيم العودة إلى السلطة من الباب الخلفي. وهذا السلوك، بالرغم من انتهازيته، يعبر عن نوع من التقليد المتبع داخل الأنظمة القهرية عندما تقع التضحية بوجه النظام ليتسنى استمرار النظام نفسه. صحيح أن الشيوعية لم تعد منذ ذلك الحين تحكم رومانيا، وأن اقتصاد السوق قد غزا بذلك آخر قلاع الاشتراكية، غير أن أولئك الذين سيروا النظام السابق كانوا هم أنفسهم من قيض لهم وضع أسس التوجه المستحدث والإشراف على صياغة دستور جديد يسمح للرومانيين بممارسة ما حرموا منه طيلة عقود من الديكتاتورية المتلثمة بالشيوعية. يبدو هذا السلوك طبيعيا إلى حد ما، فلا يعتقد أحد أن بإمكان المصالح التي استغرق بناؤها وتعهدها حوالي نصف قرن من الزمان أن تذوب بين عشية وضحاها. غير أن ما يلفت الانتباه أكثر في المثال الروماني، وما أكثر الأنظمة التي لا تزال تحذو حذوه في عالم اليوم، أن الديكتاتورية سواء كانت شيوعية أو قومية أو حتى ليبرالية، إنما تقوم على مجموعة من الأسس التي لا يتسنى استمرارها بغير تعهدها وصيانتها، وأهم هذه الأسس على الإطلاق هو الفساد.
ذلك أن أبشع الديكتاتوريات تعلم أنه لا يمكن لها أن تحكم إلى ما لا نهاية باستعمال القوة فحسب. فالقمع لديها ليس غاية في حد ذاته، وهي لا تلجأ إليه غالبا إلا مكرهة وفي أوقات معينة، أما سياسة كل يوم فتقوم على أسس أخرى أقل إكراها تجعل الديكتاتورية أمرا مقبولا به إلى حد ما، مرفوضا ولكن متعايشا معه. إن التخويف بالقمع أهم وأجدى من القمع، لذلك يقع بناء جهاز تسند إليه إشاعة الرعب بين الناس ونشر ثقافة الوشاية بين أفراد المجتمع وأحيانا ين أفراد العائلة نفسها، وهو أمر برعت فيه إلى حد كبير أجهزة مخابرات تشاوسسكو وشرطته السرية وخلايا الحزب الشيوعي. وبما أنه لا يمكن تطبيق نفس القمع على الجميع فإنه يقع انتقاء المعارضين الذين يسلط عليهم أقصى اضطهاد ممكن، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، وليس ضروريا أن يكون ضحايا القمع من أبرز المعارضين بل ينتقون من كل الفئات إذا أمكن، حتى يصل الدرس إلى الجميع. من هنا تتركز شيئا فشيئا القناعة التي مضمونها أن بإمكان أي واقع مهما كانت درجة سوئه، أن يزيد سوءا.
بالموازاة مع هذا المسار، يسعى النظام الديكتاتوري إلى خلق فئة، قد تتوسع لتصبح طبقة في بعض الحالات، من المقربين والمحظيين الذين تناط بهم مهمة التحصيل على درجة معينة من الشرعية للطغمة الحاكمة، وفي مقابل ذلك يسمح لهم الاستفادة من خدمات الدولة وحمايتها، فيشرعون في بناء إمبراطورية المصالح والربح السهل. وفي درجة معينة من تطور هذا المسار، يحصل نوع من الصدام متعدد الزوايا بين النظام السياسي ونظام المصالح ذاك. فإبان الأزمات، وما أكثرها في نمط الحكم الاستبدادي، يشعر جانب من النظام بوجوب التنازل أحيانا وفتح بعض المجال أمام تغيير مدروس يخفف من درجة الاحتقان العامة ويسمح إلى حد ما بتجديد الشرعية المتحللة، غير أن نظام المصالح هو الذي يقف عادة ضد هذا المنحى ويتولى إفشاله غالبا، لأن أي تحرير للنسق السياسي يعني تسليط ضغوط قد تبدأ صغيرة ولكنها سرعان ما تتعاظم، ضده. لا يهدف هؤلاء إلى احتكار أكبر جانب من قوت الشعب فحسب، فهذا لا يرضيهم، وإنما يكون هدفهم التهام كل ما هو متاح وغير متاح، دون اعتبار للمصلحة الإستراتيجية للنظام الذي يفترض أنهم يوجدون معه في مركب واحد. ذلك أن نظام المصالح الاقتصادية يصبح هو نفسه في حالة بناء نسقه السياسي المصغر، فيزيد في التوسع أفقيا ويربط نفسه بمصالح فئات أخرى يلقى إليها بالفتات. وهكذا تتركز إلى جانب الفساد الكبير، الذي تمارسه الفئة العليا من الفاسدين المرتبطين مباشرة بنظام الاستبداد، ممارسة الفساد الصغير الذي يدخل البيوت والإدارات وينتصب على الطرقات. وفي حين يجني المستفيدون من الأول أكبر الأرباح عن طريق الصفقات العظيمة التي يسمح لهم بالفوز بها بتغطية من الإدارة، فإن الثاني يصبح في تطوره السرطاني أخطر وأعم حيث يؤدي في نهاية الأمر إلى تثبيت ليس نظام المصالح الفاسد وإنما نظام الاستبداد أيضا. ويتم ذلك بصورة تدريجية وطبيعية عندما يشعر كل فرد أن القوانين المطبقة وعين السلطة المفتوحة لا تسمح له بحياة طبيعية فيقرر الانخراط هو أيضا في نظام المصالح من موقعه الصغير، وعادة ما يكون المقابل هو تقديم تلك الخدمات الصغيرة التي لا غنى لأي نظام استبدادي عنها وأولها الوشاية.
تغير نمط الحكم في رومانيا بفضل ما أطلق عليه حينها ثورة المخمل ، غير أن الطبقة السياسية لم تتغير إلا قليلا، وبقي نظام المصالح والفساد أيضا في مكانه، وأكثر ما اضطر إليه الجميع هو عملية توزيع أدوار جديدة والتعود على التخلي عن بعض الممارسات القديمة. ذلك أن رموز النظام الشيوعي القديم (وفي مقدمتهم إليسكو الذي سينصب رئيسا جديدا للبلاد) الذين ضحوا بزعيمهم في تلك الثورة ، قد ضمنوا بذلك الحضور الأقوى على الساحة الرومانية الجديدة، وأصبح مسؤولوا الحزب الشيوعي والإداريون القدامى ممثلين بطريقة أكثر من مرضية في النظام الجديد، كما ضمن أصحاب المصالح سيطرتهم على الاقتصاد الروماني المتحرر. ومما يدل على "حكمة" الطغمة التشاوسسكية أن جميع القوانين الهامة التي أحدثت بعد 1989 قد ضمنت استمرار نفس الفئات في السلطة، وخاصة منها النظام الانتخابي الذي يسمح للأحزاب الكبيرة دون غيرها بالولوج إلى البرلمان. وهذا الأمر ليس خاصا برومانيا لوحدها، ذلك أن كل البلدان الأوروبية الشيوعية سابقا تعيش حالة مماثلة، من روسيا إلى بولونيا إلى المجر...إلخ. والفارق الأساسي الوحيد أنه قد استعيض عن الشيوعية التي كانت في السابق غطاء لممارسة الديكتاتورية والفساد بأشكال جديدة من التغطية أكثر نجاعة وقبولا في الظروف العالمية الجديدة.
إن الديمقراطية لا تقضي على الفساد، ولكنها تمكن من أدوات أكثر فعالية لمقاومته. وما حدث مؤخرا في رومانيا يقدم أكبر مثال على ذلك. فقد قامت الحكومة بتنظيم استفتاء شعبي حول استمرار الرئيس الحالي باسيسكو في مهامه الرئاسية بعد أن جمد البرلمان مهامه بمقتضى قانون صادر في 19 أفريل 2007. وأسفر الاستفتاء الذي نظم في 19 ماي عن رفض شعبي(حوالي 75 بالمائة) لإقالة الرئيس المنتخب ديمقراطيا منذ 2004 مما اعتبر هزيمة للأحزاب الكبرى وخاصة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتشكل في معظمه من الشيوعيين السابقين. وقد عاب هؤلاء على باسيسكو بضعة أمور حاولوا تغليفها بطريقة فيها الكثير من "الديماغوجيا الديمقراطية" حيث وجهت إليه تهم من قبيل التدخل في شؤون المحكمة الدستورية، التدخل لصالح بعض الشركات، رفضه تعيين الوزراء الذين تم اقتراحهم من قبل رئيس الحكومة، مشاركته في الاجتماعات الوزارية، التدخل في شؤون البرلمان و التسبب في حالة من عدم الاستقرار السياسي في رومانيا. غير أن ما أغفله البرلمانيون المناهضون لباسيسكو كان الحديث عن حملته لمقاومة الفساد في الحصول على الصفقات الكبرى وسعيه لتوجيه القضاة نحو مزيد من الصرامة إزاء قضايا الفساد ومعارضته الصريحة للسياسات اللاشعبية للحكومة وإعداده لإصلاح دستوري سيقضي إن تم على عهد احتكار الأحزاب الكبرى للساحة البرلمانية، وهذه في ظننا مبررات كافية لسعي البرلمان للإطاحة به.
وبسبب مكافحته للفساد يحظى باسيسكو بتعاطف شعبي عارم من قبل الرومانيين الذين ينظرون إليه بوصفه رمزا لمكافحة الفساد وسوء التصرف. وقد لاحظ الرومانيون كيف عمد رئيس الحكومة تاريسيناو بمساندة من الأغلبية البرلمانية المتوجسة من برامج باسيسكو بإقالة وزيري العدل والداخلية الذين انخرطا بفعالية في مسار مقاومة الفساد، وهو موضوع ذو أولوية بالنسبة للإتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه رومانيا مؤخرا، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية هذا البلد كأكثر البلدان الأوروبية فسادا . ولا يملك رئيس الدولة في رومانيا صلاحيات كبرى بالرغم من أنه منتخب مباشرة من الشعب، في حين يسيطر رئيس الحكومة المعين من قبل الأغلبية البرلمانية على معظم الصلاحيات ولا يكون مسئولا إلا أمام البرلمان. وهو نظام هجين بين النمط الرئاسي والنمط البرلماني أريد منه تحقيق تعادل في الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية.
لا يشك أحد في طرافة هذه الوضعية: رئيس بلا نفوذ حقيقي ينطلق في حملة لمكافحة الفساد بدون صلاحيات واسعة، وحكومة متآمرة مع البرلمان على منع الإصلاحات وعلى بقاء نظام المصالح والفساد، في تجاهل كامل لتطلعات الشعب. وتكمن هذه الطرافة في أننا تعودنا على النظر إلى البرلمان، مبدئيا، بوصفه الممثل للسيادة الشعبية والعامل على تحقيق إنتظارات الناخبين والمتحفز لتصويب ممارسات السلطة التنفيذية والحريص على سيادة الدستور. ولكن الواقع على الأرض يبدو شديد التناقض مع هذا التخطيط النظري. فقد بنت الطبقة السياسية الحاكمة في رومانيا لنفسها من الحصون ما يستعصي إلى حد الآن عن السقوط، وصمودها في وجه محاولات التغيير الذي صادف أن رئيس البلاد يتبناها ما هو إلا رد فعل طبيعي من قبل فئة اعتبرت دائما أن مسؤوليتها السياسية ليست سوى غطاء تحقق من ورائه مصالحها في الإثراء. من هنا فهي تقاوم بكل ما أوتيت من جهد كل محاولات النيل منها ومن مصالحها، بانية في خضم ذلك كل التحالفات الممكنة (التحالف البرلماني المناهض لباسيسكو يضم أحزاب اليمين وأحزاب اليسار وأحزاب الوسط على حد سواء !) ومعارضة أي تغيير في الدستور يقضي على احتكارها للحياة السياسية.
وتبين نتيجة الاستفتاء من جهة أخرى قدرة الشعب الروماني على اتباع أكثر السبل براغماتية من أجل تحقيق طموحاته. فقد نفض هذا الشعب يديه من البرلمان الذي تشكل بفضل دستور ونظام انتخابي على مقاس الأحزاب الكبرى، وقرر مساندة رئيسه في حربه على الطبقة السياسية الفاسدة، لذلك يتوقع مراقبون أن الرئيس باسيسكو الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في 2009 سيفوز فوزا ساحقا في أية انتخابات مقبلة، كما يتوقع أن تنال مساعيه في تحوير الدستور إذا ما وصلت إلى الاستفتاء مساندة شبه مطلقة من الرومانيين الذين سئموا الفساد والفاسدين. ذلك أن الفساد، مثل الاستبداد تماما، يصل في مرحلة معينة من تطوره السرطاني إلى تهديد أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة، فيصبح ابتداع سبل التحرر منه، باستخدام الانتفاضة (مثلما حدث في ديسمبر 1989) أو بالتعبير الديمقراطي الهادئ (مثلما حصل في استفتاء 19 ماي 2007) أوكد من الاحترام الأبله لمؤسسات تخلت عن دورها.
الرابط:
http://www.alquds.co.uk/index.asp?code=qp18
من المثير ملاحظة التطور الهائل الذي مرت به بعض الأنظمة السياسية التي كانت إلى حد قريب نموذجا متفقا عليه في الاستبداد والطغيان. ورومانيا تشكل بلا أدنى شك مثالا لهذا التطور, فقد انتقلت في فترة وجيزة من دولة تمارس السلطة فيها طغمة تدعي تطبيق الحلم البروليتاري في مجتمع عادل بلا طبقات، إلى دولة ذات مؤسسات منتخبة وذات دستور يسمح بأوسع مشاركة سياسية ممكنة ويضمن كل الحريات الديمقراطية التي تصورتها الليرالية السياسية. فقد رزح الشعب الروماني تحت أبشع أنواع الدكتاتورية طيلة حكم الرئيس الأسبق شاوسسكو لمدة فاقت الخمسة عشر عاما (1974-1989)، ولكن أحدا لم يكن يتوقع سقوطه بتلك الطريقة. ففي ظرف ثمانية أيام، من تاريخ بداية المظاهرات المناهضة له في 17 ديسمبر 1989، إلى تاريخ محاكمته السريعة وإعدامه في 25 ديسمبر 1989، انتهى أمر زعيم احتكر مع زوجته إيلينا كل الوظائف وسام شعبه كل أنواع القهر والمهانة. هل كان نظام شاوسسكو يتوقع أن ينهار بتلك السرعة وهو الذي أعاد المؤتمر الرابع عشر للحزب الشيوعي انتخابه بالإجماع أمينا عاما له ورئيسا للبلاد قبل بضعة أسابيع فقط ؟
لم يكن الأمر ليتم بهذه السهولة لولا التفهم الذي أبداه بعض أركان النظام الذين فهموا عمق التحولات العالمية في تلك الفترة فسارعوا إلى نفض أيديهم من معلمهم العظيم وقائد البلاد المفدى حتى يتسنى لهم تنظيم العودة إلى السلطة من الباب الخلفي. وهذا السلوك، بالرغم من انتهازيته، يعبر عن نوع من التقليد المتبع داخل الأنظمة القهرية عندما تقع التضحية بوجه النظام ليتسنى استمرار النظام نفسه. صحيح أن الشيوعية لم تعد منذ ذلك الحين تحكم رومانيا، وأن اقتصاد السوق قد غزا بذلك آخر قلاع الاشتراكية، غير أن أولئك الذين سيروا النظام السابق كانوا هم أنفسهم من قيض لهم وضع أسس التوجه المستحدث والإشراف على صياغة دستور جديد يسمح للرومانيين بممارسة ما حرموا منه طيلة عقود من الديكتاتورية المتلثمة بالشيوعية. يبدو هذا السلوك طبيعيا إلى حد ما، فلا يعتقد أحد أن بإمكان المصالح التي استغرق بناؤها وتعهدها حوالي نصف قرن من الزمان أن تذوب بين عشية وضحاها. غير أن ما يلفت الانتباه أكثر في المثال الروماني، وما أكثر الأنظمة التي لا تزال تحذو حذوه في عالم اليوم، أن الديكتاتورية سواء كانت شيوعية أو قومية أو حتى ليبرالية، إنما تقوم على مجموعة من الأسس التي لا يتسنى استمرارها بغير تعهدها وصيانتها، وأهم هذه الأسس على الإطلاق هو الفساد.
ذلك أن أبشع الديكتاتوريات تعلم أنه لا يمكن لها أن تحكم إلى ما لا نهاية باستعمال القوة فحسب. فالقمع لديها ليس غاية في حد ذاته، وهي لا تلجأ إليه غالبا إلا مكرهة وفي أوقات معينة، أما سياسة كل يوم فتقوم على أسس أخرى أقل إكراها تجعل الديكتاتورية أمرا مقبولا به إلى حد ما، مرفوضا ولكن متعايشا معه. إن التخويف بالقمع أهم وأجدى من القمع، لذلك يقع بناء جهاز تسند إليه إشاعة الرعب بين الناس ونشر ثقافة الوشاية بين أفراد المجتمع وأحيانا ين أفراد العائلة نفسها، وهو أمر برعت فيه إلى حد كبير أجهزة مخابرات تشاوسسكو وشرطته السرية وخلايا الحزب الشيوعي. وبما أنه لا يمكن تطبيق نفس القمع على الجميع فإنه يقع انتقاء المعارضين الذين يسلط عليهم أقصى اضطهاد ممكن، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، وليس ضروريا أن يكون ضحايا القمع من أبرز المعارضين بل ينتقون من كل الفئات إذا أمكن، حتى يصل الدرس إلى الجميع. من هنا تتركز شيئا فشيئا القناعة التي مضمونها أن بإمكان أي واقع مهما كانت درجة سوئه، أن يزيد سوءا.
بالموازاة مع هذا المسار، يسعى النظام الديكتاتوري إلى خلق فئة، قد تتوسع لتصبح طبقة في بعض الحالات، من المقربين والمحظيين الذين تناط بهم مهمة التحصيل على درجة معينة من الشرعية للطغمة الحاكمة، وفي مقابل ذلك يسمح لهم الاستفادة من خدمات الدولة وحمايتها، فيشرعون في بناء إمبراطورية المصالح والربح السهل. وفي درجة معينة من تطور هذا المسار، يحصل نوع من الصدام متعدد الزوايا بين النظام السياسي ونظام المصالح ذاك. فإبان الأزمات، وما أكثرها في نمط الحكم الاستبدادي، يشعر جانب من النظام بوجوب التنازل أحيانا وفتح بعض المجال أمام تغيير مدروس يخفف من درجة الاحتقان العامة ويسمح إلى حد ما بتجديد الشرعية المتحللة، غير أن نظام المصالح هو الذي يقف عادة ضد هذا المنحى ويتولى إفشاله غالبا، لأن أي تحرير للنسق السياسي يعني تسليط ضغوط قد تبدأ صغيرة ولكنها سرعان ما تتعاظم، ضده. لا يهدف هؤلاء إلى احتكار أكبر جانب من قوت الشعب فحسب، فهذا لا يرضيهم، وإنما يكون هدفهم التهام كل ما هو متاح وغير متاح، دون اعتبار للمصلحة الإستراتيجية للنظام الذي يفترض أنهم يوجدون معه في مركب واحد. ذلك أن نظام المصالح الاقتصادية يصبح هو نفسه في حالة بناء نسقه السياسي المصغر، فيزيد في التوسع أفقيا ويربط نفسه بمصالح فئات أخرى يلقى إليها بالفتات. وهكذا تتركز إلى جانب الفساد الكبير، الذي تمارسه الفئة العليا من الفاسدين المرتبطين مباشرة بنظام الاستبداد، ممارسة الفساد الصغير الذي يدخل البيوت والإدارات وينتصب على الطرقات. وفي حين يجني المستفيدون من الأول أكبر الأرباح عن طريق الصفقات العظيمة التي يسمح لهم بالفوز بها بتغطية من الإدارة، فإن الثاني يصبح في تطوره السرطاني أخطر وأعم حيث يؤدي في نهاية الأمر إلى تثبيت ليس نظام المصالح الفاسد وإنما نظام الاستبداد أيضا. ويتم ذلك بصورة تدريجية وطبيعية عندما يشعر كل فرد أن القوانين المطبقة وعين السلطة المفتوحة لا تسمح له بحياة طبيعية فيقرر الانخراط هو أيضا في نظام المصالح من موقعه الصغير، وعادة ما يكون المقابل هو تقديم تلك الخدمات الصغيرة التي لا غنى لأي نظام استبدادي عنها وأولها الوشاية.
تغير نمط الحكم في رومانيا بفضل ما أطلق عليه حينها ثورة المخمل ، غير أن الطبقة السياسية لم تتغير إلا قليلا، وبقي نظام المصالح والفساد أيضا في مكانه، وأكثر ما اضطر إليه الجميع هو عملية توزيع أدوار جديدة والتعود على التخلي عن بعض الممارسات القديمة. ذلك أن رموز النظام الشيوعي القديم (وفي مقدمتهم إليسكو الذي سينصب رئيسا جديدا للبلاد) الذين ضحوا بزعيمهم في تلك الثورة ، قد ضمنوا بذلك الحضور الأقوى على الساحة الرومانية الجديدة، وأصبح مسؤولوا الحزب الشيوعي والإداريون القدامى ممثلين بطريقة أكثر من مرضية في النظام الجديد، كما ضمن أصحاب المصالح سيطرتهم على الاقتصاد الروماني المتحرر. ومما يدل على "حكمة" الطغمة التشاوسسكية أن جميع القوانين الهامة التي أحدثت بعد 1989 قد ضمنت استمرار نفس الفئات في السلطة، وخاصة منها النظام الانتخابي الذي يسمح للأحزاب الكبيرة دون غيرها بالولوج إلى البرلمان. وهذا الأمر ليس خاصا برومانيا لوحدها، ذلك أن كل البلدان الأوروبية الشيوعية سابقا تعيش حالة مماثلة، من روسيا إلى بولونيا إلى المجر...إلخ. والفارق الأساسي الوحيد أنه قد استعيض عن الشيوعية التي كانت في السابق غطاء لممارسة الديكتاتورية والفساد بأشكال جديدة من التغطية أكثر نجاعة وقبولا في الظروف العالمية الجديدة.
إن الديمقراطية لا تقضي على الفساد، ولكنها تمكن من أدوات أكثر فعالية لمقاومته. وما حدث مؤخرا في رومانيا يقدم أكبر مثال على ذلك. فقد قامت الحكومة بتنظيم استفتاء شعبي حول استمرار الرئيس الحالي باسيسكو في مهامه الرئاسية بعد أن جمد البرلمان مهامه بمقتضى قانون صادر في 19 أفريل 2007. وأسفر الاستفتاء الذي نظم في 19 ماي عن رفض شعبي(حوالي 75 بالمائة) لإقالة الرئيس المنتخب ديمقراطيا منذ 2004 مما اعتبر هزيمة للأحزاب الكبرى وخاصة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتشكل في معظمه من الشيوعيين السابقين. وقد عاب هؤلاء على باسيسكو بضعة أمور حاولوا تغليفها بطريقة فيها الكثير من "الديماغوجيا الديمقراطية" حيث وجهت إليه تهم من قبيل التدخل في شؤون المحكمة الدستورية، التدخل لصالح بعض الشركات، رفضه تعيين الوزراء الذين تم اقتراحهم من قبل رئيس الحكومة، مشاركته في الاجتماعات الوزارية، التدخل في شؤون البرلمان و التسبب في حالة من عدم الاستقرار السياسي في رومانيا. غير أن ما أغفله البرلمانيون المناهضون لباسيسكو كان الحديث عن حملته لمقاومة الفساد في الحصول على الصفقات الكبرى وسعيه لتوجيه القضاة نحو مزيد من الصرامة إزاء قضايا الفساد ومعارضته الصريحة للسياسات اللاشعبية للحكومة وإعداده لإصلاح دستوري سيقضي إن تم على عهد احتكار الأحزاب الكبرى للساحة البرلمانية، وهذه في ظننا مبررات كافية لسعي البرلمان للإطاحة به.
وبسبب مكافحته للفساد يحظى باسيسكو بتعاطف شعبي عارم من قبل الرومانيين الذين ينظرون إليه بوصفه رمزا لمكافحة الفساد وسوء التصرف. وقد لاحظ الرومانيون كيف عمد رئيس الحكومة تاريسيناو بمساندة من الأغلبية البرلمانية المتوجسة من برامج باسيسكو بإقالة وزيري العدل والداخلية الذين انخرطا بفعالية في مسار مقاومة الفساد، وهو موضوع ذو أولوية بالنسبة للإتحاد الأوروبي الذي انضمت إليه رومانيا مؤخرا، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية هذا البلد كأكثر البلدان الأوروبية فسادا . ولا يملك رئيس الدولة في رومانيا صلاحيات كبرى بالرغم من أنه منتخب مباشرة من الشعب، في حين يسيطر رئيس الحكومة المعين من قبل الأغلبية البرلمانية على معظم الصلاحيات ولا يكون مسئولا إلا أمام البرلمان. وهو نظام هجين بين النمط الرئاسي والنمط البرلماني أريد منه تحقيق تعادل في الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية.
لا يشك أحد في طرافة هذه الوضعية: رئيس بلا نفوذ حقيقي ينطلق في حملة لمكافحة الفساد بدون صلاحيات واسعة، وحكومة متآمرة مع البرلمان على منع الإصلاحات وعلى بقاء نظام المصالح والفساد، في تجاهل كامل لتطلعات الشعب. وتكمن هذه الطرافة في أننا تعودنا على النظر إلى البرلمان، مبدئيا، بوصفه الممثل للسيادة الشعبية والعامل على تحقيق إنتظارات الناخبين والمتحفز لتصويب ممارسات السلطة التنفيذية والحريص على سيادة الدستور. ولكن الواقع على الأرض يبدو شديد التناقض مع هذا التخطيط النظري. فقد بنت الطبقة السياسية الحاكمة في رومانيا لنفسها من الحصون ما يستعصي إلى حد الآن عن السقوط، وصمودها في وجه محاولات التغيير الذي صادف أن رئيس البلاد يتبناها ما هو إلا رد فعل طبيعي من قبل فئة اعتبرت دائما أن مسؤوليتها السياسية ليست سوى غطاء تحقق من ورائه مصالحها في الإثراء. من هنا فهي تقاوم بكل ما أوتيت من جهد كل محاولات النيل منها ومن مصالحها، بانية في خضم ذلك كل التحالفات الممكنة (التحالف البرلماني المناهض لباسيسكو يضم أحزاب اليمين وأحزاب اليسار وأحزاب الوسط على حد سواء !) ومعارضة أي تغيير في الدستور يقضي على احتكارها للحياة السياسية.
وتبين نتيجة الاستفتاء من جهة أخرى قدرة الشعب الروماني على اتباع أكثر السبل براغماتية من أجل تحقيق طموحاته. فقد نفض هذا الشعب يديه من البرلمان الذي تشكل بفضل دستور ونظام انتخابي على مقاس الأحزاب الكبرى، وقرر مساندة رئيسه في حربه على الطبقة السياسية الفاسدة، لذلك يتوقع مراقبون أن الرئيس باسيسكو الذي تنتهي فترة ولايته الحالية في 2009 سيفوز فوزا ساحقا في أية انتخابات مقبلة، كما يتوقع أن تنال مساعيه في تحوير الدستور إذا ما وصلت إلى الاستفتاء مساندة شبه مطلقة من الرومانيين الذين سئموا الفساد والفاسدين. ذلك أن الفساد، مثل الاستبداد تماما، يصل في مرحلة معينة من تطوره السرطاني إلى تهديد أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة، فيصبح ابتداع سبل التحرر منه، باستخدام الانتفاضة (مثلما حدث في ديسمبر 1989) أو بالتعبير الديمقراطي الهادئ (مثلما حصل في استفتاء 19 ماي 2007) أوكد من الاحترام الأبله لمؤسسات تخلت عن دورها.