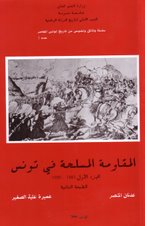سوسة في 4 أفريل 2010
السيد رئيس تحرير مجلة حقائق
تحية طيبة
أما بعد فيشرفني أن أحيل لسيادتكم، عملا بمبدأ حق الرد، نصا أرد فيه على مقال صدر بالعدد الأخير من مجلتكم (حقائق عدد 110، من 29 مارس إلى 11 أفريل 2010) تناول مشاركتي في أحد المؤتمرات العلمية، فالرجاء التفضل بنشره لإضاءة الرأي العام حول هذه المسألة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
عدنان المنصر
ردا على مقال "الأستاذ المنصر في ملتقي حضره أكاديميون إسرائيلبون: خطوة معزولة....ولكنها ليست الأولى"
..............سلاما
استرعى انتباهي وانتباه الكثيرين المقال الصادر بالعدد من مجلة حقائق والذي تناول مشاركتي في مؤتمر علمي ببرلين في جوان 2007، وقد ذهب فيه مؤلفه إلى اتهامي بالتطبيع الأكاديمي مع إسرائيل وإخفاء هذه المشاركة، وهو ما أرد عليه في النقاط التالية:
- تعمد صاحب المقال المقارنة في الجملة الأولى بيني بوصفي مؤرخا تونسيا وين مؤرخ إسرائيلي مناهض للصهيونية داسا في خلال هذه المقارنة ما معناه أن التونسي صهيوني وأن الإسرائيلي متعاطف مع الفلسطينيين. أربأ بمجلة حقائق ومن يكتبون فيها أن يصدر عنهم هذا الدس، فهو ينطلق من سوء نية واضحة وثلب شخصي يمكن أن يكون منطلقا لتتبعات عدلية ضد صاحب المقال سأبين في النقاط التالية عدم استناده لأية دلائل.
- واصل صاحب المقال في الفقرة الثانية استعمال الدس فأشار إلى أنني "محسوب على أحد التيارات السياسية الدينية" دون أن يقدم على ذلك دليلا واضحا. كنا نعتقد أن هذا الأسلوب في الدس الأمني الرخيص قد ولى إلى غير رجعة، ولو قدر لمن يهمهم الأمر أن يعتمدوا على هذا النوع من الخدمات الأمنية لكان الأمر شديد السوء، ولكنهم أكثر ذكاء ويعرفون من نكون.
- في النقطة الثالثة أشار صاحب المقال أنني أشرت في مدونتي الإلكترونية إلى مشاركتي في مؤتمر بأكس أون بروفانس حول اتفاقية الشراكة التونسية المتوسطية في سبتمبر 2006 ولم أشر إلى مشاركتي في مؤتمر برلين حول نفس الموضوع في جوان 2007. لو كان صاحب المقال حريصا على الحقيقة وعلى إنارة الرأي العام لتفطن إلى أن المدونة غير محينة منذ مدة ولوجد أنني نشرت على صفحتي في الفايسبوك فهرس الكتاب الصادر عن ندوة برلين والذي نشر منذ شهرين فحسب، وتوجد أسماء كل المشاركين في هذا الفهرس. عندما يكون البحث عن الحقيقة هو الهدف الفعلي للصحفي فإنه لا يعدم وسيلة لإظهارها ويتجنب الإنتقاء الموجه. كان بوسع مؤلف المقال المذكور أن يستجلي الأمر ولكنه خير عوضا عن ذلك قد اختار الإنطلاق من فرضية ومحاولة إثباتها بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، فعدنان المنصر معروف للرأي العام وعنوانه الإلكتروني منشور وله مع بعض صحفيي "حقائق" والمتعاونين معها علاقات شخصية، كما أن عنوان الكلية التي يدرس بها معلوم وكذلك رقم هاتفه لمن أراد. ونظرا لأن صاحب المقال يخلط بين أمور كثيرة فإننا نتفضل عليه بأن نوضح له كيف ينعقد مؤتمر علمي وما هي حدود المعلومات التي يملكها المشاركون فيه، انطلاقا من أعمال مؤتمر برلين المذكور.
- انعقد مؤتمر برلين في إطار برنامج بحث واسع موله الإتحاد الأوروبي حول المتوسط لمحاولة تقييم مسار برشلونة واتفاقيات الشراكة، وقد انخرطت فيه شبكة من الجامعات المتوسطية نجد من بينها جامعة تونس. كنت الوحيد الذي وجهت له دعوة المشاركة من تونس بالنظر إلى مقترح البحث الذي قدمته، حيث انتميت إلى فريق بحث اشتغل على موضوع "المتوسط كمشروع تبنيه الحكومات والمجتمعات المدنية". هذا الفريق انقسم إلى قسمين: قسم خاص المتوسط الغربي عقد مؤتمره التحضيري بأكس أون بروفانس وهو الذي انتميت إليه، وقسم خاص بالمتوسط الشرقي. في برلين وقع الجمع بين الورشتين، وحينها اكتشف وجود الإسرائيليين. في اليوم الأول الذي انعقد بالسفارة المصرية ببرلين قدمت بعض المداخلات الموجهة لما يسمى بصناع السياسات، وقد حضره ممثلون عن كل السفارات والبعثات الديبلوماسية المهتمة بالشأن المتوسطي، وكان من بينهم الملحق الإقتصادي للسفارة التونسية ببرلين لأن للأمر علاقة بالمسائل الإقتصادية وقضايا الهجرة إلى أوروبا. ألقى مارك هيلر مداخلته في ذلك اليوم المفتوح ووقف الأوروبيون على عداء الكيان الصهيوني للمشروع المتوسطي، ذلك أن المحاضر الإسرائيلي بين أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنتمي لمشروع يمثل أعداؤها الموجودون في ضفته الجنوبية عنصرا مركزيا في بنائه. قدمت مداخلتي في اليوم الثاني بمقر جامعة برلين الحرة، حول تقييم الشراكة المتوسطية من منظور تونسي، وهو نفس اليوم الذي قدمت فيه أنجليكا تيم مداخلة حول أحد المشروعات البيئية. وبافتراض أنني أملك معلومات مخابراتية تتيح لي الحصول على قصة حياة المشاركين وانتماءاتهم السياسية، وهو أمر غير متاح لسوء الحظ، فما كنت لأترك مقعدي شاغرا، ولا أن أترك بقية المشاركين بمن فيهم الإسرائيليين، يناقشون في غياب أي تونسي مسائل تهم التونسيين أيضا، ذلك أنني أعتبر أن في الهروب من هذه المناسبات جبنا لا يجدر بأية اعتبارات مهما كانت أن تغطي عليه.
- عندما يشارك جامعي في مؤتمر علمي فإنه لا صفة رسمية له. الجامعي لا يمثل إلا نفسه وفكره ومنهجه ونتائج أبحاثه. وهذا رد على ما كتبه صاحب المقال عندما رأي في مشاركتي تطبيعا باسم الجامعة التونسية. يفترض بحسب هذا المنطق أن ينسحب التونسيون من جميع المؤتمرات العلمية عندما يكون من بين المشاركين إسرائيليون، وأن لا يشاركوا إذا إلا في مؤتمرات الشعوذة والديماغوجيا العقيمة. فلينسحب الأطباء والمهندسون وغيرهم من العلماء من جميع المؤتمرات إذا حتى يرضوا بعض أصحاب الخطاب القومجي الرافضين فتح أعينهم على حقيقة عالمهم اليوم، حيث يمثل كل تخل عن مهمة علمية تخليا لا يقل عارا عن الهروب من ساحة معركة.
- لست في وارد التذكير بمواقفي القومية والوطنية، فهذا الأمر لا ينكره إلا جاحد، وكتاباتي على أعمدة الصحف وفي الملتقيات العلمية والمؤلفات الجماعية، وكذلك مشاركاتي في وسائل الإعلام المختلفة، تنطلق من فكرة أساسية، وهي أن الثقافة إلتزام مجتمعي وأخلاقي، وبحث عما يجمع بين الناس مهما اختلفوا، وقناعة بأن ما يجمع التونسيين أكثر بكثير مما يفرقهم، بالإستناد إلى التجربة التاريخية ذاتها. ولعل ذلك ما يقلق البعض بالفعل فانخرطوا في مسار من التشويه لا تخفى الأدلة عليه، توضح الأمر التهم المتناقضة في نفس المقال. كل شيء مطلوب من خلال هذا "التحقيق"، إلا الحقيقة.
- ماهو مفهوم التطبيع؟ كان يجدر بصاحب المقال أن يشير إلى ذلك ولو عرضا، ولكنه لم يفعل لأنه انطلاقا من مضمون ما كتبه فإن كل شيء يغدو تطبيعا: كان عليه أن يدعو الدولة التونسية إلى الإنسحاب من الأمم المتحدة، ومن منظمة الصحة العالمية، ومن المنظمة العالمية للزراعة وغيرها... فإسرائيل عضو فيها جميعا. ذلك يتطلب حتما قدرا من الشجاعة أكبر بكثير من مهاجمة الجامعيين الذين لا يجدون الوقت الكافي للإجابة عن ترهات كنا نظن الزمن قد عفا عليها. التطبيع هو أن تفعل ما من شأنه أن يجعل وجود إسرائيل وجودا طبيعيا، ويقتضي ذلك في المجال الجامعي أن تنسق معهم عقد مؤتمرات، أو تعقد معهم اتفاقيات، أو تستدعيهم لإلقاء محاضرات... ينبغي أن تكون أنت من ينظم أولا، وأن يكون هدفك هو التطبيع، وأن يفهم هذا الهدف من خلال ما تكتب وتنشر، بحيث يبدو تواصلا لمسار فكري معين. هل وجد مؤلف المقال الذي أغرته الإستنتاجات المتسرعة والمنطلقة من سوء فهم (إذا ما افترضنا أن وراءها نية حسنة) كل ذلك؟ أما نحن، فلو كانت تلك قناعتنا لما خشينا التصريح بها، مثلما صرحنا بمواقف لم ترض الكثيرين في مجالات أخرى، وقد تكون أزعجت.
- الغريب أن صاحب المقال الذي بهرنا بحسه القومي، وبكثرة التهم ضدنا،لم يقدم لنا تصوره للكيفية التي يواصل بها الأكاديميون القيام بواجباتهم دون أن يسقطوا في حبائل التهم التي تفضل بإلصاقها بهم. الجامعيون بحاجة ماسة إلى نصائح أمثال صاحب المقال فليتفضل بمساعدتهم على تلمس طريقهم، كم يحتاجون إلى هذه المساعدة !
- أما نحن، فإننا سنواصل عملنا، وسنذهب حيث وجدنا أن حضورنا لازم، وحيث وجدنا أن بإمكاننا أن نفيد. ذلك أن تكلفة تكويننا التي اقتطعت من قوت التونسيين وعرقهم لا تسمح لنا بملازمة الأركان القصية وبالتخلي عن المهام التي نعتقد أنها في صلب دورنا، وأهمها على الإطلاق رفع الجهل، والتقريب بين التونسيين، ودفع الأجيال الشابة في طريق الفهم العقلاني والنقدي لماضيهم وحاضرهم، إعدادا لمستقبلهم الذي لن يكون إلا مشرقا، فنحن من ذلك واثقون تمام الثقة. الجامعيون فخر هذه البلاد، ومنارة أجيالها الشابة. والإساءة إليهم بالإجتزاء والإنتقائية لا ترفع صاحبها مطلقا ولا تحقق له من الشهرة إلا سرابها المر. الجامعيون الذين نفتخر بالإنتماء إليهم لا يمكن النيل منهم بمثل هذه الأساليب، وإذا ما "أخطأ" البعض في حقهم فإنهم يوضحون، ثم يمشون هونا، ويقولون سلاما. فسلاما.
مجلة حقائق، 12 أفريل 2010
عدنان المنصر
أستاذ محاضر بجامعة سوسة