
سبتمبر 2001- سبتمبر 2008
حصاد السبع العجاف
حصاد السبع العجاف
عدنان المنصر
مقال صادر بصحيفة الموقف التونسية العدد 465 بتاريخ 19 سبتمبر 2008
وبصحيفة الحياة اللندنية بتاريخ 24 أكتوبر 2008
قبيل الحادي عشر من سبتمبر من سنة 2001، لم يكن أحد يتوقع أن يرى أمريكا تقصف في عقر دارها وأحد أهم رموزها ينهار تحت وطأة عملية لم تعوزها الجرأة ولا حسن التنظيم. من منا لم تهزه تلك المشاهد ولم تنطلق داخله بعض أحاسيس الشماتة لرؤية أمريكا الجريحة ذليلة منكسرة ولو لبعض الوقت؟ منذ ذلك الوقت يبدو أن أشياء كثيرة تغيرت، فتلك العملية، بغض النظر عن توصيفاتها المختلفة، لم تزد واقعنا إلا سوءا وأمريكا إلا صلفا والإستبداد إلا عنفوانا.
سبع سنوات مرت منذ تلك الهجمات التي بإمكاننا القول اليوم بانها، مثل التي جاءت من بعدها، كانت "إرهابية". ليس المقصود هنا إطلاق حكم أخلاقي قيمي عليها بل توصيفها سياسيا بالإستناد إلى المفهوم الأكثر حيادية للإرهاب، وهو العمل الذي يهدف، عن طريق عمل فجئي وعنيف ومعد بسرية، إلى إحداث تغيير في سياسات الدول أو المجموعات. هل بإمكاننا اليوم أن نرى ما إذا حققت تلك الهجمات أهدافها المضمنة في تعريف "الإرهاب" ذاك؟ على الرغم من أن الكثير من المحرجين يحاولون تأجيل الأمر بداعي "الغموض" و"الطابع الوقتي" للتوازنات الراهنة، إلا أن الأمر أكثر بساطة ووضوحا وشؤما مما يحاولون الفرار منه. إذا كان المقصود من "إحداث تغيير في سياسات الدول والمجموعات" يعني، من ضمن ما يعنيه، اشتداد الهجوم علينا من قبل الدول التي استهدفتها تلك الهجمات، فإن النجاح كامل وباهر. إن جردا بسيطا للحساب يعطينا تقييما بديهيا للوصفة السحرية التي ابتدعها منظموا ومساندوا ومنظروا تلك الهجمات: منذ ذلك الحين أعيد احتلال بلاد كان يظن أنها تحررت، واحتلت بلاد كان يعتقد أنها البوابة الشرقية لعالمنا العربي، وتركز تأثير الأجهزة السرية والعلنية الأمريكية في كل بلادنا بلا استثناء. من سوء الحظ أننا، في خضم الواقع الناشئ عن "الحرب ضد الإرهاب" قد أضحينا أكثر ضعفا ودونية مما كان عليه الأمر قبل تلك الهجمات، ولا يبدو أن اتجاه البخار سينقلب في المدى القريب، مهما اجتهد الظواهري لإقناعنا بذلك. قبل عشر سنوات من تلك الأحداث كان الغرب قد أفاق على تبخر العدو الإستراتيجي الذي قامت على مواجهته كل السياسة العسكرية والجهد الديبلوماسي لدول الغرب الرأسمالي مجتمعة منذ الحرب العالمية الثانية. لم نكن نتوقع أن يجد الغرب عدوا استراتيجيا جديدا بمثل تلك السرعة وأن ينجح في تجيير كل السياسة الدولية ضده. وفي المقابل فقد بدت القاعدة كمن يفقد ميدانا ويكسب آخر، في حرب مواقع غير تقليدية لم تشهد البشرية مثيلا لها طيلة وجودها. منحت العولمة للطرفين المتصارعين أدوات تقاتل جديدة زالت معها الحدود وتبخرت السيادات. أصبح عاديا أن نتقبل نبأ قصف طائرات أمريكية لأهداف إرهابية في اليمن أو باكستان، وأن نتقبل في الآن نفسه أن تضرب القاعدة في أماكن لم نحسب أن لها وزنا في خريطة الصراع الجديد. حيث ما قلبت الأمر وجدته محبطا. كم عدد "الإرهابيين" الحقيقيين الذين طالتهم العمليات العسكرية والأمنية الغربية؟ وفي المقابل كم عدد "أعداء الأمة" الحقيقيون الذين طالتهم عمليات القاعدة؟ لا يبدو أن لذلك قيمة تذكر في نظر الطرفين، فالهدف لم يكن مطلقا، فيما يبدو، التفريق بين العدو الحقيقي وضحايا الصدفة. الأمريكيون وجدوا بعض الحل لمشكل التصنيف ذاك، فقد أصبحت بياناتهم منذ مدة تتحدث عن "الإرهابيين المفترضين"، أما الطرف المقابل فيقوم بتوزيع أوسمة الشهادة التي لا يبدو أنها تغير في واقع الضحايا شيئا. من اللافت أن كلا الطرفين وجدا الحل نفسه ، ففي حين يضع الأول الأمر على عاتق حسن النية، فإن الثاني يعول على تفهم الله لأخطاء المنفذين.
كم كنا نود أن يأخذ الصراع شكله العتيق الذي تعودنا عليه، دول تتصارع، دول تساند هذا الطرف أو ذاك، وأخرى تتفرج. لنعترف أن لا تقليدية الصراع الراهن أمر يرهقنا أشد الإرهاق. فعلاوة على طابعه غير المحسوس غالبا، يضعنا هذا الصراع في الموقعين المتقابلين في الآن نفسه: نرفض أساليب "الإرهاب" وتبريراته لأننا ندفع من حياتنا ثمنها القاسي، ولكننا نتحمل بعض وزره لأننا ننتمي، شئنا أم أبينا، إلى نفس الثقافة التي يقال لنا أنها أنتجت من جملة ما أنتجت، "الإرهاب". بالنسبة "للإرهاب" نحن مشبوهون. بالنسبة لمحاربيه، لسنا في محل أقل شبهة إطلاقا. كم تبدو مضنية وضعيتنا فنحن فيما يبدو لا قدرة لنا على اختيار موقعنا، وإذا ما قدر لنا أن نختاره فإننا نجني به عداء الجميع في الوقت نفسه. إننا ببساطة القدر نتلقى الضربات من الجانبين، هل سلط علينا حكم بات بأن نكون إما إرهابيين وإما عملاء للغرب؟ الأمر يتخطى الواقعية ولكنه، في بعده القاسي، واقعي كأبشع ما يكون الواقع.
هل نريد من التصريح بعدم رضانا عن موقعنا أن يحيدنا الجميع وأن نواصل حياتنا كما كانت، دون رجات ولا أزمات؟ المسالة، برغم التوصيف بالإنتهازية الذي قد لا ننجو منه، أعقد من ذلك. مأتى القلق أننا نجد نفسنا في أتون صراع لم نرده ولكنه يصهرنا، لم نرده رغبة في السلامة ولكن لأننا نعتقد أنه عبثي إلى أقصى الحدود، لأن منطقه لا ينبع ببساطة من داخله. هل بإمكان الغرب المصطف اليوم كالبنيان المرصوص في "الحرب على الإرهاب" أن يأمل أن حربه تلك ستنتج عالما أكثر استقرارا؟ هل بإمكان "الإرهاب" في المقابل أن يجعل من أعمال التفجير خريطة طريق لصراعه ضد الغرب؟ الأمر لا ينبع من هذه الطريقة في النظر للأشياء بقدر ما ينبع من اعتبارات نراها ولكننا لا نستطيع لمسها لأنها متحولة، ينتج بعضها بعضا، وفي خضم ذلك التحول يضيع الأصل وينتج "الإرهاب" مضاداته في حين تبلى المضادات بالمناعة المكتسبة المتزايدة "للإرهاب".
سيكون بإمكان الصراع الراهن أن يتبجح بأنه كان من أهم عناصر تحقيق العولمة. لم يعد سرا أنه في الآن نفسه، سعت الولايات المتحدة إلى تكثيف مراقبتها المخابراتية في كل دول العالم دون استثناء، وإلى فرض تغييرات محسوسة في برامج التعليم في الدول الإسلامية، وإلى تكثيف مراقبة الأفراد في تنقلاتهم ومعاملاتهم وحياتهم الأسرية، وتطوير أساليب عسكرية جديدة أكثر تلاؤما مع تحديات المرحلة، والإحاطة بوسائل الإعلام من أجل تغطية دعائية لسياستها، وربط جميع المساعدات والتعاملات المالية مع الدول بمدى انخراطها في منظومة "الحرب على الإرهاب". من بإمكانه اليوم إنكار أنه أصبح، رغما عنه وعن سيادة الدولة التي تحيطه بعنايتها، مواطنا أمريكيا بدرجة ما. تتدخل الأجهزة الأمريكية في تحديد أنظمة السفر ومعايير المعاملات المصرفية وطرق مراقبة المشبوهين (أي نحن جميعا) وتتولى في أحيان كثيرة أمر اعتقالهم خارج التراب الأمريكي وتوكل أمر استنطاقهم وتعذيبهم إلى من فرض كفاءته في هذا الميدان أكثر من غيره. ينبغي أن نعترف بأن ذلك الجهد كان خارقا وخارج دائرة التوقع منذ سبع سنوات وأن أهدافه الأساسية قد تحققت، ونحن نحسب أن أهدافه الأساسية ليست مطلقا منع القاعدة من تنظيم هجمات أو تحقيق عالم أكثر أمنا، بل إنتاج عالم جديد تمسك فيه الولايات المتحدة بمقاليد كل شيء، بكل المعلومات وكل المقدرات، مما يسهل تجيير جميع الطاقات لصالحها وفرض تأثيرها غير القابل للمقاومة على الكيانات الأخرى، حليفة كانت أو متحفظة. نكاد نجزم، لولا اعتراف القاعدة، بأن تلك الأجهزة هي من خطط للأمر برمته، ولكن هذه قضية أخرى. ما نريد تأكيده هنا هو ازدهار صناعة "الإرهاب" إلى حد لم نتصور أنها ستبلغه. تقوم صناعة "الإرهاب" على مكون أساسي توفره صناعة رديفة أخرى هي صناعة الخوف. وبين الخوف من "الإرهاب" و"الإرهاب" بدعوى القضاء على الخوف نقطع الخطوات المتبقية لنا نحو الزمن الأمريكي الكامل.
يضعنا الغرب في موضع المتهم باستمرار، إما لتخلفنا أو لثقافتنا "الراعية للإرهاب" أو لنفسيتنا المهووسة بالعداء له. وفي المقابل نحسن نحن لعب هذا الدور كما لم نحسن غيره. نلتفت داخلنا ونتساءل: من حق القوم أن يلومونا، فثقافتنا "تحرض على الإرهاب". ينتابنا الشك في فهمنا الذي كان إلى حد قريب بديهيا لأنفسنا، لواقعنا ولثقافتنا. ليس المقصود من وضعنا موضع الإتهام أن نلفظ تلك الثقافة فهم يحتاجون باستمرار إلينا حيث نحن، ليفهمونا كما يريدون. تنهال علينا الضربات وعندما نرفع أيدينا لنتقي بعضها تتأكد التهمة ويشرعون في تصفيتنا. في كلتا الحالتين يتهددنا الزوال.
لا يضعنا الآخرون في موقع أكثر سكينة باتهامنا واستهدافنا، لأننا "مسلمون سيؤون"، "منافقون ومنبطحون لهيمنة الغرب". لا يراد منا أن نكون مسلمين جيدين لأنهم سيفقدون بذلك "تميزهم" ومشيخات الرماد التي شيدوها على جثثنا. نلتفت مرة أخرى داخلنا ونتساءل: هل نحن سيؤون إلى هذه الدرجة؟ يتسمعون إلى تساؤل البعض منا فينهالون عليه بفيض تقواهم وجهادهم، قد ينجحون فيبلغنا بعد حين أنه انتقل إلى الضفة الأخرى، و"يحتسبونه عند الله شهيدا".
يتمعش الإستبداد من الوضع فيستلمنا ونحن على خوفنا ذاك، فيمتص ما بقي من الحياة داخلنا، ويلقي بنا بعد ذلك مكرهين في زمرة الرعية الراضية المرضية. لن يكون بالإمكان بعد ذلك أن نطلب لأنفسنا أو لغيرنا شيئا، يكفي أننا نتفس بين الحين والآخر. من بمقدوره اليوم أن يناقش استفادة الإستبداد من "الإرهاب"؟ فقط الإستبداد يشكك في ذلك (ومعه "الإرهاب" أحيانا). تكتمل حلقة الفناء من حولنا وقد اندثرت معالم حلم قديم بأن نكون مواطنين في دولة مواطنة. تلتقط دولة الرعية أنفاسها بعد محنة المساءلة الديمقراطية وتجد نفسها، مجددا، في وضعها المريح. تلعب دورها في الحرب على "الإرهاب" كأفضل ما يؤمل منها، تلتقط في الأثناء المناوئين لها وترمي بحقوق الناس إلى الجحيم. بعد ذلك يصبح بإمكانها القول أن القطيع بخير، "بلدة طيبة ورب غفور".
لا تستهدف "الحرب على الإرهاب" "الإرهاب" وإنما السيطرة على الأفراد بعد أن تكون قد قضت على كل روابط التضامن بينهم. تحاصر المميزات الثقافية في زوايا الصراع المظلمة فيبدأ مسار تذويب الهويات وتقترح العولمة الأمريكية بديلا لذلك كله. يضيق الإسلام في أثناء ذلك بمعتنقيه ويتحول عوضا عن كونه هوية منفتحة على الإنسانية ومتسعة باستمرار إلى بوتقة يحتكرها "المسلمون الجيدون" بعد أن قرروا أنهم من تنطبق عليهم الصفة. تنحسر حركة الحقوق في خلال ذلك تحت وطأة استبداد الدول التي اغتنمت فرصة وجودها ويصبح أقصى أمل الفرد أن يعود إلى بيته في المساء دون أن يكون ضحية قصف أو تفجير أو إيقاف عن طريق الخطأ. في خضم هذه السريالية القاسية يفقد الإنسان بوصلته ويعلم أنه لن يكون بإمكانه أن يعيش إنسانيته كما تعود في الماضي. الآن أصبح يفهم أن "الإرهاب" و"الحرب على الإرهاب" والإستبداد وما خفي من ملمات إنما تستهدفه كإنسان يراد له أن يكون قطعة بلا روح ولا إرادة في متاهة لا يعلم حدودها ولا مخارجها.
سبع سنوات مرت منذ تلك الهجمات التي بإمكاننا القول اليوم بانها، مثل التي جاءت من بعدها، كانت "إرهابية". ليس المقصود هنا إطلاق حكم أخلاقي قيمي عليها بل توصيفها سياسيا بالإستناد إلى المفهوم الأكثر حيادية للإرهاب، وهو العمل الذي يهدف، عن طريق عمل فجئي وعنيف ومعد بسرية، إلى إحداث تغيير في سياسات الدول أو المجموعات. هل بإمكاننا اليوم أن نرى ما إذا حققت تلك الهجمات أهدافها المضمنة في تعريف "الإرهاب" ذاك؟ على الرغم من أن الكثير من المحرجين يحاولون تأجيل الأمر بداعي "الغموض" و"الطابع الوقتي" للتوازنات الراهنة، إلا أن الأمر أكثر بساطة ووضوحا وشؤما مما يحاولون الفرار منه. إذا كان المقصود من "إحداث تغيير في سياسات الدول والمجموعات" يعني، من ضمن ما يعنيه، اشتداد الهجوم علينا من قبل الدول التي استهدفتها تلك الهجمات، فإن النجاح كامل وباهر. إن جردا بسيطا للحساب يعطينا تقييما بديهيا للوصفة السحرية التي ابتدعها منظموا ومساندوا ومنظروا تلك الهجمات: منذ ذلك الحين أعيد احتلال بلاد كان يظن أنها تحررت، واحتلت بلاد كان يعتقد أنها البوابة الشرقية لعالمنا العربي، وتركز تأثير الأجهزة السرية والعلنية الأمريكية في كل بلادنا بلا استثناء. من سوء الحظ أننا، في خضم الواقع الناشئ عن "الحرب ضد الإرهاب" قد أضحينا أكثر ضعفا ودونية مما كان عليه الأمر قبل تلك الهجمات، ولا يبدو أن اتجاه البخار سينقلب في المدى القريب، مهما اجتهد الظواهري لإقناعنا بذلك. قبل عشر سنوات من تلك الأحداث كان الغرب قد أفاق على تبخر العدو الإستراتيجي الذي قامت على مواجهته كل السياسة العسكرية والجهد الديبلوماسي لدول الغرب الرأسمالي مجتمعة منذ الحرب العالمية الثانية. لم نكن نتوقع أن يجد الغرب عدوا استراتيجيا جديدا بمثل تلك السرعة وأن ينجح في تجيير كل السياسة الدولية ضده. وفي المقابل فقد بدت القاعدة كمن يفقد ميدانا ويكسب آخر، في حرب مواقع غير تقليدية لم تشهد البشرية مثيلا لها طيلة وجودها. منحت العولمة للطرفين المتصارعين أدوات تقاتل جديدة زالت معها الحدود وتبخرت السيادات. أصبح عاديا أن نتقبل نبأ قصف طائرات أمريكية لأهداف إرهابية في اليمن أو باكستان، وأن نتقبل في الآن نفسه أن تضرب القاعدة في أماكن لم نحسب أن لها وزنا في خريطة الصراع الجديد. حيث ما قلبت الأمر وجدته محبطا. كم عدد "الإرهابيين" الحقيقيين الذين طالتهم العمليات العسكرية والأمنية الغربية؟ وفي المقابل كم عدد "أعداء الأمة" الحقيقيون الذين طالتهم عمليات القاعدة؟ لا يبدو أن لذلك قيمة تذكر في نظر الطرفين، فالهدف لم يكن مطلقا، فيما يبدو، التفريق بين العدو الحقيقي وضحايا الصدفة. الأمريكيون وجدوا بعض الحل لمشكل التصنيف ذاك، فقد أصبحت بياناتهم منذ مدة تتحدث عن "الإرهابيين المفترضين"، أما الطرف المقابل فيقوم بتوزيع أوسمة الشهادة التي لا يبدو أنها تغير في واقع الضحايا شيئا. من اللافت أن كلا الطرفين وجدا الحل نفسه ، ففي حين يضع الأول الأمر على عاتق حسن النية، فإن الثاني يعول على تفهم الله لأخطاء المنفذين.
كم كنا نود أن يأخذ الصراع شكله العتيق الذي تعودنا عليه، دول تتصارع، دول تساند هذا الطرف أو ذاك، وأخرى تتفرج. لنعترف أن لا تقليدية الصراع الراهن أمر يرهقنا أشد الإرهاق. فعلاوة على طابعه غير المحسوس غالبا، يضعنا هذا الصراع في الموقعين المتقابلين في الآن نفسه: نرفض أساليب "الإرهاب" وتبريراته لأننا ندفع من حياتنا ثمنها القاسي، ولكننا نتحمل بعض وزره لأننا ننتمي، شئنا أم أبينا، إلى نفس الثقافة التي يقال لنا أنها أنتجت من جملة ما أنتجت، "الإرهاب". بالنسبة "للإرهاب" نحن مشبوهون. بالنسبة لمحاربيه، لسنا في محل أقل شبهة إطلاقا. كم تبدو مضنية وضعيتنا فنحن فيما يبدو لا قدرة لنا على اختيار موقعنا، وإذا ما قدر لنا أن نختاره فإننا نجني به عداء الجميع في الوقت نفسه. إننا ببساطة القدر نتلقى الضربات من الجانبين، هل سلط علينا حكم بات بأن نكون إما إرهابيين وإما عملاء للغرب؟ الأمر يتخطى الواقعية ولكنه، في بعده القاسي، واقعي كأبشع ما يكون الواقع.
هل نريد من التصريح بعدم رضانا عن موقعنا أن يحيدنا الجميع وأن نواصل حياتنا كما كانت، دون رجات ولا أزمات؟ المسالة، برغم التوصيف بالإنتهازية الذي قد لا ننجو منه، أعقد من ذلك. مأتى القلق أننا نجد نفسنا في أتون صراع لم نرده ولكنه يصهرنا، لم نرده رغبة في السلامة ولكن لأننا نعتقد أنه عبثي إلى أقصى الحدود، لأن منطقه لا ينبع ببساطة من داخله. هل بإمكان الغرب المصطف اليوم كالبنيان المرصوص في "الحرب على الإرهاب" أن يأمل أن حربه تلك ستنتج عالما أكثر استقرارا؟ هل بإمكان "الإرهاب" في المقابل أن يجعل من أعمال التفجير خريطة طريق لصراعه ضد الغرب؟ الأمر لا ينبع من هذه الطريقة في النظر للأشياء بقدر ما ينبع من اعتبارات نراها ولكننا لا نستطيع لمسها لأنها متحولة، ينتج بعضها بعضا، وفي خضم ذلك التحول يضيع الأصل وينتج "الإرهاب" مضاداته في حين تبلى المضادات بالمناعة المكتسبة المتزايدة "للإرهاب".
سيكون بإمكان الصراع الراهن أن يتبجح بأنه كان من أهم عناصر تحقيق العولمة. لم يعد سرا أنه في الآن نفسه، سعت الولايات المتحدة إلى تكثيف مراقبتها المخابراتية في كل دول العالم دون استثناء، وإلى فرض تغييرات محسوسة في برامج التعليم في الدول الإسلامية، وإلى تكثيف مراقبة الأفراد في تنقلاتهم ومعاملاتهم وحياتهم الأسرية، وتطوير أساليب عسكرية جديدة أكثر تلاؤما مع تحديات المرحلة، والإحاطة بوسائل الإعلام من أجل تغطية دعائية لسياستها، وربط جميع المساعدات والتعاملات المالية مع الدول بمدى انخراطها في منظومة "الحرب على الإرهاب". من بإمكانه اليوم إنكار أنه أصبح، رغما عنه وعن سيادة الدولة التي تحيطه بعنايتها، مواطنا أمريكيا بدرجة ما. تتدخل الأجهزة الأمريكية في تحديد أنظمة السفر ومعايير المعاملات المصرفية وطرق مراقبة المشبوهين (أي نحن جميعا) وتتولى في أحيان كثيرة أمر اعتقالهم خارج التراب الأمريكي وتوكل أمر استنطاقهم وتعذيبهم إلى من فرض كفاءته في هذا الميدان أكثر من غيره. ينبغي أن نعترف بأن ذلك الجهد كان خارقا وخارج دائرة التوقع منذ سبع سنوات وأن أهدافه الأساسية قد تحققت، ونحن نحسب أن أهدافه الأساسية ليست مطلقا منع القاعدة من تنظيم هجمات أو تحقيق عالم أكثر أمنا، بل إنتاج عالم جديد تمسك فيه الولايات المتحدة بمقاليد كل شيء، بكل المعلومات وكل المقدرات، مما يسهل تجيير جميع الطاقات لصالحها وفرض تأثيرها غير القابل للمقاومة على الكيانات الأخرى، حليفة كانت أو متحفظة. نكاد نجزم، لولا اعتراف القاعدة، بأن تلك الأجهزة هي من خطط للأمر برمته، ولكن هذه قضية أخرى. ما نريد تأكيده هنا هو ازدهار صناعة "الإرهاب" إلى حد لم نتصور أنها ستبلغه. تقوم صناعة "الإرهاب" على مكون أساسي توفره صناعة رديفة أخرى هي صناعة الخوف. وبين الخوف من "الإرهاب" و"الإرهاب" بدعوى القضاء على الخوف نقطع الخطوات المتبقية لنا نحو الزمن الأمريكي الكامل.
يضعنا الغرب في موضع المتهم باستمرار، إما لتخلفنا أو لثقافتنا "الراعية للإرهاب" أو لنفسيتنا المهووسة بالعداء له. وفي المقابل نحسن نحن لعب هذا الدور كما لم نحسن غيره. نلتفت داخلنا ونتساءل: من حق القوم أن يلومونا، فثقافتنا "تحرض على الإرهاب". ينتابنا الشك في فهمنا الذي كان إلى حد قريب بديهيا لأنفسنا، لواقعنا ولثقافتنا. ليس المقصود من وضعنا موضع الإتهام أن نلفظ تلك الثقافة فهم يحتاجون باستمرار إلينا حيث نحن، ليفهمونا كما يريدون. تنهال علينا الضربات وعندما نرفع أيدينا لنتقي بعضها تتأكد التهمة ويشرعون في تصفيتنا. في كلتا الحالتين يتهددنا الزوال.
لا يضعنا الآخرون في موقع أكثر سكينة باتهامنا واستهدافنا، لأننا "مسلمون سيؤون"، "منافقون ومنبطحون لهيمنة الغرب". لا يراد منا أن نكون مسلمين جيدين لأنهم سيفقدون بذلك "تميزهم" ومشيخات الرماد التي شيدوها على جثثنا. نلتفت مرة أخرى داخلنا ونتساءل: هل نحن سيؤون إلى هذه الدرجة؟ يتسمعون إلى تساؤل البعض منا فينهالون عليه بفيض تقواهم وجهادهم، قد ينجحون فيبلغنا بعد حين أنه انتقل إلى الضفة الأخرى، و"يحتسبونه عند الله شهيدا".
يتمعش الإستبداد من الوضع فيستلمنا ونحن على خوفنا ذاك، فيمتص ما بقي من الحياة داخلنا، ويلقي بنا بعد ذلك مكرهين في زمرة الرعية الراضية المرضية. لن يكون بالإمكان بعد ذلك أن نطلب لأنفسنا أو لغيرنا شيئا، يكفي أننا نتفس بين الحين والآخر. من بمقدوره اليوم أن يناقش استفادة الإستبداد من "الإرهاب"؟ فقط الإستبداد يشكك في ذلك (ومعه "الإرهاب" أحيانا). تكتمل حلقة الفناء من حولنا وقد اندثرت معالم حلم قديم بأن نكون مواطنين في دولة مواطنة. تلتقط دولة الرعية أنفاسها بعد محنة المساءلة الديمقراطية وتجد نفسها، مجددا، في وضعها المريح. تلعب دورها في الحرب على "الإرهاب" كأفضل ما يؤمل منها، تلتقط في الأثناء المناوئين لها وترمي بحقوق الناس إلى الجحيم. بعد ذلك يصبح بإمكانها القول أن القطيع بخير، "بلدة طيبة ورب غفور".
لا تستهدف "الحرب على الإرهاب" "الإرهاب" وإنما السيطرة على الأفراد بعد أن تكون قد قضت على كل روابط التضامن بينهم. تحاصر المميزات الثقافية في زوايا الصراع المظلمة فيبدأ مسار تذويب الهويات وتقترح العولمة الأمريكية بديلا لذلك كله. يضيق الإسلام في أثناء ذلك بمعتنقيه ويتحول عوضا عن كونه هوية منفتحة على الإنسانية ومتسعة باستمرار إلى بوتقة يحتكرها "المسلمون الجيدون" بعد أن قرروا أنهم من تنطبق عليهم الصفة. تنحسر حركة الحقوق في خلال ذلك تحت وطأة استبداد الدول التي اغتنمت فرصة وجودها ويصبح أقصى أمل الفرد أن يعود إلى بيته في المساء دون أن يكون ضحية قصف أو تفجير أو إيقاف عن طريق الخطأ. في خضم هذه السريالية القاسية يفقد الإنسان بوصلته ويعلم أنه لن يكون بإمكانه أن يعيش إنسانيته كما تعود في الماضي. الآن أصبح يفهم أن "الإرهاب" و"الحرب على الإرهاب" والإستبداد وما خفي من ملمات إنما تستهدفه كإنسان يراد له أن يكون قطعة بلا روح ولا إرادة في متاهة لا يعلم حدودها ولا مخارجها.



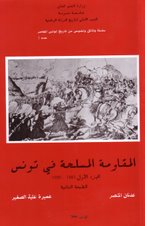



1 commentaire:
لماذا تتظاهر مواقف العنف عند المسلمين
إني أفكر ببساطة وبشجاعة...وكثيرا ما يقال لي انك على حق...إن مظاهر العنف عند المسلمين مشكلة أصولها واضحة ومن المذهل أن لا ينتبه لها أصحاب القرار
La Frustrationهذا العنف متأت مما يعبر عنه بالفرنسية : ومن المؤسف أن لا أجد في ذاكرتي كلمة عربية أو حتى باللغة العامية تؤدي هذا المعنى .أما المنجد فقد انجدني بعدة جمل متناثرة منها الحرمان من الحق وما شابه ذالك... الخ الخ... نعم المسلمون يعبرون كما يعبر الإنسان ـأو الطفل إذا حرم من حقه الشرعي وربما أيضا من حقه في الوجود..بقي أن نجد الكفاءة الأداريه لوضع الأمور في نصابها ونمكن كل ذي حق من حقه بكل عدالة اجتماعيه ونتمكن عندها من القضاء عما يسمونه بالإرهاب .ويفضي هذا الرأي المتواضع إلى السؤال التالي كيف يمكن أن تكون هيكلة الدولة الإسلامية المستقرة والتي توفر طاقاتها للعمل الجاد...هذه أطروحة لها رجالها الأكفاء...
و بكل حياد أقول بالهيكلة الإيرانية أو بما هو جار به في بلاد الفاتيكان حيث وجدت المعادلة المنشودة للتوفيق والؤام بين الإدارة السياسية والقطب الديني الذي يشعر بكيانه وحقه الشرعي في الوجود
Enregistrer un commentaire