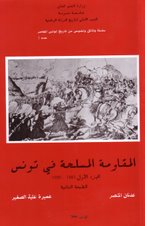بعض من دروس الأعداء
عدنان المنصر مؤرخ جامعي (تونس)
لا معنى لشهر ماي من كل عام دون تذكر فلسطين ونكبتنا. منذ إثنين وستين عاما والوضع على ما تركتنا عليه جيوش العرب وملوكها وجامعة دولها، لا بل أشد سوءا: شعب يقاوم في الوقت نفسه عسف المستوطنين وقهر الدول الكبرى، وظلم ذوي القربى، ومقومات صمود رسمي تتضاءل تحت شمس التاريخ الحارقة كجلد حمل ذبح منذ ستين عاما.
عندما ترك الأنقليز فلسطين للمستوطنين في ماي 1948، بعد ربع قرن قضوه هناك في تهيئة الظروف لشعب الله المختار حتى يضم إلى "تاريخه الطويل" قليلا من الجغرافيا العربية القاحلة، كان الإعتقاد أن الأمر لم يفلت تماما من يد العرب، وأن ما حصل ليس إلا حكم القوة الزائل تحت وطأة الإرادة المكافحة من أجل العروبة والإسلام وتحت قيادة جامعة المستبدين الناشئة والأنظمة الوطنية والقومية في المشرق الذي تنفس أخيرا ووضع عنه عهر سايكس وبيكو.
لا شيء كان يحرك العرب مثل فلسطين، وإن النظر في حركة التطوع التي شملت معظم البلدان العربية للقتال في فلسطين تبين أن الأمر قد هز الوجدان بطريقة أنست المستعمرين أنهم مستعمرون، والمستبد عليهم أنهم هم أيضا ضحايا التاريخ الجحود، مثل عرب فلسطين تماما. منذ ذلك الوقت والأمور لم تتغير إلا قليلا: شعوب تهتز لفلسطين في كل مجزرة للأرض والبشر، وتنسى في اهتزازها ذاك قيودها القديمة، وولاة أمور يتولون كل الأمور، ما ظهر منها وما بطن، تتجه نحوهم العيون فترتد في كل مرة خائبة حسيرة. منذ عقود ستة تتكرر هذه الحركة اليائسة والقاتلة، ذلك أن العرب مازالوا لا يعرفون النظرية التجريبية ويعتقدون أن التقاء نفس العوامل قد ينتج شيئا مختلفا في كل مرة...
عندما بدأت المنظمات الصهيونية في أوروبا ترسل بالمستوطنين إلى فلسطين العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر كان الأمر خطوة في مسار طويل انتقلت فيه "المسألة اليهودية" من مسألة أقلية دينية قابلة لوضعية الإضطهاد المعادي للسامية إلى وضعية قضية قومية تبحث عن حل سياسي. من زاوية تاريخية بحتة لا يمكن أن يبقى المرء ممتنعا عن ملاحظة الجهد الخارق الذي أنجزته الصهيونية كتعبير سياسي عن الحل القومي المنشود للمسألة اليهودية. ذلك ما يفسر دعوة رشيد رضا العرب، آنذاك، إلى الإستفادة من الدرس الذي قدمته الصهيونية، كانت تلك دعوة لا تعوزها الحكمة ولكنها بقيت إلى اليوم عويلا في صحراء التاريخ وقحط الثقافة السياسية العربية.
جاء نجاح الصهيونية في النهاية كمحصلة لتضافر عوامل مختلفة التقت في صعيد واحد يضيق المجال عن حصرها جميعا. على المستوى الفكري انتقلت الصهيونية الثقافية من وضع كانت المسألة اليهودية تطرح فيه بعبارات العاطفة والتباكي، إلى وضع مختلف تماما يمسك فيه اليهود بمصيرهم بأنفسهم ويعيدون تأسيس الهوية اليهودية من جديد. لم يبق في ذاكرتنا عن صهيونية هذه المرحلة سوى تيودور هرتزل. غير أن الرجل، رغم الجهد التنظيمي والتنظيري الذي قام به، لا يكاد يكون له كبير حضور في الذاكرة اليهودية المعاصرة إذا ما قورن بآخرين ممن هيأوا الفكر اليهودي لتقبل الصهيونية وتطويع الفهم التوراتي لضرورات المرحلة الجديدة، مثل ليو بينسكر وموشي لليانبلوم وأحد عام، وهم أيضا من التيار الصهيوني العلماني. إن أهم انتصار للفكرة الصهيونية هو ذلك الذي حققته داخل الفكر اليهودي فثورته وجعلت منه سندا للمشروع القومي الصهيوني. ما يجب الإحتفاظ به هو أنه في مثال الصهيونية لم يستغرق الجدل حول مسألة التوفيق بين المعتقد الديني والأهداف القومية سوى الوقت الضروري لتحقيق إقلاع آمن، بعد ذلك أمكن حل بقية التعقيدات المرتبطة بنقل المسألة من مجرد رؤية نظرية إلى مشروع مجسم على الأرض. من جهة أخرى، وفي تكامل تام مع هذا المسار، حصل تحالف متين بين أهم تيارين في الفكر الصهيوني: التيار العلماني والتيار الديني. كان تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية مظهرا من مظاهر نجاح هذا التحالف، وهي المنظمة التي أخذت على عاتقها متابعة إنجاز مراحل المشروع النهائي الهادف إلى تأسيس دولة لليهود في فلسطين. غير أن هذا التحالف لم يكن هدفه إنهاء الخلافات بين التيارين وإنما تنسيبها بدفعهما نحو انجاز مهمة واحدة وفي هياكل واحدة: كان هناك اتفاق على أن أهمية الهدف تلغي أية ذرائع لعدم التوحد، وهي قناعة لا تزال تقود المجتمع الصهيوني اليوم في مواجهة كل المسائل التي يطرحها استمرار وجوده. لقد قدمت المنظمات الصهيونية المتدينة، وخاصة منظمة "عشاق صهيون" القوة البشرية الدافعة للمشروع الصهيوني، ورغم مركزيتها في الحركة الصهيونية فإنها قبلت بالتحالف مع العلمانيين الصهيونيين (رغم ضعف تمثيليتهم ونخبويتهم) وحتى بالإندماجيين الذين انخرطوا من جهتهم في العمل الخيري عن طريق الدعم المالي للمستوطنين اليهود في فلسطين.
إن المشروع الصهيوني مشروع قومي بدرجة أولى، وديني بدرجة ثانية. يمثل الدين الغطاء الذي التحف به الجميع ذلك أنه كان يقدم الشرعية التوراتية العليا لكل المشروع مصبغا عليه هالة من القداسة. لا نفهم سر نجاح المشروع الصهيوني في إنجاز كيان سياسي بفلسطين دون أن نأخذ ذلك بعين الإعتبار: من منطلق استعماري بحت، كان العلمانيون في الحركة الصهيونية الذين صاغت الحركة الإستعمارية الأوروبية فكرهم إلى حد ما، ميالين للبحث عن مجال جغرافي مختلف لتأسيس كيان اليهود السياسي. لذلك فقد اتجهت أنظارهم نحو الأرجنتين على سبيل المثال، وهو أمر نجد له أثرا واضحا في كتاب هرتزل "دولة اليهود"، ذلك أنه كان يؤمن أنه لا نجاح لمشروع دولة ما لم تكن له قاعدة اقتصادية مريحة. غير أن هذاالتوجه كان يلغي الطابع الديني للمسألة اليهودية، وهو طابع حددته التعاليم التوراتية بوضوح من ناحية تأكيدها على أرض الميعاد: "السنة القادمة في أورشليم" لم تكن تعني "السنة القادمة في الأرجنتين" حتما. لو قدر للتيار العلماني في الحركة الصهيونية أن يواصل السير في تلك الطريق لكان الأمر قد قضي تماما ولعادت الفكرة الصهيونية فكرة نخبوية عاجزة عن أن تجسم على أرض الواقع. كانت تلك النخبة في حاجة إلى دعم بشري واسع، وككل مجتمع في مرحلة اضطهاد فقد كان الحقل الديني، بوصفه أحد أهم حقول الهوية تاريخيا، قادرا على مد النخبة بما تحتاجه: جمهور واسع من المتعطشين لتحقيق الأهداف الصهيونية يدفعه في ذلك إيمان توراتي لا يرقى إليه شك بعدالة الطموحات القومية اليهودية.
عندما نقول أن المشروع الصهيوني هو مشروع قومي بالأساس فإننا نعني أنه كان يقدم الحل لقضية قومية أصبح تجاوزها مستعصيا بالطرق القديمة. لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية الخدمات التي قدمتها اللاسامية للمشروع الصهيوني، بل إن هرتزل الذي كان أكثر الشخصيات الصهيونية وضوحا إزاء هذه القضية، اعتبر أن اللاسامية ليست مشكلة بل جزءا من الحل القومي، إذ أنها تعطي للمشروع الصهيوني قوته الدافعة عن طريق تحطيم آمال اليهود في الإندماج في المجتمعات الأوروبية، بغض النظر عن جدوى قوانين التحرير وتطبيقاتها حتى في البلدان التي لم تكن الحكومات فيها تغطي عمليات الإضطهاد (أوروبا الغربية).
من ناحية تاريخية أيضا لا يمكن نكران التأثر الذي أحدثته الفكرة القومية الأوروبية على الحركة الصهيونية بحيث بدت الصهيونية منسجمة في عصرها رغم حضور الطابع الديني فيها. وفي السياق ذاته فإن الحركة الإستعمارية الأوروبية التي عرفت أوجها في أواخر القرن التاسع عشر قد جعلت من تأسيس دولة على أرض الغير أمرا مقبولا به أخلاقيا من منطلق المهمة التمدينية التي قرر الغرب أن يضطلع بها في القارات المتخلفة، هذا أمر شديد الحضور في الخطاب الذي ألقاه تيودور هرتزل أمام القيصر الألماني في فلسطين (2 نوفمبر 1898). كانت الصهيونية منسجمة مع عصرها ، "عصرية تنمو من صميم أحوال اليوم الحاضر " كما قال في نفس الخطاب، ولا تشكل أي نشاز مع الفكر السائد في أوروبا ومع الطموحات القومية اليهودية.
هناك من جانب الصهيونية قدرة فائقة على التلاؤم مع عصرها وتوجيه كل العوامل لخدمة أهدافها النهائية، من هذاالمنطلق فإن استخدام التحالفات مع القوى الكبرى ليس العنصر الوحيد الذي خدم تحولها من فكرة إلى كيان سياسي، ذلك أن أهم التحولات قد جاءت نتاج حركة داخلية في الفكر اليهودي وضعت نصب عينيها تأسيس مشروع دولة، بغض النظر عن عدالة هذا التأسيس من عدمه. التاريخ إرادة الأقوى دائما، ومحصلة صراع إرادات. من المنطلق ذاته فإن الإيديولوجيا ليست مقدسة لذاتها بل هي عنصر من جملة عناصر يقع توظيفها في تحقيق إرادة الشعوب والأمم.
عندما جاء اليهود من شرق أوروبا كانوا قد حملوا معهم الأفكار الإشتراكية، مثلما حمل يهود أوروبا معهم الفكر الليبرالي الإقتصادي وتقديس الربح والمبادرة الفردية. بالموازاة مع التكامل الذي حصل بين العلمانيين والمتدينين، حصل تكامل آخر كان من نتائجه بناء مجتمع يهودي صهيوني قادر على البقاء، إلى حد ما، باستعمال موارده الذاتية.
كانت المستوطنات التي وقع تأسيسها على أراضي عربية (فرطت فيها الإقطاعية المحلية للمستطنين اليهود) قد بدأت البحث عن سبل بقائها بالتوجه نحو اقتصاد الربح، وهو أمر طبيعي باعتبار أن الممولين قد جاؤوا من أوساط الإستثمار والأعمال. لكن سرعان ما توقف الممولون أمام سؤال حارق: هل الهدف هو تحقيق الربح، أم وضع أسس مجتمع صهيوني مكتف بذاته وقادر على الإستمرار؟ هنا حصلت انعطافة كبرى أسهم فيها الإشتراكيون الصهيونيون عن طريق تصور مستوطنات خارجة عن الدورة النقدية، معولة فحسب على اليد العاملة اليهودية، وقائمة على العمل الجماعي التعاضدي. لم يتساءل الأولون إن كان ذلك مناقضا لمبدأ المبادرة الحرة، كما لم يتساءل الآخرون إن كان الأمر يسرع أو يؤخر قيام المجتمع العمالي على أرض الميعاد، ذلك أن الإيديولوجيا ليست مقدسة إلا في حدود قدرتها على تقديم إجابات لتحديات الواقع.
هناك جهد كبير يتوجب القيام به من أجل فهم طبيعة المشروع الصهيوني بفلسطين، ومن المعيب أن الأوساط المهتمة بقضية هذه الأرض وهذا الشعب تظل تنظر للمسألة من زاوية العداء الغريزي الذي لا يقدم بنا خطوة واحدة للأمام. كما أن هناك دروسا يفترض أن نتعلمها من الآخرين، وخاصة من أعدائنا الذين نجحوا. لا يتعامل مع مسائل كتلك التي يطرحها الصراع العربي الصهيوني من منطلق الكراهية أو المحبة فهذا حقل آخر قد يقع الإحتياج إليه في بعض الحالات، ولكنه قد يتحول إلى عبء على محاولة الفهم. طيلة عقود ستة، واجه العرب والمسلمون إسرائيل ومشروعها بالعواطف، لكن أقلية محدودة تعاملت مع الموضوع تعاملا عقلانيا وفهمت أن أول سبيل القدرة على مواجهة ذلك المشروع الذي لا يمكن اعتباره، في أدنى الحالات، سوى اعتداء على الإنسان وقيم العدالة، يمر بمحاولة تفكيك عناصره والتعامل العقلاني معه لاستباق التطورات التي قد تطرأ عليه، وبالتالي علينا.
طيلة عقود ستة هي تاريخ الصراع بين اسرائيل وجيرانها العرب، تركز أكبر جانب من الصراع الحقيقي بين القوميين واليساريين، وبين الشيوعيين والبعثيين، وبين أولئك أو بعضهم وبين الإسلاميين، متطرفهم ومعتدلهم. طيلة عقود ستة كانت فلسطين وقضيتها بضاعة رخيصة في سوق الإيديولوجيات الرثة، وغطاء يشرع لقيام الأنظمة وسقوطها وعنصرا قارا في التجاذبات بين الحكومات ومعارضيها. ما يثير الانتباه هو أن فلسطين التي تسكن قضيتها الوجدان العربي منذ عقود عديدة، وقبل اعلان قيام الكيان الصهيوني على أرضها، والتي يقول الجميع، من مختلف الحساسيات وفي كل الفضاءات، أنها قضيتهم الأولى التي يهون من أجلها كل شيء، لم تقدم الذريعة الكافية لتحقيق مثل هذا التوحد. يضيء ذلك الأهمية الحقيقية التي تحتلها هذه المأساة من وجداننا إذ أن المرء لا يضحي إلا من أجل ما يعتقد أنه يستحق تضحيته، وحتما فإن الإيديولوجيا عزيزة علينا جدا فقد ورثناها كابرا عن كابر ولا نرضى عنها بديلا، فنحن أمة ايديولوجيا، نعتقد أننا نسقط إذا سقطت. لا يرضى علمانيونا أن يقودهم متدينون، ولا يقبل متدينونا أن يتزعمهم علمانيون، فهناك حدود لكل شيء !
مقال صادربموقع الأوان
http://www.alawan.org/%D8%