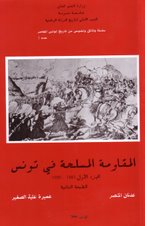الصراع في تركيا
عندما يحول العسكر اللائكية إلى دين جديد
عدنان المنصر
مقال صادر بالعدد 407 من جريدة الموقف التونسية بتاريخ 25 ماي و2007
وبصحيفة القدس العربي بتاريخ 16 جويلية 2007 ص 18
تعيش تركيا حاليا إرهاصات أزمة ليست في الحقيقة وليدة اليوم، بل إن جذورها تمتد عميقا في تاريخها منذ ما يناهز القرن. وبحسب الموقع الإيديولوجي فعادة ما يقع إرجاع سبب هذه الأزمة إما إلى انغماس الأتراك منذ عهد مصطفى كمال في تجربة وضعت حدا، أو كان يفترض أن تضع حدا، لانتماء تركيا الحضاري، أو على العكس من ذلك للعوائق التي ما انفك جانب من الأتراك يضعها أمام تطور تركيا العصرية وما تعنيه، أو ما قد تعنيه، من قيم الحداثة والديمقراطية والتنمية.
ولعل جانبا من اهتمامنا نحن، غير الأتراك، بهذا الموضوع يعود إلى أن ما يجري في تركيا من صراع مكتوم بين أبناء الكمالية ومعارضيها، يمثل نموذجا لما يفترض أن يؤول إليه الصراع بين تيارين اتضحت معالمهما في عالمنا العربي، تيار يدعي الانتساب إلى الحداثة رافعا لواء التقدمية، وآخر يدعي أنه المعبر عن نبض الشارع في رفضه لما يقول أنه إقصاء الدين من الحياة العامة الذي من شأنه، إن تم، أن يعمق انبتات المجتمع عن قيمه الثقافية وانتمائه الحضاري.
ليس من السهل توصيف الوضع كما يبدو بدون استعمال مصطلحات مثل "علماني" أو "لائكي". ولكن بالرغم من الطابع الإشكالي لهذه المصطلحات إلا أنها الأكثر استعمالا اليوم لتوصيف القوى المتقابلة في معركة لا تريد أن تنتهي. ويعود الطابع الإشكالي لهذه المصطلحات في أنها عادة ما تستعمل في غير السياق الذي نشأت فيه، كما أن لفظ لائكية الذي يقدم عادة كمرادف للفظ علمانية يختزل سياقا تاريخيا مختلفا عن ذلك الذي ظهرت فيه العلمانية. فإذا كانت اللائكية قد ظهرت بفرنسا كرد فعل على قرون السيطرة الكنسية ورغبة في التحرر من ربقة رجال الدين الذين كانوا يسيطرون على الفضاء العمومي بمساندة من الملكية ، فإن العلمانية قد ظهرت بأنقلترا كطريقة مختلفة للنظر إلى العالم خارج التصنيفات والتقسيمات التي كان يفرضها الفكر الديني المسيحي. من هنا تبدو العلمانية في نشأتها أوسع مجالا من اللائكية، ففي حين نظر مبدعوها إلى المجتمع ككل، بما هو منظومة قيم ومعارف، محاولين تأسيس أو إعادة اكتشاف وجود اجتماعي مختلف عن ذلك الذي ترعاه المسيحية، فإن اللائكية كانت تضع نصب عينيها جزءا بعينه من هذا الوجود الاجتماعي، وهو المتعلق بحقل السلطة الزمنية، ساعية إلى تحرير السياسة والحكم من نفوذ طبقة ذات وجود ملموس ومصالح بينة.
وقد كان لهذا الفارق في النشأة بين المصطلحين تأثير مباشر على تطور الممارسة السياسية للنظامين الناتجين عن كلا المفهومين. ففي حين أسست العلمانية لممارسة بعيدة كل البعد عن العداء للدين وللممارسة الدينية، فإن اللائكية عادة ما استخدمت غطاء لتأسيس نظام غير متسامح مع الظاهرة الدينية. بل إن العلمانية مثلت حلا لمشكلة التعايش، داخل نظام سياسي واحد، بين الطوائف والمذاهب المختلفة وربما المتناقضة، مثلما هو الشأن في الولايات المتحدة منذ الاستقلال، حيث يسمح بالتدين، ويمكن للرئيس والوزراء أن يؤدوا صلاتهم في الكنائس وهو أمر لا يثير أي إشكال طالما أن الدولة تعامل جميع المذاهب بنفس الطريقة. من هنا فإن العلمانية تبدو ضمانة للمجتمعات متعددة الثقافات، وهو ما يفسر التسامح الأنقليزي مع الاختلافات الثقافية للجاليات المقيمة في بريطانيا، بحيث يسمح لها بالتعبير عن انتمائها الثقافي سواء باللباس أو الاحتفال أو التدين الظاهر. هذا الهامش من التسامح لا نجده في اللائكية التي ظلت تحتفظ بنظرة عدائية للدين حتمت عليها البقاء مستنفرة لقمع أية مظاهر ثقافية خصوصية ذات طابع ديني، مثلما أوضحت ذلك قضية الحجاب في فرنسا أخيرا.
غير أننا قد لا نكون موضوعيين إزاء اللائكية إذا ما تعمدنا تفسير المصطلح بالممارسة الحالية التي يمكن أن تكون قد انزاحت بمرور الوقت عن الممارسة اللائكية الأصلية. فإذا عدنا إلى الظرفية التي أصبحت فيها اللائكية سياسة رسمية للدولة الفرنسية لوجدنا أن نواب الأمة الفرنسية رغم تصويتهم في 1905 على القانون الخاص بفصل الكنيسة عن الدولة إلا أنهم رفضوا بوضوح أن يؤول ذلك كعداء للدين أو للكنيسة بما أنهما دين وكنيسة. كانت العملية مجرد توزيع للمهام في حقل السلطة بحيث بدت كطلاق بالتراضي بالرغم من الضغوط التي واجهها مشروع القانون آنذاك من قبل "اللائكيين المتشددين" الذين أرادوا أن تبقى للدولة اليد الطولى في الشؤون الدينية من ناحية تعيين الكهنة والتصرف في الأملاك الكنسية وذلك في إطار الصراع بين الدولة الفرنسية والفاتيكان. وكانت تلك الضغوط تهدد بسقوط مشروع الفصل برمته باعتبار أن أنصار الكنيسة داخل المؤسسة التشريعية الفرنسية لم يكونوا بالضعف الذي قد يتصوره البعض. وهكذا جاء نص القانون في نهاية الأمر نتاج توافق على حل وسط بين اللائكيين وأنصار الكنيسة من حيث أنه أكد في فصله الأول على أن الجمهورية تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وفي فصله الثاني على أن الدولة لا تتحمل أية نفقات ولا تدفع أية رواتب للقائمين على المؤسسات الدينية. من هنا فقد كان طلاقا بالتراضي استعاد طرفاه حريتهما الكاملة دون تدخل في شؤون الآخر، وكان أنصار الكنيسة قد حققوا بذلك ما اعتقدوا أنه، في تلك الظروف، أكثر أهمية من التدخل في الشأن السياسي: حرية ممارستهم الدينية دون تدخل من أي نوع كان من قبل الدولة.
وبالعودة إلى تركيا، ففي أية الخانتين نصنف نظامها السياسي؟ لا تبدو تسمية الدولة العلمانية معبرة عن واقع الأتراك اليوم باعتبار أن الاختلافات الدينية والثقافية لا تحظى باحترام خاص من قبل الدولة حيث غالبا ما يصنف أصحابها كانفصاليين تجيش الدولة كل قواها لمحاربتهم باعتبار أنهم يهددون وحدة "الأمة التركية". كما أن تسمية الدولة اللائكية لا تبدو دقيقة هي الأخرى باعتبار أن الدولة لا تزال تضطلع بجملة من المهام الدينية لعل من ضمنها تخصيص حصص دينية للتلاميذ في المدارس الحكومية بالإضافة إلى تعيين الأئمة والمفاتي واعتبارها أماكن العبادة ملكا للدولة. من هنا فإن لائكية الأتراك تبدو في اتجاه واحد: لا حق للدين في التدخل في شؤون الدولة ولكن يحق للدولة أن تتدخل في شؤون الدين وأن تستغله وتستغل مؤسساته وتأثيره لاعتبارات سياسية.
إن تطور الوضع في تركيا طيلة النصف الثاني من هذا القرن قد بين اتجاها جديدا للنظام السياسي في هذا البلد. فبالرغم من أن اللائكية، في نسختها الفرنسية الأصلية أو في نسختها التركية المعدلة قد احتفظت بعلاقة انفصال عن الدين أو استبعاد واستغلال له، إلا أنها في مسيرتها الهجينة قد تحولت بدورها إلى دين جديد ضبطت طقوسه وممارساته وسبل حمايته في نصوص الدستور وعهد لأجهزة الدولة العسكرية والسياسية والخفية بحماية وجوده. فقد استثنى دستور 1982 ثلاث مواد من أية إمكانية للتحوير أو التغيير أو الحذف بل وحرم حتى تقديم مقترحات بالمساس بها، وهي المواد التي تنص على لائكية الدولة التركية. من هنا فقد وضعت المؤسسة العسكرية المؤتمنة على التوجهات الكمالية والتي أوحت بذلك الدستور خطا يحرم تجاوزه حتى على نواب الأمة في مجتمع يفترض أنه ديمقراطي بقدر ما هو لائكي. من هنا فإن الدستور التركي لا يبدو في الجوهر أقل تشددا من الدستور الإيراني من حيث التأكيد على الشكل النهائي للدولة. وتؤكد الممارسة هذه الفكرة بشكل لا يقبل القدح، فبين 1960 و 1997 نفذ الجيش التركي أربعة انقلابات على الحكومة (1960،1971،1980،1997) بدعوى حماية الإرث الكمالي مما اعتقد أنه تهديد محدق باللائكية، وفي جميع هذه الانقلابات كان المستهدف هي حكومات منتخبة ديمقراطيا. بل إن الجيش قام غداة انقلاب 1960 بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في محاكمة انتهت فصولها بإعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس (الذي كان حزبه قد فاز فوزا ساحقا في انتخابات 1954 و 1957) ووزيري الخارجية والمالية، في حين حكم على رئيس الجمهورية بالسجن مدى الحياة، وقد كانوا جميعا أبناء شرعيين للكمالية. غداة ذلك الانقلاب صدر دستور جديد أحكم من خلاله العسكر قبضتهم على الدولة وهو دستور 1961 الذي نص في فصوله على بعث مجلس للأمن القومي يسيطر العسكر على أغلبية مقاعده و يمتلك حق نقض كل القرارات المتخذة.
تبدو تركيا من هذا المنطلق مجرد ديكتاتورية عسكرية بملابس مدنية حيث يحتكر الجيش صياغة السياسة العامة للدولة بمعزل عن المؤسسات الديمقراطية المفترض أنها تعبر عن السيادة الشعبية. غير أن سيطرة العسكر المطلقة على الوضع بدأت فيما يبدو بالتراخي تحت تأثير عوامل عديدة. ولعل السعي للاستجابة للمقاييس الأوروبية كشرط للنظر في ملف انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي هو أحد هذه العوامل التي يحاول أنصار أوردوغان الاستفادة منها اليوم. من هنا فقد قبل العسكر بأن يصبحوا أقلية في مواجهة المدنيين في مجلس الأمن القومي، بل إنهم لجئوا أخيرا إلى تغيير طريقة سلوكهم في الساحة السياسية عن طريق الإحجام عن التدخل المباشر بمناسبة تقديم عبد الله غول ترشحه لمنصب الرئاسة وأحيل أمر البت في دستورية نصاب الجلسة البرلمانية لانتخاب الرئيس إلى المحكمة العليا التي يبدو أنها اكتفت بتطبيق الدستور. من هنا يبدو الإتحاد الأوروبي عاملا قويا من بين العوامل الدافعة نحو تراجع تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، وهو ما يعني أيضا أن مجرد بقاء أمل الأتراك معلقا بالانتماء إلى هذا الإطار الجغراسياسي من شأنه أن يحمي الحياة الديمقراطية التركية من عدوها الأساسي وهو العسكر. بذلك يمكن أن نفهم أن مئات الآلاف من الأتراك الذين خرجوا في الأسابيع الأخيرة للتظاهر ضد حزب العدالة والتنمية، وهي ممارسة ديمقراطية لا لبس فيها، قد هتفوا أيضا ضد تدخل الجيش في الحياة السياسية محذرين من انقلابه مرة أخرى على الحكومة. ذلك أن جانبا هاما من أنصار النظام اللائكي قد اتضح لهم بعد تجارب مريرة عديدة مع المؤسسة العسكرية أن هذه المؤسسة لا تدافع عن اللائكية بقدر دفاعها عن المصالح التي نجحت في بنائها طيلة حوالي الثمانين عاما من حكم تركيا. من هنا فقد حولت اللائكية إلى نوع من الإيديولوجيا، إلى رأسمال رمزي تستثمره في مواجهة القوى السياسية الأخرى المهددة لسيطرتها على المجتمع. في حين تحول أعضاؤها إلى ما يشبه الكهنوت، إلى طغمة ذات مصالح مادية واضحة.
من هنا فإن الصراع الحقيقي في تركيا اليوم، كما في كل البلدان ذات الديمقراطية الغضة، هو صراع بين المجتمع والاستبداد، سواء كان هذا الاستبداد متدثرا بعباءة الدين أو العسكر أو الاقتصاد. وعلى نتيجة هذا الصراع يتوقف ما هو حياتي بالنسبة لهذا المجتمع: صيانة الديمقراطية الحقيقية المنظمة للاختلاف والضامنة للتداول السلمي على السلطة بما يعبر عن طموحات المواطنين. أما ما عدى ذلك من صراعات، فإن مؤسسات النظام الديمقراطي واحترام الجميع للمبادئ التي يسير عليها كفيلة بعدم تطورها إلى الحد الذي تخرج معه عن السيطرة. لذلك فإن بإمكان الأتراك، بما يملكونه من حيوية وتجربة، أن ينجحوا هذه المرة في تحقيق لائكيتهم الحقيقية، تلك اللائكية التي ستضع إن نجحت حدا لسيطرة الكنيسة الجديدة، كنيسة العسكر المتدثر بالعلمانية، المتخم بالمصالح والاستبداد.
عدنان المنصر
مقال صادر بالعدد 407 من جريدة الموقف التونسية بتاريخ 25 ماي و2007
وبصحيفة القدس العربي بتاريخ 16 جويلية 2007 ص 18
تعيش تركيا حاليا إرهاصات أزمة ليست في الحقيقة وليدة اليوم، بل إن جذورها تمتد عميقا في تاريخها منذ ما يناهز القرن. وبحسب الموقع الإيديولوجي فعادة ما يقع إرجاع سبب هذه الأزمة إما إلى انغماس الأتراك منذ عهد مصطفى كمال في تجربة وضعت حدا، أو كان يفترض أن تضع حدا، لانتماء تركيا الحضاري، أو على العكس من ذلك للعوائق التي ما انفك جانب من الأتراك يضعها أمام تطور تركيا العصرية وما تعنيه، أو ما قد تعنيه، من قيم الحداثة والديمقراطية والتنمية.
ولعل جانبا من اهتمامنا نحن، غير الأتراك، بهذا الموضوع يعود إلى أن ما يجري في تركيا من صراع مكتوم بين أبناء الكمالية ومعارضيها، يمثل نموذجا لما يفترض أن يؤول إليه الصراع بين تيارين اتضحت معالمهما في عالمنا العربي، تيار يدعي الانتساب إلى الحداثة رافعا لواء التقدمية، وآخر يدعي أنه المعبر عن نبض الشارع في رفضه لما يقول أنه إقصاء الدين من الحياة العامة الذي من شأنه، إن تم، أن يعمق انبتات المجتمع عن قيمه الثقافية وانتمائه الحضاري.
ليس من السهل توصيف الوضع كما يبدو بدون استعمال مصطلحات مثل "علماني" أو "لائكي". ولكن بالرغم من الطابع الإشكالي لهذه المصطلحات إلا أنها الأكثر استعمالا اليوم لتوصيف القوى المتقابلة في معركة لا تريد أن تنتهي. ويعود الطابع الإشكالي لهذه المصطلحات في أنها عادة ما تستعمل في غير السياق الذي نشأت فيه، كما أن لفظ لائكية الذي يقدم عادة كمرادف للفظ علمانية يختزل سياقا تاريخيا مختلفا عن ذلك الذي ظهرت فيه العلمانية. فإذا كانت اللائكية قد ظهرت بفرنسا كرد فعل على قرون السيطرة الكنسية ورغبة في التحرر من ربقة رجال الدين الذين كانوا يسيطرون على الفضاء العمومي بمساندة من الملكية ، فإن العلمانية قد ظهرت بأنقلترا كطريقة مختلفة للنظر إلى العالم خارج التصنيفات والتقسيمات التي كان يفرضها الفكر الديني المسيحي. من هنا تبدو العلمانية في نشأتها أوسع مجالا من اللائكية، ففي حين نظر مبدعوها إلى المجتمع ككل، بما هو منظومة قيم ومعارف، محاولين تأسيس أو إعادة اكتشاف وجود اجتماعي مختلف عن ذلك الذي ترعاه المسيحية، فإن اللائكية كانت تضع نصب عينيها جزءا بعينه من هذا الوجود الاجتماعي، وهو المتعلق بحقل السلطة الزمنية، ساعية إلى تحرير السياسة والحكم من نفوذ طبقة ذات وجود ملموس ومصالح بينة.
وقد كان لهذا الفارق في النشأة بين المصطلحين تأثير مباشر على تطور الممارسة السياسية للنظامين الناتجين عن كلا المفهومين. ففي حين أسست العلمانية لممارسة بعيدة كل البعد عن العداء للدين وللممارسة الدينية، فإن اللائكية عادة ما استخدمت غطاء لتأسيس نظام غير متسامح مع الظاهرة الدينية. بل إن العلمانية مثلت حلا لمشكلة التعايش، داخل نظام سياسي واحد، بين الطوائف والمذاهب المختلفة وربما المتناقضة، مثلما هو الشأن في الولايات المتحدة منذ الاستقلال، حيث يسمح بالتدين، ويمكن للرئيس والوزراء أن يؤدوا صلاتهم في الكنائس وهو أمر لا يثير أي إشكال طالما أن الدولة تعامل جميع المذاهب بنفس الطريقة. من هنا فإن العلمانية تبدو ضمانة للمجتمعات متعددة الثقافات، وهو ما يفسر التسامح الأنقليزي مع الاختلافات الثقافية للجاليات المقيمة في بريطانيا، بحيث يسمح لها بالتعبير عن انتمائها الثقافي سواء باللباس أو الاحتفال أو التدين الظاهر. هذا الهامش من التسامح لا نجده في اللائكية التي ظلت تحتفظ بنظرة عدائية للدين حتمت عليها البقاء مستنفرة لقمع أية مظاهر ثقافية خصوصية ذات طابع ديني، مثلما أوضحت ذلك قضية الحجاب في فرنسا أخيرا.
غير أننا قد لا نكون موضوعيين إزاء اللائكية إذا ما تعمدنا تفسير المصطلح بالممارسة الحالية التي يمكن أن تكون قد انزاحت بمرور الوقت عن الممارسة اللائكية الأصلية. فإذا عدنا إلى الظرفية التي أصبحت فيها اللائكية سياسة رسمية للدولة الفرنسية لوجدنا أن نواب الأمة الفرنسية رغم تصويتهم في 1905 على القانون الخاص بفصل الكنيسة عن الدولة إلا أنهم رفضوا بوضوح أن يؤول ذلك كعداء للدين أو للكنيسة بما أنهما دين وكنيسة. كانت العملية مجرد توزيع للمهام في حقل السلطة بحيث بدت كطلاق بالتراضي بالرغم من الضغوط التي واجهها مشروع القانون آنذاك من قبل "اللائكيين المتشددين" الذين أرادوا أن تبقى للدولة اليد الطولى في الشؤون الدينية من ناحية تعيين الكهنة والتصرف في الأملاك الكنسية وذلك في إطار الصراع بين الدولة الفرنسية والفاتيكان. وكانت تلك الضغوط تهدد بسقوط مشروع الفصل برمته باعتبار أن أنصار الكنيسة داخل المؤسسة التشريعية الفرنسية لم يكونوا بالضعف الذي قد يتصوره البعض. وهكذا جاء نص القانون في نهاية الأمر نتاج توافق على حل وسط بين اللائكيين وأنصار الكنيسة من حيث أنه أكد في فصله الأول على أن الجمهورية تضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وفي فصله الثاني على أن الدولة لا تتحمل أية نفقات ولا تدفع أية رواتب للقائمين على المؤسسات الدينية. من هنا فقد كان طلاقا بالتراضي استعاد طرفاه حريتهما الكاملة دون تدخل في شؤون الآخر، وكان أنصار الكنيسة قد حققوا بذلك ما اعتقدوا أنه، في تلك الظروف، أكثر أهمية من التدخل في الشأن السياسي: حرية ممارستهم الدينية دون تدخل من أي نوع كان من قبل الدولة.
وبالعودة إلى تركيا، ففي أية الخانتين نصنف نظامها السياسي؟ لا تبدو تسمية الدولة العلمانية معبرة عن واقع الأتراك اليوم باعتبار أن الاختلافات الدينية والثقافية لا تحظى باحترام خاص من قبل الدولة حيث غالبا ما يصنف أصحابها كانفصاليين تجيش الدولة كل قواها لمحاربتهم باعتبار أنهم يهددون وحدة "الأمة التركية". كما أن تسمية الدولة اللائكية لا تبدو دقيقة هي الأخرى باعتبار أن الدولة لا تزال تضطلع بجملة من المهام الدينية لعل من ضمنها تخصيص حصص دينية للتلاميذ في المدارس الحكومية بالإضافة إلى تعيين الأئمة والمفاتي واعتبارها أماكن العبادة ملكا للدولة. من هنا فإن لائكية الأتراك تبدو في اتجاه واحد: لا حق للدين في التدخل في شؤون الدولة ولكن يحق للدولة أن تتدخل في شؤون الدين وأن تستغله وتستغل مؤسساته وتأثيره لاعتبارات سياسية.
إن تطور الوضع في تركيا طيلة النصف الثاني من هذا القرن قد بين اتجاها جديدا للنظام السياسي في هذا البلد. فبالرغم من أن اللائكية، في نسختها الفرنسية الأصلية أو في نسختها التركية المعدلة قد احتفظت بعلاقة انفصال عن الدين أو استبعاد واستغلال له، إلا أنها في مسيرتها الهجينة قد تحولت بدورها إلى دين جديد ضبطت طقوسه وممارساته وسبل حمايته في نصوص الدستور وعهد لأجهزة الدولة العسكرية والسياسية والخفية بحماية وجوده. فقد استثنى دستور 1982 ثلاث مواد من أية إمكانية للتحوير أو التغيير أو الحذف بل وحرم حتى تقديم مقترحات بالمساس بها، وهي المواد التي تنص على لائكية الدولة التركية. من هنا فقد وضعت المؤسسة العسكرية المؤتمنة على التوجهات الكمالية والتي أوحت بذلك الدستور خطا يحرم تجاوزه حتى على نواب الأمة في مجتمع يفترض أنه ديمقراطي بقدر ما هو لائكي. من هنا فإن الدستور التركي لا يبدو في الجوهر أقل تشددا من الدستور الإيراني من حيث التأكيد على الشكل النهائي للدولة. وتؤكد الممارسة هذه الفكرة بشكل لا يقبل القدح، فبين 1960 و 1997 نفذ الجيش التركي أربعة انقلابات على الحكومة (1960،1971،1980،1997) بدعوى حماية الإرث الكمالي مما اعتقد أنه تهديد محدق باللائكية، وفي جميع هذه الانقلابات كان المستهدف هي حكومات منتخبة ديمقراطيا. بل إن الجيش قام غداة انقلاب 1960 بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة في محاكمة انتهت فصولها بإعدام رئيس الوزراء عدنان مندريس (الذي كان حزبه قد فاز فوزا ساحقا في انتخابات 1954 و 1957) ووزيري الخارجية والمالية، في حين حكم على رئيس الجمهورية بالسجن مدى الحياة، وقد كانوا جميعا أبناء شرعيين للكمالية. غداة ذلك الانقلاب صدر دستور جديد أحكم من خلاله العسكر قبضتهم على الدولة وهو دستور 1961 الذي نص في فصوله على بعث مجلس للأمن القومي يسيطر العسكر على أغلبية مقاعده و يمتلك حق نقض كل القرارات المتخذة.
تبدو تركيا من هذا المنطلق مجرد ديكتاتورية عسكرية بملابس مدنية حيث يحتكر الجيش صياغة السياسة العامة للدولة بمعزل عن المؤسسات الديمقراطية المفترض أنها تعبر عن السيادة الشعبية. غير أن سيطرة العسكر المطلقة على الوضع بدأت فيما يبدو بالتراخي تحت تأثير عوامل عديدة. ولعل السعي للاستجابة للمقاييس الأوروبية كشرط للنظر في ملف انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي هو أحد هذه العوامل التي يحاول أنصار أوردوغان الاستفادة منها اليوم. من هنا فقد قبل العسكر بأن يصبحوا أقلية في مواجهة المدنيين في مجلس الأمن القومي، بل إنهم لجئوا أخيرا إلى تغيير طريقة سلوكهم في الساحة السياسية عن طريق الإحجام عن التدخل المباشر بمناسبة تقديم عبد الله غول ترشحه لمنصب الرئاسة وأحيل أمر البت في دستورية نصاب الجلسة البرلمانية لانتخاب الرئيس إلى المحكمة العليا التي يبدو أنها اكتفت بتطبيق الدستور. من هنا يبدو الإتحاد الأوروبي عاملا قويا من بين العوامل الدافعة نحو تراجع تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي، وهو ما يعني أيضا أن مجرد بقاء أمل الأتراك معلقا بالانتماء إلى هذا الإطار الجغراسياسي من شأنه أن يحمي الحياة الديمقراطية التركية من عدوها الأساسي وهو العسكر. بذلك يمكن أن نفهم أن مئات الآلاف من الأتراك الذين خرجوا في الأسابيع الأخيرة للتظاهر ضد حزب العدالة والتنمية، وهي ممارسة ديمقراطية لا لبس فيها، قد هتفوا أيضا ضد تدخل الجيش في الحياة السياسية محذرين من انقلابه مرة أخرى على الحكومة. ذلك أن جانبا هاما من أنصار النظام اللائكي قد اتضح لهم بعد تجارب مريرة عديدة مع المؤسسة العسكرية أن هذه المؤسسة لا تدافع عن اللائكية بقدر دفاعها عن المصالح التي نجحت في بنائها طيلة حوالي الثمانين عاما من حكم تركيا. من هنا فقد حولت اللائكية إلى نوع من الإيديولوجيا، إلى رأسمال رمزي تستثمره في مواجهة القوى السياسية الأخرى المهددة لسيطرتها على المجتمع. في حين تحول أعضاؤها إلى ما يشبه الكهنوت، إلى طغمة ذات مصالح مادية واضحة.
من هنا فإن الصراع الحقيقي في تركيا اليوم، كما في كل البلدان ذات الديمقراطية الغضة، هو صراع بين المجتمع والاستبداد، سواء كان هذا الاستبداد متدثرا بعباءة الدين أو العسكر أو الاقتصاد. وعلى نتيجة هذا الصراع يتوقف ما هو حياتي بالنسبة لهذا المجتمع: صيانة الديمقراطية الحقيقية المنظمة للاختلاف والضامنة للتداول السلمي على السلطة بما يعبر عن طموحات المواطنين. أما ما عدى ذلك من صراعات، فإن مؤسسات النظام الديمقراطي واحترام الجميع للمبادئ التي يسير عليها كفيلة بعدم تطورها إلى الحد الذي تخرج معه عن السيطرة. لذلك فإن بإمكان الأتراك، بما يملكونه من حيوية وتجربة، أن ينجحوا هذه المرة في تحقيق لائكيتهم الحقيقية، تلك اللائكية التي ستضع إن نجحت حدا لسيطرة الكنيسة الجديدة، كنيسة العسكر المتدثر بالعلمانية، المتخم بالمصالح والاستبداد.