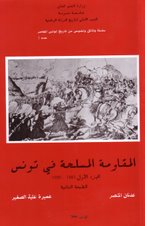هؤلاء المثقفون الذين يجرؤون... قليلا
قراءة في كتاب ريجيس دوبريه الأخير "رسالة إلى صديق اسرائيلي"
هل بدأ اتجاه البخار في الانقلاب داخل السّاحة الثقافية الفرنسية تجاه الصراع العربيّ الإسرائيليّ؟ ذلك ما قد توحي به نظرة سريعة إلى الإنتاج الثقافيّ الفرنسيّ بمختلف أشكاله في المدّة الأخيرة حيث تصاعدت أصوات تثير الشكّ في الأسس التي قامت عليها الدعاية الصهيونية في الأوساط الأوروبية ، ورغم أنّ معظم هؤلاء لا يشيرون في الغالب من قريب ولا من بعيد إلى روجيه قارودي، فإنّه يبدو أنّ كتابه الأخير "الأساطير المؤسّسة للسياسة الإسرائيلية" والزوبعة التي قامت حوله والحكم القضائيّ الصادر ضدّه بتهمة "المراجعة" أو نفي المحرقة، قد كان له بعض الفضل في إعادة موضوع الصهيونية إلى دائرة الجدل في الساحة الثقافية الفرنسية بصفة خاصة.
من المفيد أن نشير في هذا السياق إلى أنّ المثقّفين الفرنسيّين الذين يجرؤون على التحدّث في الموضوع بعين شديدة النقد للإيديولوجيا الصهيونية وللسياسة الإسرائيلية، ما عادوا يأتون من دوائر اليمين الفرنسي وحده مثلما كان الأمر في الماضي، فتثار الشكوك في سلامة نواياهم كلّما تحدّثوا عن إسرائيل، وتكون تهمة معاداة السامية السيف المُصلتَ عليهم باستمرار، وهي تهمة ليسوا بريئين منها تماما، ولكنها قاصرة عن توضيح تعقيدات الموقف من الصهيونية وارتباطاتها باليهودية وبالسياسة الإسرائيلية الحالية تجاه الفلسطينيين والمحيط العربي.
في هذا السياق يأتي كتاب ريجيس دوبريه Regis Debray الأخير "رسالة إلى صديق اسرائيلي، مع رد لأيلي برنافي" الصادر عن دار فلاماريون الفرنسية للنشر في شهر ماي 2010 والواقع في 160 صفحة خصص الكاتب أكثر من 120 منها لنقد السياسة الإسرائيلية مع إضاءات على تطوّر الإيديولوجيا الصهيونية وسياسة التمييز التي يستفيد منها اليهود في فرنسا على حساب الأقليات الدينية والقومية الأخرى، في حين استغرق ردّ إيلي برنافي، المؤرّخ والديبلوماسي الإسرائيلي، باقي الكتاب.

يأتي ريجيس دوبريه من فضاء ثقافيّ وفكريّ معيّن يصعب تصنيفه على أنه من اليمين أو من اليسار، فالرجل يموقع نفسه في "الديغولية اليسارية" أو "أقصى اليسار الديغولي" وهو تصنيف فرنسيّ داخليّ ولكنّه يضيء جانبا من التزام الرجل الفكريّ. من المعروف أنّ ريجيس دوبريه كان مساندا نشيطا لحركات التحرّر المناهضة للامبريالية الأمريكية وأنّه قضى فترة في السجن في بوليفيا (1967-1971) بسبب دوره في دعم الثوّار الشيوعيين، كما أنّ صداقاته الشخصية مع رموز الحركات الثورية مثل تشي غيفارا من الأمور المعلومة التي تؤكّد التزام الرجل الفكريّ والسياسي. على المستوى الأكاديميّ نشر ريجيس دوبريه عشرات الكتب في مواضيع فكرية متنوّعة يجمع بينها خصوصا اهتمامه بالشأن الديني، كما أدار مشاريع ومؤسسات بحث أكاديميّ عديدة وتسلّم مناصب إدارية وسياسية استشارية ذات قيمة في الحكومة الفرنسية (1981-1985).
إن كتاب دوبريه الأخير تواصل لالتزامه السياسي والفكري والأكاديمي على حدّ سواء، فالمؤلف الذي يعبّر بطريقة شديدة الوضوح عن اشمئزازه من السياسة الإسرائيلية، لا يهمل قراءتها على ضوء تطوّر الفكر الصهيوني والثقافة الدينية اليهودية، وكذلك على ضوء علم اجتماع السياسة. لا يمكن اتّهام ريجيس دوبريه بمعاداة السامية، حتى من قبل أعتى المدافعين عن اسرائيل، لذلك فإنّ الرجل يبدي حرية كبيرة في التنقّل بين نقد السياسة الإسرائيلية وإبداء الرأي في الإستهتار الذي تمارسه الدعاية الإسرائيلية تجاه الرأي العامّ الأوروبي، مع انتقاد لا شبهة فيه للّوبي الصهيوني داخل الدوائر السياسة الفرنسيّة، إضافة إلى البحث، في قالب قراءة بعيدة المدى، عن الأسس التي تقوم عليها السياسة الإسرائيلية الحالية، وهي أسس لاحظ انبثاقها من تطوّر الإيديولوجيا الصهيونية ذاتها، وضعف العلمانيين داخلها وتراجعهم لفائدة المتديّنيين الذين يقودهم الحاخامات.
يوجّه ريجيس دوبريه خطابه شكلا إلى إيلي برنافي Elie Barnavi المؤرخ اإسرائيلي ذي الأصل الروماني الذي يدير مركز الدراسات الدولية في جامعة تل أبيب وصاحب عديد الدراسات حول التاريخ اليهودي وتاريخ الأديان أيضا، والسفير الإسرائيلي في باريس طيلة الفترة من 2000 إلى 2002، إضافة إلى نشاطه ضمن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية. من هذا المنطلق فإنّ ريجيس دوبريه إنّما يناقش أكاديميا مثله مختصا في علم الإجتماع الديني وسياسيا من نفس الأفق الاشتراكي العلماني، ما يفترض أنّ الرجلين متّفقان على كثير من المنطلقات الإيديولوجية في فهم وضعية اسرائيل في علاقتها بالفلسطينيين وكذلك في النظر إلى تطوّر اسرائيل من الصهيونية العلمانية إلى الصهيونية الدينية، غير أنّ نص دوبريه وردود برنافي يبرز حدود هذا الاتفاق في أحيان كثيرة.
يبدأ دوبريه رسالته بالدعوة إلى الشجاعة في التطرّق للشان الإسرائيلي واستنكار لادّعاءات الإسرائيلية بخبث النوايا الكامنة وراء أيّ اهتمام يبديه كاتب أوروبي بقضايا الصهيونية وسياسة الدولة العبرية، ويجد في الدعاية الإعلامية الإسرائيلية نفسها ما يبرّر التطرّق لكلّ هذه المسائل بعين ناقدة : ألم تدّعِ "تسيبي ليفني" أنّ الهجوم على غزة وكلّ عملية الرصاص المصبوب إنّما هي "جزء من الصراع بين قيم الحداثة والإنسانية الغربية وبين الهمجية والكراهية"؟ ذلك مبرّر كاف إذا، فليس من السهل إقحام الأوروبيين في هذا الموضوع عندما تريد الدعاية الإسرائيلية ثمّ اخراجهم منه بكلّ البساطة الممكنة عندما يخدم ذلك رغبة في الاستفراد بمنطقة كاملة وبشعب أعزل. في السياق ذاته يستنكر دوبريه الصورة التي تنشرها الدعاية الصهيونية عن انتشار اللاسامية في فرنسا، فقط لمجرّد أنّه توجد بها جالية مسلمة كبيرة نسبيا. في نظر دوبيريه، ليس من جالية مدلّلة في فرنسا بقدر الجالية اليهودية، وليس من جالية مستهدفة بالقوانين والإجراءات التمييزية أكثر من الجالية المسلمة. يكفي للتأكّد من ذلك مراقبة المناسبات الدينية للجاليتين وملاحظة من يحضر من الرسميين الفرنسيين فيها. حتما إنّ تصوير الأمر بطريقة عكسية للواقع لا يمكن إلا أن يخفي رغبة في الضغط المستمرّ على الساحة الفكرية والسياسية الفرنسية، وهو أمر لا يمكن تصنيفه إلا في خانة الدعاية الوقائية التي لا تستفيد منها إلا السياسة الإسرائيلية، تلك السياسة غير الوفيّة حتى لمنطلقات الصهيونية. من زاوية تاريخية صرفة، استغلّت الصهيونية انتشار اللاسامية في أوروبا كقوّة دافعة لتكتيل اليهود حول الفكرة الصهيونية، كمحرّك للتاريخ اليهودي، وهو أمر أطنب في توضيحه تيودور هرتزل وحاييم وايزمان، الأبوان المؤسّسان للصهيونية ومشروع الدولة الإسرائيلية. ما تستخدم الصهيونية من أجله اللاسامية اليوم أمر مختلف تماما، فيه الكثير من الانتهازية السياسية حتى تجاه الدول الصديقة تقليديا لاسرائيل، وفرنسا إحداها. يعدّد دوبريه بعض أوجه الإهانات التي تتعرّض إليها الديبلوماسية الفرنسية في الخارج من قبل السياسة الإسرائيلية، في المناسبات الدولية وعلى معابر القطاع والضفة، ويقرأ الأمر ليس فقط في العلاقة بموقف ديغول من حرب 1967 ولكن أيضا بالاصطفاف الإسرائيلي، في الصراع الإستراتيجي الدولي بين أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب هذه الأخيرة. في الأثناء لا يدّخر المؤلف اللوم للديبلوماسية الفرنسية لعدم ردّها تجاه تلك الإهانات : "يجب أن تكون تركيا حتى تجرؤ وتطلب اعتذارا ثم تحصل عليه، أما الفرنسي فإنه يناول خدّه الأيسر"!
تمثل مسألة خيانة اسرائيل للصهيونية الخيط الرئيسيّ لرسالة ريجيس دوبريه، وهو خيط يفترض أنّ إيلي برنافي بوصفه "اسرائيليا منفتحا"، ناشطا من دعاة "السلام"، يتبنّاه. تقوم الفكرة الرئيسية على اعتبار دوبريه أنّ الصهيونية بوصفها مشروعا لتحقيق الإنقاذ القومي لليهود بدأت في الترنّح منذ تأسيس دولة اسرائيل وبخاصة منذ تحوّلها إلى غطرسة لا محدودة تجاه سكان فلسطين العرب والمسيحيين. هذا أمر قابل كثيرا للنقاش. ذلك أنّ الصهيونية لم تكن فقط مثلا قوميا يهوديا ونظرية سياسية لجمع الشتات اليهودي المعذّب في أوروبا جراء الإجراءات اللاسامية. في جوهرها تمثّل الصهيونية نظرية عنصرية تموقع نفسها بالتمايز عن بقية القوميات وتعيش على خليط غريب من المكوّنات العرقية والدينية والقومية المنصهرة في بوتقة واحدة. كانت هناك في ظروف الشتات حاجة لهذا الخلط من أجل أن تتحوّل اليهودية إلى الصهيونية، وفي خضمّ ذلك تمّ إضعاف التيّارات اليهودية الإندماجية كما شنّت حرب شعواء على الأرثوذكسية اليهودية المناهضة للصهيونية التي لا تزال بعض مظاهرها تعيش اليوم في شكل حركات متدينين عاجزة عن نشر تعاليمها في أوساط اليهود أنفسهم. من هذا المنطلق فإنه عندما لا يستطيع دوبريه فهم تحوّل مضطهدي ومعتقلي المحتشدات النازية إلى مضطهدين لغيرهم من العرب في فلسطين اليوم، فإنه يقرّ بطريقة ضمنية أنّ في الأمر خيانة للصهيونية، وهي فكرة خلافية جدا.
لا يقوى دوبريه على التحرّر من تراثه الاشتراكي أيضا عندما يرى في الكيبوتز kibboutz التأسيسي رمزا لمشروع مجتمع عادل سرعان ما تهاوى تحت تأثير جملة من العوامل الخاصة بتطوّر المجتمع الصهيوني. ما يغفل عنه دوبريه في هذا السياق أنه في مثال الكيبوتز بالذات، وبغضّ النظر عن المسار الذي أدّى لإفرازه، فإنّ تأسيسه قد تمّ على حساب الأراضي العربية (التي لم تشتر كلها) وكذلك على حساب اليد العاملة العربية التي أطردت ومعها آلاف أسرها تحت نيران حراس المستعمرات والكيبوتزات، أولئك أنفسهم الذين سيكونون لاحقا تنظيمات شتيرن والهاغاناه المسؤولة عن المذابح في حقّ سكان القرى العربية. من الثابت أنّ الكيبوتز تأسّس للتحرّر من دورة الإقتصاد النقدي الرأسمالي والإنعتاق من النظرة الربحية التي حكمت الاستثمارات الصهيونية الأولى في فلسطين، والتي كان البارون دي روتشيلد أول من أطلقها على نطاق واسع. كان يفترض في الكيبوتز أن يجمع أعضاء عاملين في شكل تعاضدي يقوم على التبادل بالمقايضة، وفي غنى كامل عن منطق المردودية الرأسمالية التي عطّلت بناء المجتمع اليهودي المستقلّ بذاته اقتصاديا على أرض فلسطين. وفي الحقيقة فقد كان الإشتراكيون اليهود الصهيونيون القادمون من شرق أوروبا هم من أبدع هذا الحلّ في مواجهة مشاريع الاستثمار الرأسمالي المتعثّرة. من منطلق اشتراكيّ صرف شكّلت عملية تأسيس الكيبوتز الولادة الحقيقية للمجتمع الصهيوني في فلسطين، غير أنّه من جهة أخرى فإنّ ذلك التأسيس تزامن، كشرط لازم، مع عملية طرد واسعة لليد العاملة العربية تحت شعار "افتكاك العمل"، ذلك الشعار الذي جاء به بن غوريون، المهاجر الشابّ من بولندا الذي قاد عملية إرهاب حقيقيّ ضدّ مديري المستعمرات الأولى لدفعهم للتخلّي عن اليد العاملة العربية.
من جانب اشتراكي بحت أيضا ينبغي التأكيد على ثورية الأفكار التي قدم بها الاشتراكيون الصهيونيون المهاجرون إلى فلسطين في تحقيق مشروع الدولة القومية، ولكن بالاحتفاظ بالخلط بين كل ماهو عرقيّ ودينيّ وقوميّ. يظهر ذلك بالخصوص في قرار الاشتراكيين اليهود اعتماد مبدأ الصراع الطبقيّ داخل البوتقة القومية اليهودية ورفض المبدأ الذي يجعل من العمال الفلسطينيين حلفاء طبقيين في الصراع ضدّ رأس المال. من الضروري التأكيد على أنه في مرحلة ما من الصراع القومي يحصل افتراق بين الفكرة الطبقية والفكرة الوطنية، وهو أمر حصل في كل حركات التحرر في العالم، غير أن الفارق مع المثال المدروس هو أن الصهيونية لم تكن حركة تحررية في فلسطين وإنما حركة استعمارية على أرضية عنصرية.
ما يقلق ريجيس دوبريه هو تضاؤل الحضور العلماني في السياسة الإسرائيلية، وتغلّب المتدينين الذين يسوقون الصهيونية نحو مصير صداميّ محتوم لا تبشّر ملامح مستقبله بأيّ خير بالنسبة لإسرائيل. غير أنّ الأمر ليس بمثل هذه البساطة تاريخيا. فاليهود المتديّنون ليسوا حادثا طارئا على الصهيونية، وإنما شكّلوا باستمرار قوّة المشروع الصهيوني الدافعة. من زاوية نظر تاريخية بحتة ظلت الصهيونية العلمانية عاجزة عن التقدّم إلى حين التحاق المتديّنين بالركب، وقبول العلمانيين إعطاء مضمون توراتيّ للحركة التي كانت قد بدأت في الاكتمال. لم يكن مؤتمر بال لينعقد لولا ذلك الاتّفاق المبدئي والإستراتيجي بين العلمانيين والمتدينين. ولعلّه من المهمّ أن نشير إلى أنّ هؤلاء المتدينين الممثّلين خاصة في منظمة "عشّاق صهيون" قد جاؤوا في معظمهم من أوروبا الشرقية، وخصوصا من روسيا وبولونيا، حاملين معهم أيضا إرثا فكريا اشتراكيا واضحا.
كما يقلق ريجيس دوبريه صمّ الإسرائيليين آذانهم عن كلّ النقد الذي يوجّه لسياستهم تجاه الفلسطينيين والعرب حتى من قبل حلفائهم الطبيعيين، أوروبا والأمريكيين. ينتقد دوبريه الفكرة التي عبّر عنها إيلي برنافي في كتابه الأخير والتي يعتبر فيها الولايات المتحدة الطرف الوحيد القادر على فرض السلام على الجميع في المنطقة، ويقوم انتقاده لا على توضيح الفروقات بين فهم كلّ طرف للسلام المدعى، وإنما على أساس أن الولايات المتحدة، حتى تحت حكم أوباما، لا يمكن أن تكون طرفا محايدا في الصراع، وأنّ الطرف المحايد الحقيقيّ هو أوروبا. يعلم الإسرائيليون ذلك طبعا، وما ميلهم لتحكيم الأمريكيين إلا دليل على الثقة في عدم حيادهم. في الأثناء يضيع الجميع "فرصة السلام".

أما ردّ إيلي برنافي فقد اعتمد على تبنٍّ واضح للمنطلقات التي صيغت على أساسها رسالة دوبريه، وهي التخوّف من سيطرة المتديّنين وتراجع العلمانيين، وكذلك تآكل الايديولوجيا الصهيونية من الداخل في وقت تتضاعف فيه أخطار جسام على اسرائيل، ليس أقلّها شأنا خطر السلاح النووي الإيراني المحتمل، تلك الدعاية الفجّة التي لا يدّخر دوبريه نقده اللاذع لها. فيما عدا ذلك فإنّ إيلي برنافي يتلافى المسائل الخلافية ويفلت من طرح الإشكالات الرئيسية التي يضعها "تحدّي السلام مع الفلسطينيين" على طاولة التداول. يقدم برنافي نفسه "كصهيونيّ متعاطف مع الفلسطينيين"، وهي تسمية تؤكّد الخلط المتعمّد بين الانتماء القومي لكيان سياسي اسمه اسرائيل، ولايديولوجيا عنصرية تقوم على جملة من الضوابط الدينية والعرقية.
إن فضل كتاب مثل "رسالة إلى صديق اسرائيلي" لا يتمثّل في تبنّي صاحبه، الأكاديمي المعروف على الصعيد الدولي بفتوحاته العلمية في مجال الدراسات الدينية والمناضل من أجل حقّ الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، لأفكار العدالة الإنسانية وإدانة الغطرسة الإسرائيلية المدججة بالدعاية والتحالفات، بل في اعتباره دليلا على الجرأة التي بدأت تدفع بعدد من المثقفين الغربيين والفرنسيين بالخصوص إلى الإصداع علنا بانتقادات كان يهمس بها همسا في آذان الأصدقاء الإسرائيليين. هي من هذه الزاوية تعبير صارخ عن الضيق من الممارسات العنصرية والدموية للسياسة الإسرائيلية خاصة أثناء الهجوم على غزة، وهي أيضا وخاصة تعبير عن الرغبة في التحرر من كلّ السيوف المسلطة على المثقفين الفرنسيين (من عنصرية و"لاسامية" و"انكار للمحرقة") كلما اقتربوا في كتاباتهم من موضوع اسرائيل والصهيونية، وتنسيب لفكرة تحرر السياسة الفرنسية من الضغوط اليهودية المساندة لاسرائيل وإدانة للدلال المبالغ فيه للجالية اليهودية في فرنسا. غير أن مطالع الكتاب، إذا ما أراد تلخيصه في جملة واحدة، برغم عبثية ذلك، فإنها ستكون الجملة التالية: "صديقي إيلي، كنت أتمنّى أن نراكم تتصرّفون بطريقة أقلّ ضجيجا ودموية". لا يمكن مطالبة مثقف غربي بتبنّي قراءة تناقض رؤيته الفلسفية والإيديولوجية تتداخل فيها عوامل عديدة وشديدة التعقيد، غير أن قارئ ريجيس دوبريه يفترض أن ينتظر أكثر، خاصة إذا ما شعر القارئ، في ثنايا الكتاب، بأنّ المؤلف رغم الحدّة التي اصطبغت بها بعض انتقاداته، إلا أنها تبقى بالأساس حدّة موجّهة لسياسات لا يرى دوبريه أنّها تمثل وفاء لقيم الصهيونية. المشكل هنا بالذات، فليس أوفى للصهيونية من سياسات إسرائيل اليوم !
نشر بموقع الأوان
5أوت 2010