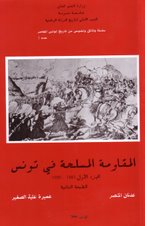من "الشخصية التونسية" إلى "الهوية التونسية"، إلى "الأمة التونسية": محمد مزالي والبشير بن سلامة
اكتفى بورقيبة في هذا المجال بوضع المبادئ العامة للثقافة الجديدة المراد ترسيخها لدى الأجيال الشابة والتي سيعتبر أنها ضمانة لاستمرار مشروع الدولة الوطنية في المستقبل، في حين قامت أطراف أخرى، جمع بينها وحدة التكوين وانسجام الرؤى والحماس الفياض للمشروع البورقيبي، بصياغة هذه الثقافة الجديدة وإعطاء إيديولوجيا الدولة الوطنية بعدا أعمق عن طريق تأصيلها في الثقافة الوطنية من جهة، وعن طريق إعادة صياغة هذه الثقافة الوطنية لتصبح متماشية مع البرامج السياسية بعيدة المدى للنخبة الوطنية. ويؤكد ذلك في الحقيقة حركية هذه النخبة المثقفة الجديدة وبراغماتيتها في الوقت نفسه. فإضافة إلى اقتناعها الكامل بالمشروع الذي شرع في تطبيقه منذ استقلال البلاد، كانت هذه النخبة، التي نشأت في الصادقية وعايشت أهم مفاصل مسيرة التحرر الوطني واطلعت بحكم دراساتها العليا على ما كان يعتمل داخل الثقافة الأوروبية عموما والفرنسية منها بالخصوص غداة الحرب، صاحبة مشروع جنيني عبرت عنه منذ الأعداد الأولى من الفكر، وهو مشروع "التونسة" أو صيرورة "تأصيل الكيان" الوطني. وهكذا أصبحت مجموعة الفكر، وبصفة خاصة قطباها محمد مزالي والبشير بن سلامة، المجموعة التي سيعهد إليها بصياغة الثقافة الجديدة.
لقد كان الأمر يتعلق بإنشاء أجيال جديدة تؤمن بالعقيدة الوطنية مما جعل للمدرسة وللنظام التربوي الدور الأساسي في هذه الصيرورة وهو ما عبر عنه أحد أكبر المتحمسين لفكرة "التونسة" وهو محمد مزالي عندما كتب أن هذه الأخيرة "تقتضي أن يهدف الهيكل الجديد لنظامنا التربوي إلى تجسيم كل مقومات الأمة وغرس العقيدة الوطنية في نفس الشباب بحيث يؤمنون بأنهم ينتمون إلى وطن له خصائصه الحضارية وله تاريخه وأمانيه فيعتزون بالانتساب إليه ويندمجون فيه ويستعذبون البذل والتضحية من أجل نصرته ومناعته وهذا لن يكون ما لم يتم الاتفاق بين أهل الحل والعقد ورجال الفكر على محتوى هذه التونسة، وما لم يتيسر ضبط مقومات الأمة التونسية ومعرفة خصائصها، وما لم يشيد سلم القيم الروحية والأخلاقية الذي به يكيف الشباب أعمالهم ومنه يستوحون سلوكهم واتجاهاتهم".
لقد عني "بالتونسة" التأكيد على محتوى العقيدة الجمعية الجديدة المراد ترسيخها لدى التونسيين، وهو ما سيسمى في مرحلة موالية "بالشخصية التونسية" قبل أن تتحول إلى "الهوية التونسية" ثم إلى "الأمة التونسية". ويتنزل هذا المجهود النظري الذي اضطلعت به النخبة المثقفة الجديدة في إطار ما أسماه محمد مزالي "إعطاء الوحدة القومية مضمونا عقائديا وفلسفيا" والتعمق في استجلاء هذه الخصائص ثم تركيزها في كل البرامج التربوية والثقافية واعتمادها في سياسة تكوين الشباب وتوجيهه، واستيحائها عند ضبط وسائل الإعلام وطرائق التوجيه.والوحدة القومية تقتضي من التونسيين، في نظر محمد مزالي، "الإيمان بأننا أمة قبل كل شيء، ومعرفة مقوماتنا ثم العمل على تغذية هذه المقومات وجعل الأجيال الصاعدة تتعرف إليها وتتغذى منها وتعتز بها ثم تعمل بدورها على إشاعتها وتنميتها وتبليغ الأمانة إلى الأجيال التي تأتي بعدها". من هذا المنطلق يفند محمد مزالي الادعاء بمرحلية الوحدة القومية، كونها مجرد موقف ظرفي ينحصر في "وحدة الصف" في مرحلة الكفاح من أجل التحرر، بل يعطيها مضمونا حضاريا وثقافيا يعتمد على شعور التونسيين أنهم يكونون أمة "لها خصائصها ولها حاضرها ولها مستقبلها وتقتضي إيمانا بوجوب الحفاظ على جملة المقومات القارة التي تجمع بينها وصونها من التلاشي والضياع".
إن أهمية اجتهادات كل من محمد مزالي وبصفة خاصة البشير بن سلامة تكمن في تناولها مسألة ذات صبغة إشكالية واضحة، فقد حاول كل منهما تأكيد مقولة "نحن أمة" التي قامت عليها فلسفة التحرر الوطني، مؤكدين على وجود جملة من الخصائص تجعل من التونسيين أمة بالفعل. وهنا يقعان بفعل تأكيدهما على أن الدولة لا تعدو كونها خاصية من خصائص الأمة أو أحد انتاجاتها في أفضل الحالات، للوهلة الأولى، في تعارض واضح مع نظرية بورقيبة والقائمة على فكرة انعدام شيء اسمه الأمة التونسية وأن إيجادها هي مهمة الدولة الوطنية ومبرر وجودها. غير أنه من الضروري الإشارة إلى أن الاختلاف بين الموقفين ليس أمرا خاصا بالساحة التونسية . نجد النخبة المثقفة التي ينتمي إليها مزالي وبن سلامة أكثر إلحاحا على عملية التراكم التاريخي التي جعلت التونسيين أمة تسعى لتحقيق تحررها وبناء كيانها السياسي المتمثل في الدولة الوطنية.
يؤكد محمد مزالي أن "لهذه البلاد تاريخا وتاريخا مجيدا، وأن شعبنا ظل صامدا حيا رغم تعاقب الغزاة وشراسة الطامعين، لم يذب قط في الغير بل هضم ما استساغته روحه الحضارية وأخذ عن الأقوام ما تصادى مع أخص خصائص عبقريتهن وتصدى للغاصبين فردهم على أعقابهم وكثيرا ما لعب دورا إيجابيا فأخذ وأعطى واستوحى وأوحى.." وقد أدت تجربة التونسيين في العيش مع بعضهم وتوالي المحن والغزاة إلى تبلور تلك "الإرادة المشتركة في الحياة الجماعية، وهي الإرادة التي تتكون بها الأمم". وقد لاحظ مزالي من خلال استقرائه لتاريخ الشعب التونسي أن هناك خصائص كبرى تجمع بين أفراده وتجعلهم يكونون أمة بالمعنى الكامل وهذه الخصائص لخصها في ما أسماه بالقاعدة الروحية ذات المنبع الشرقي، وجدلية العلاقة مع حضارات وشعوب البحر المتوسط التي تجسمت عبر القرون تارة في الاحتكاك السلمي وطورا في التصادم الحربي "مما أورث فينا النظرة الواقعية". من هنا استنتج مزالي أن تونس "ليست مجرد فرع من أصل، إنها وطن متميز، له كيانه المعروف وحيزه الجغرافي المضبوط وإن دينها الإسلام معتقدا وحضارة وتراثا، سلوكا ونظام حياة ونظرة إلى الوجود، وإن لغتها العربية... الركن الركين للشخصية الوطنية والعنصر المتين للذاتية القومية".
ورغم أن ملامح وصفات هذا الانتماء الحضاري تبدو أمرا بديهيا إلا أن طبيعة السجال الإيديولوجي والسياسي الذي عرفته تونس بين دعاة التشريق ودعاة التغريب قد جعلت مهمة منظري الذاتية التونسية صعبة نوعا ما. وإذا ما كان من اليسير نسبيا على هؤلاء مجابهة دعاة التغريب فإن مواجهة الخصوم الآخرين لم يكن بمثل ذلك اليسر، من هنا فإن التمسك بالثقافة العربية وبالدين الإسلامي كمكونين أساسيين في تلك الشخصية التونسية كان يرمي أولا إلى رد تهم الفئات التقليدية والأطراف القومية -التي شكلت هذه الفترة وخاصة قبل هزيمة جوان 1967 عهدها الذهبي- بسعي الدولة الوطنية في تونس إلى الخروج عن دائرة الانتماء الحضاري العربي الإسلامي. لذلك نجد محمد مزالي يواصل في ذات السياق التأكيد على أن "الأمة التونسية عربية إسلامية منذ الفتح الإسلامي، تغلغلت فيها الروح الدينية وصهرت شعبها وطبعته بطابعها حتى أصبح الدين الإسلامي من أخص خصائصها وأمتن مقوماتها، لا يمكن أن تتنكر له أو تزور عنه دون أن تفقد ذاتها وتمسخ شخصيتها". غير أن الاعتزاز بهذا الانتماء لا يجب أن يخفي في نظر النخبة التونسية المثقفة طبيعة المعركة التي أصبح على الأمة خوضها، وهي معركة التحرر الاقتصادي والاجتماعي، وسعيها إلى "تجديد مفاهيم الحرية والعدالة والسعادة بما ينسجم ومثلها العليا في الحياة وما يمليه عليها ضميره الحي". من هذا المنطلق فإن الدين الإسلامي الذي "وقى الأمة في الماضي شر التشتت ودرأ عنها خطر الاندماج رغم السياسة الاستعمارية ومكائدها وزود مجاهديها بالطاقة على الكفاح والإيمان بالنصر، يمكن، بل يجب، أن يكون محركا للعزائم وحافزا على العمل، والقوة على العمل، والثقة "بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم".
ويؤكد البشير بن سلامة على نفس المبدأ في التعامل مع الانتماء العربي الإسلامي لما يسميه الأمة التونسية وإن كان أكثر إسهابا. فهو يرى أن تأكيده على وجود ما أسماه الشخصية التونسية هو تأكيد لوجود أمة تونسية دون أن يعني ذلك مطلقا أي استنقاص من أهمية انتساب هذه الأمة إلى الأمة العربية اعتقادا منه " أنه لا تزدهر هذه الأمة الكبيرة التي ننادي بإقامتها والتي أصبحت الأمل الذي يجب أن يتحقق إلا بقيام الأمم العربية أي أن تصبح هذه الشعوب المتأرجحة في ثنائية يائسة أمما بأتم معنى الكلمة تنصهر في نهر الأمة العربية الكبير وإلا فإنها ستبقى أجزاء مبعثرة يوحدها الأمل ويفرقها الواقع".
انطلاقا من هنا سعى البشير بن سلامة لإثبات فرضية وجود "الأمة التونسية" فلاحظ أن علماء الاجتماع والفلاسفة قد اتفقوا على أنه "لا يمكن لشعب يصبح أمة إلا إذا أظهر بصفة مستمرة حية، إرادة جماعية للعيش عيشة مشتركة وإذا عرف كيف يكون لنفسه الهياكل اللازمة لوجوده كأمة قائمة الذات وكذلك إذا هو أمكن له أن تكون له نوع من الثقافة ونوع من القدرة على أن يحكم نفسه بنفسه ويدير شؤونه".
والبشير بن سلامة هنا لا يخرج عن الإطار الذي تشكلت فيه الرؤية النظرية للحركة الوطنية التونسية بوصفها عملية إحياء للثقافة وللأمة وبكونها رفضا للذوبان في الثقافة الفرنسية الغازية وبرهانا على استمرارية الكيان الوطني. فنجد أن على البلهوان، وهو أول الوطنيين الذين تناولوا هذه الإشكالية بكثير من الاهتمام، نجده ينتصر للفكرة التي تجعل من الدولة مجرد مظهر من مظاهر الأمة، ذلك أن الأنظمة تتغير وتزول وتتوالى العائلات الحاكمة ويندثر بعضها "غير أن الحكم السياسي للأمة لا ينمحي بسبب تلك التغييرات بل يبقى مستمرا دائما" .ولا يعني ذلك أي استنقاص من أولوية دور الدولة في فكر البشير بن سلامة، بل إنه على العكس من ذلك تماما يجعلها تتويجا لمسيرة دامت قرونا وقرونا وينيط بها مهمة تحويل بعض الخصائص الحضارية السلبية إلى خصائص أخرى ايجابية.
مقتطف من كتاب "دولة بورقيبة، فصول في الإيديولوجيا والممارسة"، عدنان المنصر، 2007.