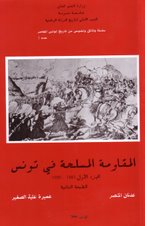samedi 5 mai 2007
jeudi 3 mai 2007
تصور البورقيبية لمسألة الأمة وقضية الهوية
تصور البورقيبية لمسألة الأمة وقضية الهوية
عدنان المنصر
مداخلة في ندوة بورقيبة والإسلام التي نظمها منتدى الجاحظ بالإشتراك مع دار الجنوب للنشر يوم السبت 29 جانفي 2005 في فضاء التياترو بتونس.
رابط الندوة:
http://www.eljahedh.org/Documents/borgibr1%20%20%20_s%20%20_.htm
عدنان المنصر
مداخلة في ندوة بورقيبة والإسلام التي نظمها منتدى الجاحظ بالإشتراك مع دار الجنوب للنشر يوم السبت 29 جانفي 2005 في فضاء التياترو بتونس.
رابط الندوة:
http://www.eljahedh.org/Documents/borgibr1%20%20%20_s%20%20_.htm
لم أدرس تصور بورقيبة فقط بل البورقيبية باعتبارها لم تكن نتاج بورقيبة فقط بل ساهمت فيها النخبة التي أحاطت به في الحكم سواء كانت مثقفة أو نخبة حاكمة فعندما نقول نخبة وطنية مثقفة نقصد النخبة التي تبنت البورقيبية وطورتها وأعطتها الكثير من الزخم للفكر البورقيبي.
وقد استغرقت قضية العلاقة بين الدولة والأمة جانبا كبيرا من الجهد التنظيري لهذه النخبة غداة الاستقلال بالخصوص وإن بدأ التفكير حول هذه المسائل خاصة منذ ظهور أول الفضاءات الفكرية من سنة 1954 تقريبا عبر مجلة الندوة التي تلتها مجلة الفكر وهذه النخبة بقيادة بورقيبة ستنيط بالدولة ليس مهمة إنشاء مؤسسات الدولة فقط أو عقلنة التصرف الإداري وإنما خاصة إنشاء نموذج جديد من الأمة عن طريق مجهود سياسي وثقافي وتعليمي وقانوني متناسق يسند ويبرر الواقع السياسي الجديد المتسم بسيادة الدولة القطرية، ويشكل سدا منيعا في وجه الخيارات العروبية أو الإسلامية التي كان يعتبرها بورقيبة أكبر تهديد لنموذج الدولة الحديثة.
من هنا يأتي الدور الكبير الذي أسند للمدرسة وللنظام التربوي في صيرورة إنشاء أجيال جديدة تؤمن بهذه العقيدة الوطنية الجديدة وبالفعل فدستور سنة 1959 ضبط هذه الخطوط العامة لهذه الأمة التونسية فجعل حدودها سياسية وليست ثقافية.
ويمكن القول عموما إن تصور بورقيبة للأمة ينطلق من نظرية الدولة لديه ويمكن تلخيص المبادئ العامة
لهذا التصور في ثلاث نقاط رئيسية:
النقطة الأولى:
إيديولوجيا الدولة الوطنية تعتبر الدولة أداة التغيير الرئيسية إن لم تكن الوحيدة في المجتمع وشيئا فشيئا سيتطور الأمر إلى قلب العلاقة النظرية القديمة التي تعتبر الدولة نتاجا للمجتمع الذي يصبح بدوره نتاجا لها.
النقطة الثانية :
مجهود الدولة الوطنية كان يرمي إلى خلق" أمة متجانسة وموّحدة " فكان منطقيا أن تكون النتيجة القضاء على كل هيكل تقليدي وسيط بين الدولة والفرد أو بصيغة أخرى القضاء على كل عصبية منافية للعصبية الجديدة التي أرادت الدولة إنشاءها وهي العصبية للدولة أو العصبية للدولة الأم ، فضرورات البناء الوطني كما تتصورها النخبة الوطنية كان يتضمن تحييد كل الهياكل المستقلة ذلك أن الأمة يجب أن تبنى في نظر بورقيبة من الأفراد لأن الفرد الذي لا يكون مواليا لأية مؤسسة أو عصبية من السهل على الدولة أن تقحمه في مشروعها الحضاري الجديد وهو إنشاء الأمة.
النقطة الثالثة:
لا يتصور بورقيبة إنشاء الدولة إلا على أساس قومي أي وطني. فالأمة هي التي يجب أن تسند قيام الدولة، ولكن في نظره هذه الأمة غير موجودة و من هنا يأتي الدور الطلائعي للحزب كهيكل يضم نخبة الشعب عن طريق مزج عناصره المشتتة في وحدة منسجمة. فبورقيبة كان يعتبر دائما الحزب طليعة الأمة أي أمة مصغرة تتجاوز مهمتها المراحل الآنية لتبلغ هدفا أرقى وهو خلق أمة حقيقية منسجمة وموحّدة تقضي على التنافر بين الأفراد.
هذه هي النقاط الرئيسية التي ينطلق منها تصور بورقيبة للدولة والأمة وللهوية كتابع لتصوره للأمة.
إن قومية بورقيبة وطنية وقطرية بالأساس، وهي أيضا على ارتباط بمفهوم وهو مفهوم الأمة ونجد أنه في بعض الخطب لا يستنكف من الحديث عن أمة إسلامية أو أمة عربية خاصة في الخطب التي كانت تلقى بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان، لكن في أغلب الحالات الأمة التي كان يتحدث عنها بورقيبة هي الأمة التونسية، ويجد لذلك تبريرا وهو أن النخبة التونسية وضعت لنفسها بعد خروج المستعمر مهمة ذات أولوية وهي بناء الدولة الذي يتم بالموازاة مع بناء الأمة.
الأمة هنا لا تشكل معطى في الواقع وإنما هي حالة كامنة وفي أفضل الحالات مشروع في طور التحقيق فالمقياس الأساسي للأمة في نظر بورقيبة هو الدولة، ولا يمكن أن تتحقق بدونها وهو هنا يتبنى بشكل كامل تقريبا مفهوم الدولة القومية كما ظهر في أوروبا وخاصة في فرنسا يدفعه في ذلك تكوينه السياسي والفلسفي الليبرالي وعلى قناعة أساسية مفادها أن انحطاط الأمة العربية والإسلامية يعود أساسا إلى عدم استنادها إلى دولة حديثة ومركزية وفقا للنموذج الأوروبي ، وهذه الفكرة ستؤهله لتبني مواقفه المعروفة من الوحدة العربية وهو ما سيؤدي إلى ترسيخ معنى مختلف وأحيانا مناقض للوحدة القومية بمفهومها غير القطري أي الوحدة العربية أو الوحدة الإسلامية ..
فبورقيبة حين يتحدث عن القومية فهو يعني القومية التونسية أو الأمة التونسية وفي هذا السياق بالذات يبدو أن بورقيبة كان شديد الحرص على تدعيم الصفة القطرية للقومية التونسية أو الأمة التونسية مما كان يعني أيضا إعادة صياغة الهوية التونسية في قالب سياسي وقانوني قطري يحررها من احتكار البعد العربي والإسلامي كبعدين مؤسسين لها، وقد بدأ هذا المسار منذ الشروع في إعداد الدستور التونسي الصادر سنة 1959 فالأمة بالمعنى الوارد في هذا الدستور هي الأمة التي عبرت عن وجودها كشعب مناضل من أجل التحرر والاستقلال وهي الأمة التي تتشكل بعد الحصول على السيادة التامة بفعل الدولة التي تحدد أحكام الدستور كيانها وصورتها .
ويشير دستور سنة 1959 إلى الأمة العربية بتعبير الأسرة العربية ويحتفظ بتعبير الأمة للأمة التونسية وهذا الدستور لا يكتفي بتغيير معنى الأمة فقط وإنما حتى لفظ قومية يتغير معناه ، فتصبح القومية التونسية معوّضة للقومية العربية فنجد أن جميع مؤسسات الدولة الوطنية تستعمل لفظ قومية كمرادف للفظ وطنية مثل " الشركة القومية للسكك الحديدية التونسية " وغيرها.
والحقيقة أن بورقيبة قد اكتفى في هذا المجال بوضع المبادئ للثقافة الجديدة المراد ترسيخها لدى الأجيال الشابة والتي يعتبر أنها الضامنة لاستمرار مشروع الدولة الوطنية في المستقبل في حين قامت أطراف أخرى بصياغة هذه الثقافة الجديدة وإعطاء إيديولوجيا الدولة الوطنية بعدا أعمق. إذ كانت هذه النخبة- التي نشأت في الصادقية وعايشت أهم مفاصل مسيرة التحرر الوطني واطلعت بحكم دراساتها العليا على ما كان يعتمل داخل الثقافة الأوروبية عموما والفرنسية منها بالخصوص غداة الحرب العالمية الثانية - كانت صاحبة مشروع جنيني عبرت عنه منذ الأعداد الأولى من مجلة الندوة وخاصة مجلة الفكر وهو مشروع التونسة أو " صيرورة تأصيل الكيان الوطني " وعني بالتونسة التأكيد على محتوى العقيدة الجمعية الجديدة المراد ترسيخها لدى التونسيين وهو ما سيسمى في المرحلة الموالية بالشخصية التونسية قبل أن تتحول إلى الهوية التونسية ثم إلى الأمة التونسية.
من أهم من طور هذه النظرة للأمة وللقومية التونسية نجد رمزين هامين هما محمد مزالي والبشير بن سلامة خاصة في مجلة فكر.
فالسيد محمد مزالي لاحظ من خلال استقرائه لتاريخ الشعب التونسي أن هناك خصائص كبرى تجمع بين أفراد هذا الشعب وتجعله يكوّن أمّة بالمعنى الكامل وهذه الخصائص لخصها ما أسماه بالقاعدة الروحية ذات المنبع الشرقي وجدلية العلاقة بحضارات شعوب البحر المتوسط والتي تجسمت عبر القرون تارة عبر الاحتكاك السلمي وطورا في التصادم الحربي إذن هناك صبغة متوسطية للهوية التونسية من هنا استنتج أن تونس والشاهد له " ليست مجرد فرع من أصل بل إنها وطن متميز له كيانه المعروف وحيزه الجغرافي المضبوط وإن دينها الإسلام معتقدا وحضارة وتراثا وسلوكا ونمط حياة ونظرة إلى الوجود وإن لغتها العربية الركن الركين للشخصية الوطنية والعنصر المتين للذاتية القومية "
غير أن طبيعة السجال الإيديولوجي والسياسي الذي عرفته تونس بين دعاة التشريق ودعاة التغريب جعل مهمة منظري الذاتية التونسية صعبة نوعا ما فإذا كان من اليسير نسبيا على هؤلاء مجابهة دعاة التغريب فإن مواجهة الخصوم الآخرين لم يكن بذلك اليسر، من هنا فإن التمسك بالثقافة العربية وبالدين الإسلامي كمكونين أساسيين لتلك لشخصية التونسية كان يرمي إلى رد تهم الفئات القومية والأطراف التقليدية التي شكلت في هذه الفترة و خاصة قبل هزيمة جوان 1967 عهدها الذهبي وذلك بسعي الدولة الوطنية في تونس إلى الخروج عن دائرة الانتماء الحضاري العربي الإسلامي.
أما السيد البشير بن سلامة فيؤكد على نفس المبدأ في التعامل مع الانتماء العربي الإسلامي بما يسميه بالأمة التونسية فهو يرى أن تأكيده على ما أسماه الشخصية التونسية هو تأكيد لوجود أمة تونسية دون أن يعني ذلك مطلقا أي استنقاص من أهمية انتساب هذه الأمة إلى الأمة العربية فالعصر أضحى عصر وطنيات ، كما يقول ، والوطنية أصبحت العصبية الجديدة التي تقوم عليها الأمم . و انطلاقا من هنا سعى البشير بن سلامة إلى إثبات فرضية وجود الأمة التونسية باعتبار توفر الشروط الأساسية التي تتمثل في أربعة شروط.
* وجود إرادة جماعية للعيش عيشة مشتركة .
* القدرة على تكوين الهياكل اللازمة كأمة قائمة الذات .
* توفر نوع من الثقافة .
* قدرة الشعب على أن يحكم نفسه بنفسه.
وفي مؤلفه الهام "الشخصية التونسية خصائصها ومقوّماتها " - والذي لا يمكن دراسة هذه المسألة دون الرجوع إليه - يرى البشير بن سلامة أن توفر هذه الشروط لا يعفي من التعامل مع بعض الخصائص السلبية في الشخصية التونسية وخاصة الصراع الجدلي والمستمر بين ما أسماه روح المقاومة المستمرة وروح التعاون والمؤالفة فهو يرى أن الحضارات التي شهدتها البلاد لم تكن لتنشأ وتستمر لولا وجود روح التعاون والمؤالفة مما سهل على سكان البلاد التونسية هضم ثقافة الغزاة وجعلها جزءا من بنائهم الحضاري، غير أن روح التعاون والمؤالفة ستصطدم دائما بظاهرة أخرى وهي التخريب والتهديم وروح الفتنة والتناحر وتقويض البناء عندما يشيد وتظهر مزاياه ولا يمكن في نظره أيضا أن تشذ دولة الاستقلال في تونس عن هذه القاعدة الأزلية حيث ستجد نفسها وهي تسعى لترسيخ روح التعاون والمؤالفة وتكوين
" دولة قائمة الذات منيعة قادرة على إنشاء حضارة متميزة خلاقة آثارها باقية على مر الدهر " ستجد هذه الدولة نفسها في صراع مستمر ضد روح المقاومة والمناوءة التي لن تأخذ في العهد الجديد بعد الاستقلال لباس النعرات القبلية مثلما حدث في الماضي بل ستعود في شكل جديد " في صورة أخرى قاتلة مخرّبة " مثل الانقلاب العسكري أو التمرد أو المعارضة" المعارضة الهدامة" من هنا يتضح لنا بعد هام في نظرية الأمة التونسية في علاقاتها ببرامج الدولة الوطنية كما اتضحت لدى منظري هذا المفهوم الدولة الوطنية إنما تضع نفسها في مسار البناء والإنشاء و المدنيّة والحضارة في حين أن جميع الأخطار الداخلية التي تسعى لتقويض مجهودها لا يمكن أن تكون إلا من إحياءات روح التهديم والتخريب أي أن الدولة الوطنية والنخبة المشرفة على حظوظها في سعيهما لترسيخ روح التعاون والمؤالفة ستعتبر أن كل معارضة تهديد لذلك المسار من هنا فإن إزاحة هذه المعارضة المهددة للمشروع الحضاري للدولة الوطنية إنما هو إقصاء لغريزة المقاومة التي تصبح في هذا السياق تخريبا ووندلة.
وفي هذا السياق النظري بدأت بالبروز إيديولوجيا الأمة ثم بعد ذلك إيديولوجيا الوحدة القومية التي ستنقل الأمة شيئا فشيئا إلى أن تصبح إحدى مكونات الدولة الوطنية.
وهكذا مرت الايديولوجيا الوطنية من ايديولوجيا تريد إثبات وجود أمة تونسية إلى ايديولوجيا تسعى إلى تكتيك مشروع حول الدولة الوطنية ونخبتها الحاكمة فتحولت تلك الايديولوجيا بالتدريج من تعبير محتمل عن مشروع حضاري إلى ايديولوجيا نظام حكم.
من هنا اتخذ هذا المفهوم، خاصة مفهوم الوحدة القومية، صبغته الاصطلاحية ومغزاه الايديولوجي بوصفه أصبح جزءا من سياق التبرير سياسة طرف معين أمسك بمقاليد الدولة الناشئة وأعلن أنه المؤتمن على مشروعها التحديثي . وبالفعل فإن الدولة الوطنية عملت - في إطار مجهود دعائي قوي سخرت له كلما كان متاحا لها أدوات التأثير وقنوات الاتصال وخاصة الإعلام والمدرسة - عملت على احتكار التحدث باسم الأمة وادعاء تمثيلها والدفاع عن وحدتها المهددة باستمرار.
mardi 1 mai 2007
المكتبة الرقمية الإنسانية وتنافس الثقافات
المكتبة الرقمية الإنسانية وتنافس الثقافات
عدنان المنصر
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 16 فيفري 2007 وبجريدة الحياة اللندنية تاريخ 18 2007
الرابط
http://213.253.55.207/science_tech/05-2007/Item-20070517-9afcd57d-c0a8-10ed-01b2-ede8b1a44126/story.html
تمثل الأنترنت اليوم إحدى أهم الأدوات في عالم البحث في مختلف ميادين المعرفة البشرية. وبسبب الانتشار السريع في نسق استخدامها على مستوى العالم فقد امتدت إلى ميادين أكثر فأكثر تنوعا، وأصبح نشر الكتب والفهارس على الشبكة من بين أكثر خدمات الأنترنت إقبالا. وكنتيجة لذلك ظهرت بصفة مبكرة مشاريع بناء مكتبات رقمية تتيح للمطالعين المتصلين بالأنترنت الحصول على عدد من المؤلفات غير المشمولة بحقوق النشر والتأليف، فكانت البداية في الولايات المتحدة منذ 1971 عن طريق مشروع بدأه أحد الشبان ويدعى مايكل هارت وأطلق عليه اسم قوتنبرق . وقد تطور ذلك المشروع منذ 35 سنة تطورا كبيرا إلى الحد الذي أصبح معه اليوم أضخم مشروع مكتبة رقمية غير تجارية في العالم. وقد سمح اتساع إمكانيات تخزين المعلومات لمايكل هارت ولحوالي الألف متطوع ضمن هذا المشروع من وضع آلاف العناوين على ذمة الباحثين والمطالعين بالمجان، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد العناوين المرقمنة في منتصف العشرية القادمة حوالي المائة ألف عنوان. ويلاقي مشروع قوتنبرغ اليوم نجاحا هائلا حيث يقدر عدد الكتب التي تتم استعارتها على الشبكة في شكل رقمي (تصفح أو تخزين) حوالي المليوني كتاب شهريا.
وسرعان ما انتشرت فكرة المكتبات الإلكترونية في العالم الغربي وبصفة خاصة في العالم الأنقلوسكسوني حيث قامت شبكات من أعرق المكتبات الجامعية الأمريكية بالتعاقد مع شركات إعلامية لرقمنة مخزونها المعرفي في مختلف المجالات، غير أن مشروع قوقل برنت يعتبر اليوم أكثرها طموحا وأضخمها تمويلا، حيث يتوقع القائمون عليه أن يضع على ذمة المتصلين بالشبكة حوالي 15 مليون عنوان، أي ما يعادل 4,5 مليار صفحة من المكتبة الأنقلوسكسونية.
وقد كان من النتائج المباشرة لمشروع قوقل برنت أنه نقل الصراع بين الأنقلوسكسونية والفرنكوفونية إلى ميدان رقمنة الكتب، حيث تعمل المكتبة الوطنية الفرنسية، عبر مشروعها قاليكا على رفع التحدي بتسريع عملية رقمنة رصيدها الهائل من المصادر والمراجع باللغة الفرنسية، مع تفاوت واضح في القدرة على ايجاد التمويلات الكافية. ورغم سعي الفرنسيين إلى إقحام الإتحاد الأوروبي في هذا المشروع تحت مسمى مواجهة التحدي الثقافي الأمريكي، إلا أن ذلك لا يلاقي فيما يبدو نجاحا كبيرا، بالنظر إلى أن الهم الفرنكوفوني ليس مشتركا بين معظم الدول الأعضاء.
إن للموضوع بعده المعرفي بالتأكيد، غير أن الجانب الربحي لا يقل عنه أهمية. فبغض النظر عن البعد الثقافي الكامن وراء انتقاء عناوين دون غيرها ولغات دون أخرى، فإن تحويل مشاريع المكتبات الرقمية إلى مشاريع مربحة تجاريا لأصحابها من شأنه أن يحدث ثورة عظيمة أخرى في هذا الميدان، لذلك تحظى مشكلة حقوق التأليف والنشر بأكبر جنب من اهتمام القائمين على هذه المشاريع.
إن قيمة المكتبات الرقمية التي تتيح لعموم المتصلين بشبكة الأنترنت تصفح أو تخزين ما يريدونه من عناوين، مجانا أو بمقابل، لا تضاهيها قيمة فيما يبدو سوى عملية اختراع الطباعة التي نقل قوتنبرغ بواسطتها المعرفة من نشاط تمارسه نخبة ضيقة إلى أوسع الأنشطة البشرية. وبالرغم من الصراع الكامن وراء عملية التنافس في بناء المكتبات الرقمية فإن النتيجة ستكون بالتأكيد في صالح البشرية كلها حيث سيؤدي تراكم هذه المشاريع إلى إنشاء ما يسمى بالمكتبة الرقمية الإنسانية التي ستحفظ إلى ما لا نهاية المعرفة الإنسانية من الضياع.
وفيما يبدو فإن هذه المكتبة الرقمية الإنسانية أنقلوسكسونية بالدرجة الأولى وفرنكوفونية بدرجة ثانية، في حين لا يكاد عدد العناوين العربية المرقمنة يذكر مقارنة بثراء المكتبة العربية، وهو أمر يمكن إرجاعه على المستوى التقني إلى ضآلة الجهد المبذول لرقمنة الكتب العربية. ففيما عدا بعض المشاريع الفردية التطوعية التي يكاد ينحصر معظمها في منطقة الخليج، ليس هناك شيء يذكر. بل إن المتصفح للمواقع الإلكترونية لدور الكتب في البلدان العربية يصاب بخيبة أمل كبيرة، ذلك أن هذه الدور تفشل إلى حد اليوم ، برغم الإمكانيات البشرية والتقنية التي تتوفر عليها، في وضع مجرد فهارس بعناوين مخزونها تتيح للباحثين الإطلاع عليها عن بعد. وعوضا عن ذلك تتحول تلك المواقع في الغالب إلى عمل دعائي منعدم المضمون. وانعكاسات ذلك كبيرة حيث يخسر الباحث، في مختلف ميادين البحث، وقته وماله وجهده، فيتأخر نفعه لغيره. والوضع ليس أحسن حالا بالنسبة للمكتبات الجامعية، وهي في الأصل مكتبات بحث.
هذا الوضع يفتح الجدل واسعا حول السياسات الثقافية في البلدان العربية، هذا إذا جاز لنا إطلاق تسمية "سياسات ثقافية" على ما يفعل بالثقافة في تلك البلدان. إن ضحالة المساهمة العربية في مشروع المكتبة الإنسانية الرقمية لا يعود لقلة الخبرات ولا إلى ضعف الإمكانيات، بل إلى انعدام إرادة سياسية تجعل من الهم الثقافي هما جديا لوزارات الثقافة العربية، فلو خصص لهذا المشروع جزء يسير من الميزانيات التي تنفق على "دعم الأغنية" أو جزء مما ينفق على حفلات الاستقبال الرسمية لكان الأمر كافيا. غير أن المسألة لا تقف عند تخلي المسئولين عن الثقافة في البلدان العربية عن مسؤولياتهم في نشر وتطوير اللغة الأم، ذلك أن الجامعات العربية هي الأخرى لا تقوم بأدنى المطلوب في هذا الشأن. لذلك فإن النتيجة تكاد تكون نفسها حيث ما وليت وجهك: تصحر ثقافي، انعزال متزايد عن حركة الفكر الإنساني، ضعف في المناعة الثقافية للجيل المتعلم وانتشار غير مسبوق للجهل والخرافة.
إن حلم اللحاق بالمجهود المبذول في الفضاءات الثقافية الغالبة اليوم لم يعد غير واقعي فحسب، بل إن المرء يتساءل عن إمكانية المحافظة على رتبتنا الحالية في سلم التخلف العلمي والثقافي والحفاظ على بعض ما تم تحقيقه في العقود الماضية. غير أن إلقاء التبعات على السياسات الرسمية لا يغطي إلا جزءا من المشكلة، ذلك أن الاستقالة من مسؤولية صيانة الثقافة العربية تكاد تصبح سلوكا عاما لدى جانب كبير من الشرائح التي يفترض أن تكون أكثر وعيا من غيرها بخطورة هذه المسألة. وهنا تطرح قضية مساهمة المجتمع الأهلي، أو المدني، في المحافظة على إحدى أهم أسس هويته الثقافية، واعتبار نفسه معنيا أكثر من الجهات الرسمية بهذا الموضوع. ذلك أن المشاريع الغربية في مجال المكتبات الرقمية بدأت كلها بشكل غير رسمي واستندت إلى العمل التطوعي، ولم تتطور إلى الشكل الذي أصبحت عليه اليوم إلا بفضل عملية تراكم طويلة الأمد.
غير أن تطور الاقتصاد الرقمي وانفتاحه على مجالات جديدة يمكن أن يحدث النقلة المطلوبة في مجال الكتاب الرقمي العربي حيث أصبح بإمكان المستثمرين الخاص ولوج عالم الثقافة الرقمية العربية باعتبار الأرباح التي يمكن جنيها من الإطلاع على المخزون الرقمي، حتى لو تعلق الأمر في البداية برقمنة الكتب التراثية المحررة من حقوق التأليف. ليجرب أحدهم ذلك وسيتأكد من الأرباح التي سيجنيها، وسيكون في النهاية قد حقق استثمارا جيدا وساهم (حتى من حيث لا يدري) في "مشروع صيانة الثقافة العربية".
عدنان المنصر
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 16 فيفري 2007 وبجريدة الحياة اللندنية تاريخ 18 2007
الرابط
http://213.253.55.207/science_tech/05-2007/Item-20070517-9afcd57d-c0a8-10ed-01b2-ede8b1a44126/story.html
تمثل الأنترنت اليوم إحدى أهم الأدوات في عالم البحث في مختلف ميادين المعرفة البشرية. وبسبب الانتشار السريع في نسق استخدامها على مستوى العالم فقد امتدت إلى ميادين أكثر فأكثر تنوعا، وأصبح نشر الكتب والفهارس على الشبكة من بين أكثر خدمات الأنترنت إقبالا. وكنتيجة لذلك ظهرت بصفة مبكرة مشاريع بناء مكتبات رقمية تتيح للمطالعين المتصلين بالأنترنت الحصول على عدد من المؤلفات غير المشمولة بحقوق النشر والتأليف، فكانت البداية في الولايات المتحدة منذ 1971 عن طريق مشروع بدأه أحد الشبان ويدعى مايكل هارت وأطلق عليه اسم قوتنبرق . وقد تطور ذلك المشروع منذ 35 سنة تطورا كبيرا إلى الحد الذي أصبح معه اليوم أضخم مشروع مكتبة رقمية غير تجارية في العالم. وقد سمح اتساع إمكانيات تخزين المعلومات لمايكل هارت ولحوالي الألف متطوع ضمن هذا المشروع من وضع آلاف العناوين على ذمة الباحثين والمطالعين بالمجان، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد العناوين المرقمنة في منتصف العشرية القادمة حوالي المائة ألف عنوان. ويلاقي مشروع قوتنبرغ اليوم نجاحا هائلا حيث يقدر عدد الكتب التي تتم استعارتها على الشبكة في شكل رقمي (تصفح أو تخزين) حوالي المليوني كتاب شهريا.
وسرعان ما انتشرت فكرة المكتبات الإلكترونية في العالم الغربي وبصفة خاصة في العالم الأنقلوسكسوني حيث قامت شبكات من أعرق المكتبات الجامعية الأمريكية بالتعاقد مع شركات إعلامية لرقمنة مخزونها المعرفي في مختلف المجالات، غير أن مشروع قوقل برنت يعتبر اليوم أكثرها طموحا وأضخمها تمويلا، حيث يتوقع القائمون عليه أن يضع على ذمة المتصلين بالشبكة حوالي 15 مليون عنوان، أي ما يعادل 4,5 مليار صفحة من المكتبة الأنقلوسكسونية.
وقد كان من النتائج المباشرة لمشروع قوقل برنت أنه نقل الصراع بين الأنقلوسكسونية والفرنكوفونية إلى ميدان رقمنة الكتب، حيث تعمل المكتبة الوطنية الفرنسية، عبر مشروعها قاليكا على رفع التحدي بتسريع عملية رقمنة رصيدها الهائل من المصادر والمراجع باللغة الفرنسية، مع تفاوت واضح في القدرة على ايجاد التمويلات الكافية. ورغم سعي الفرنسيين إلى إقحام الإتحاد الأوروبي في هذا المشروع تحت مسمى مواجهة التحدي الثقافي الأمريكي، إلا أن ذلك لا يلاقي فيما يبدو نجاحا كبيرا، بالنظر إلى أن الهم الفرنكوفوني ليس مشتركا بين معظم الدول الأعضاء.
إن للموضوع بعده المعرفي بالتأكيد، غير أن الجانب الربحي لا يقل عنه أهمية. فبغض النظر عن البعد الثقافي الكامن وراء انتقاء عناوين دون غيرها ولغات دون أخرى، فإن تحويل مشاريع المكتبات الرقمية إلى مشاريع مربحة تجاريا لأصحابها من شأنه أن يحدث ثورة عظيمة أخرى في هذا الميدان، لذلك تحظى مشكلة حقوق التأليف والنشر بأكبر جنب من اهتمام القائمين على هذه المشاريع.
إن قيمة المكتبات الرقمية التي تتيح لعموم المتصلين بشبكة الأنترنت تصفح أو تخزين ما يريدونه من عناوين، مجانا أو بمقابل، لا تضاهيها قيمة فيما يبدو سوى عملية اختراع الطباعة التي نقل قوتنبرغ بواسطتها المعرفة من نشاط تمارسه نخبة ضيقة إلى أوسع الأنشطة البشرية. وبالرغم من الصراع الكامن وراء عملية التنافس في بناء المكتبات الرقمية فإن النتيجة ستكون بالتأكيد في صالح البشرية كلها حيث سيؤدي تراكم هذه المشاريع إلى إنشاء ما يسمى بالمكتبة الرقمية الإنسانية التي ستحفظ إلى ما لا نهاية المعرفة الإنسانية من الضياع.
وفيما يبدو فإن هذه المكتبة الرقمية الإنسانية أنقلوسكسونية بالدرجة الأولى وفرنكوفونية بدرجة ثانية، في حين لا يكاد عدد العناوين العربية المرقمنة يذكر مقارنة بثراء المكتبة العربية، وهو أمر يمكن إرجاعه على المستوى التقني إلى ضآلة الجهد المبذول لرقمنة الكتب العربية. ففيما عدا بعض المشاريع الفردية التطوعية التي يكاد ينحصر معظمها في منطقة الخليج، ليس هناك شيء يذكر. بل إن المتصفح للمواقع الإلكترونية لدور الكتب في البلدان العربية يصاب بخيبة أمل كبيرة، ذلك أن هذه الدور تفشل إلى حد اليوم ، برغم الإمكانيات البشرية والتقنية التي تتوفر عليها، في وضع مجرد فهارس بعناوين مخزونها تتيح للباحثين الإطلاع عليها عن بعد. وعوضا عن ذلك تتحول تلك المواقع في الغالب إلى عمل دعائي منعدم المضمون. وانعكاسات ذلك كبيرة حيث يخسر الباحث، في مختلف ميادين البحث، وقته وماله وجهده، فيتأخر نفعه لغيره. والوضع ليس أحسن حالا بالنسبة للمكتبات الجامعية، وهي في الأصل مكتبات بحث.
هذا الوضع يفتح الجدل واسعا حول السياسات الثقافية في البلدان العربية، هذا إذا جاز لنا إطلاق تسمية "سياسات ثقافية" على ما يفعل بالثقافة في تلك البلدان. إن ضحالة المساهمة العربية في مشروع المكتبة الإنسانية الرقمية لا يعود لقلة الخبرات ولا إلى ضعف الإمكانيات، بل إلى انعدام إرادة سياسية تجعل من الهم الثقافي هما جديا لوزارات الثقافة العربية، فلو خصص لهذا المشروع جزء يسير من الميزانيات التي تنفق على "دعم الأغنية" أو جزء مما ينفق على حفلات الاستقبال الرسمية لكان الأمر كافيا. غير أن المسألة لا تقف عند تخلي المسئولين عن الثقافة في البلدان العربية عن مسؤولياتهم في نشر وتطوير اللغة الأم، ذلك أن الجامعات العربية هي الأخرى لا تقوم بأدنى المطلوب في هذا الشأن. لذلك فإن النتيجة تكاد تكون نفسها حيث ما وليت وجهك: تصحر ثقافي، انعزال متزايد عن حركة الفكر الإنساني، ضعف في المناعة الثقافية للجيل المتعلم وانتشار غير مسبوق للجهل والخرافة.
إن حلم اللحاق بالمجهود المبذول في الفضاءات الثقافية الغالبة اليوم لم يعد غير واقعي فحسب، بل إن المرء يتساءل عن إمكانية المحافظة على رتبتنا الحالية في سلم التخلف العلمي والثقافي والحفاظ على بعض ما تم تحقيقه في العقود الماضية. غير أن إلقاء التبعات على السياسات الرسمية لا يغطي إلا جزءا من المشكلة، ذلك أن الاستقالة من مسؤولية صيانة الثقافة العربية تكاد تصبح سلوكا عاما لدى جانب كبير من الشرائح التي يفترض أن تكون أكثر وعيا من غيرها بخطورة هذه المسألة. وهنا تطرح قضية مساهمة المجتمع الأهلي، أو المدني، في المحافظة على إحدى أهم أسس هويته الثقافية، واعتبار نفسه معنيا أكثر من الجهات الرسمية بهذا الموضوع. ذلك أن المشاريع الغربية في مجال المكتبات الرقمية بدأت كلها بشكل غير رسمي واستندت إلى العمل التطوعي، ولم تتطور إلى الشكل الذي أصبحت عليه اليوم إلا بفضل عملية تراكم طويلة الأمد.
غير أن تطور الاقتصاد الرقمي وانفتاحه على مجالات جديدة يمكن أن يحدث النقلة المطلوبة في مجال الكتاب الرقمي العربي حيث أصبح بإمكان المستثمرين الخاص ولوج عالم الثقافة الرقمية العربية باعتبار الأرباح التي يمكن جنيها من الإطلاع على المخزون الرقمي، حتى لو تعلق الأمر في البداية برقمنة الكتب التراثية المحررة من حقوق التأليف. ليجرب أحدهم ذلك وسيتأكد من الأرباح التي سيجنيها، وسيكون في النهاية قد حقق استثمارا جيدا وساهم (حتى من حيث لا يدري) في "مشروع صيانة الثقافة العربية".
ابن خلدون والبسكويت
ابن خلدون والبسكويت
عدنان المنصر
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 2 مارس 2007 و بصحيفة "الحياة اللندنية ليوم 12 مارس 2008
في المنطلق خبران: الجزيرة نقلا عن مصادر ثقافية مصرية تعلن افتتاح متحف حول الزعيم التونسي بورقيبة بالقرية الفرعونية المصرية وهو المتحف الثالث من نوعه المخصص لزعامة معاصرة بعد المتحفين المخصصين لكل من جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، والثاني أن ابن خلدون شوهد على شاشة إحدى قنواتنا التلفزية يلاحق أحد أنواع البسكويت في شوارع العاصمة في ومضة إشهارية تفتقت عليها عبقرية أحد مخرجي الإعلانات التلفزية الباحثين عن العمق التاريخي!
صدمتان في ظرف وجيز، الأولى أن مصر هي التي- برغم الخلافات التي ميزت العلاقات بين عبد الناصر والزعيم التونسي- قررت أن تخصص لبورقيبة متحفا لا بد وأن ملايين السياح، وهؤلاء ليسوا من سقط متاع أوروبا الشرقية حتما، سيزورون هذا المتحف سنويا، وقد يرسخ في أذهان بعضهم عندما يفعل الزمن فعله في الذاكرة أنه أحد زعماء مصر. إننا لا يمكن إلا أن نشكر أشقاءنا رجال الثقافة في مصر الذين لا ينامون كما ينام غيرهم، ولا يعدمون وسيلة لإثراء السياحة الثقافية في بلادهم، غير أننا كنا نتمنى أن يبادر تونسيون إلى ذلك، فالزعيم تونسي مهما اختلف الناس في تقييمهم لمسيرته السياسية، ومن حق وطننا علينا أن نرعى رموزه في ذاكرتنا وأن ننقل عنها للأجيال المقبلة صورة تليق بنا وبها. لا يتعلق الأمر مطلقا في هذا المثال بالذات بإنشاء متحف للزعيم بورقيبة، فقد يكون ذلك مكلفا لوزارة الثقافة في بلادنا ونحن لا نريد أن نرهقها بطلبات لم تتوقعها عندما رسمت ميزانيتها. الأمر يتعلق فقط بتنشيط متحف موجود منذ فترة طويلة وهو متحف معقل الزعيم الذي يجهل وجوده كثير من الناس وقد يمرون أمام ذلك المبنى ويتساءلون عما يكون داخله دون أن يجرؤ معظمهم على الولوج داخله. وبالمناسبة فحتى العملة المكلفون بحراسة هذا المتحف نسوا أنه متحف مجعول ليزوره التونسيون مثل غيره من المتاحف، لذلك يسألونك عندما تطرق عليهم الباب عما تريد !!! قد نختلف في قيمة الدور التاريخي لبورقيبة أو نتفق، قد لا تكون لنا نفس النظرة لمسيرته السياسية سواء في فترة الكفاح من أجل التحرر الوطني أو في فترة بناء الدولة الوطنية، قد نترحم عليه عندما يذكر اسمه أو قد نرفض ذلك مطلقين العنان لأحاسيس الشماتة في خصم أعيانا أمره ردحا من الزمن، قد نعترف له ببعض المزايا أو ننكرها عليه، ولكن لا أحد يجرؤ على الشك في أنه كان محور الحياة في تونس لحوالي الخمسين عاما. أليس ذلك مبررا كافيا ليعتبر من مواطن الذاكرة؟
أما ابن خلدون فهو أكثر حظا، فقد شيد له تمثال ضخم في قلب العاصمة، وأطلق اسمه على أحد أكبر أنهجها وعلى دار ثقافة وعلى حي سكني وعلى عشرات المدارس والمعاهد، واحتفي في السنة المنصرمة بالذكرى المئوية السادسة لوفاته. وأكثر من ذلك فإن بإمكانه أن يختار بين تونس ومصر "وطنا" له، فهما تتنازعانه وربما مكنه ذلك من هامش جيد للمساومة!!! ليس من المفيد أن ننكر قيمة الجهد الذي خصصته وزارة الثقافة في بلادنا لإحياء "سنة ابن خلدون"، لقد أحدث ذلك بعض الحركية على دور الثقافة وهذا في حد ذاته مدعاة للإحساس بالرضى. غير أن تصوير أحد فاقدي الخيال له في مشهد اللاهث وراء البسكويت لا يعتبر إهانة للثقافة ولمجهودات المسئولين عنها فحسب، بل هو إهانة لأحد رموز ذاكرتنا وتاريخنا الذي حقق للبشرية فتحا في الفكر والمعرفة. قد تسأل العبقري الذي أبدع تلك الومضة الإشهارية عمن يكون ابن خلدون، ربما ادعى معرفته بالرجل وبرمزيته حتى لا يبدو في صورة الجاهل، ولكننا نرى أن من مصلحته أن يقر بأنه جاهل، لأنه سيكون في منزلة المجتهد الذي أخطأ، وهذا يسمح له بالمطالبة بأجر واحد على الأقل. ولكن إذا ما كان هو جاهلا لقدر الرجل، فما عذر الذي أشر بالموافقة على عرض الومضة، ومدير تلك القناة العتيدة، إلى آخر السلسلة؟
إن انعكاسات هذا الإسفاف على ثقافتنا وعلى نظرة الأجيال المتعلمة لرمزية الهرم الخلدوني ستكون وخيمة ما لم تضبط معايير واضحة في التعامل مع هذا النوع من المسائل. كان بإمكان بعض الذين قيض لهم أن يتحكموا في ما نشاهده أن يسألوا أهل الذكر وما أكثرهم، عمن يكون ابن خلدون، وأن يصلحوا خطأهم الفادح، حتى لا نفجع بإبداعات أخرى قد تتجرأ على حنبعل أو على عليسة أو على أسد بن الفرات أو على ابن الجزار أو على أي مصباح آخر من مصابيح ثقافتنا الجمعية.
إن المسألة تتعلق بالطريقة التي ننظر بها إلى تاريخنا وإلى فرادة المزيج الذي أنتج ثقافتنا الحاضرة. فنحن شئنا ذلك أم أبينا حلقة في سلسلة عمرها آلاف السنين، ومن حق الإنسانية كما من حق الأجيال المقبلة علينا أن نحسن التصرف في هذا التراث مهما اختلفنا في تقييم مرحلة من مراحله. هل قمنا بالواجبات التي تحتمها علينا هذه المسؤولية؟ الأمر يحتاج بالتأكيد إلى تفكير. لنقارن بمصر على سبيل المثال، صحيح أنه ليست لنا أهرامات ولا أبو الهول، ولكن كان بالإمكان توجيه السياحة في بلادنا وجهة ثقافية وإنشاء مسالك سياحية جديدة بالاعتماد على ثراء موروثنا الثقافي بدرجة أساسية، عوضا عن بناء سياحة لا تقدم للسائح سوى ما لا نملك فيه تصرفا: الصحراء والشمس والبحر. لا يعني ذلك أن السياحة الثقافية غير موجودة، فنحن نصطدم بالسياح في متحف باردو وفي السقيفة الكحلاء وفي بلريجيا وحمامات أنطونينوس... نصطدم بهم فحسب لأنهم لا يأتون خصيصا لزيارة تلك المعالم. وفي المقابل ما هو مصير مئات المواقع الأخرى التي تكاد تنهار من جراء الإهمال. لننظر على سبيل المثال إلى قصور البايات، قصر المرسى يكاد يتهاوى وقصر حمام الأنف تحول إلى وكالة لسكن المعوزين، مساكن المستوطنين الإيطاليين والفرنسيين في الوطن القبلي وغيره تعاني من ظلم غير مبرر وهي التي بإمكانها لوحدها أن تشكل مسلكا سياحيا. وإذا ما تواصل ذلك فإنه لن يمضي وقت طويل حتى تزول علامات فترة كاملة من تاريخنا القريب.
بل إن القضية قبل ذلك قضية ذاكرة، وفي ذاكرتنا من الثقوب ما قد يعجز الراتق عن إصلاحه. ومرة أخرى فلا يجب في رأينا التعويل على الدولة ومصالحها لتنجز ما يجب إنجازه في هذا المجال. فالمسألة تتجاوز القرار السياسي وإن كان ذلك ضروريا باستمرار. في البلدان العريقة في التاريخ تتكون الجمعيات لحماية شجرة أو جسر أو طريق قديمة أو للتعريف بمفكر أو شاعر، وفي بلدان أخرى يصبح الآباء والأجداد آلهة تعبد ويستنجد بحكمتها، أما نحن فنعتقد دائما أننا ولدنا البارحة وأنه يتحتم علينا أن نبدأ في كل مرة من جديد. بديهي أن ذلك يجعل منا عاجزين عن إدراك ثراء الموروث الذي قيض له أن يضع مصيره بين أيدينا، وبديهي أن تكون النتيجة انبتاتا للأجيال الجديدة برغم مجهودات المدرسة، وضياعا في عالم تكاد تنقرض فيه القيم. بل لعلنا اليوم بحاجة إلى أن نبدأ من جديد بالفعل، إلى أن نجد للثقافة والفكر مكانا يقيهما غائلة الاضطهاد الذي تمارسه عليهما "قيم" الإسفاف والربح السهل، إلى أن نعيد اكتشاف تاريخنا وثقافتنا، إلى أن نعود إلى المدرسة من جديد حتى نتذكر أبسط الأشياء: لون وشكل العلم الوطني[1][1].
[1][1] - بمناسبة تنظيم الدورة السابقة لبطولة العالم لكرة اليد في تونس شاهد كثير من التونسيين مترو نقل تونس يتهادى في شوارع العاصمة حاملا علم تركيا خطأ عوضا عن علم تونس ولم يتفطن لذلك أحد لأكثر من أسبوع !!!!
عدنان المنصر
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 2 مارس 2007 و بصحيفة "الحياة اللندنية ليوم 12 مارس 2008
في المنطلق خبران: الجزيرة نقلا عن مصادر ثقافية مصرية تعلن افتتاح متحف حول الزعيم التونسي بورقيبة بالقرية الفرعونية المصرية وهو المتحف الثالث من نوعه المخصص لزعامة معاصرة بعد المتحفين المخصصين لكل من جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، والثاني أن ابن خلدون شوهد على شاشة إحدى قنواتنا التلفزية يلاحق أحد أنواع البسكويت في شوارع العاصمة في ومضة إشهارية تفتقت عليها عبقرية أحد مخرجي الإعلانات التلفزية الباحثين عن العمق التاريخي!
صدمتان في ظرف وجيز، الأولى أن مصر هي التي- برغم الخلافات التي ميزت العلاقات بين عبد الناصر والزعيم التونسي- قررت أن تخصص لبورقيبة متحفا لا بد وأن ملايين السياح، وهؤلاء ليسوا من سقط متاع أوروبا الشرقية حتما، سيزورون هذا المتحف سنويا، وقد يرسخ في أذهان بعضهم عندما يفعل الزمن فعله في الذاكرة أنه أحد زعماء مصر. إننا لا يمكن إلا أن نشكر أشقاءنا رجال الثقافة في مصر الذين لا ينامون كما ينام غيرهم، ولا يعدمون وسيلة لإثراء السياحة الثقافية في بلادهم، غير أننا كنا نتمنى أن يبادر تونسيون إلى ذلك، فالزعيم تونسي مهما اختلف الناس في تقييمهم لمسيرته السياسية، ومن حق وطننا علينا أن نرعى رموزه في ذاكرتنا وأن ننقل عنها للأجيال المقبلة صورة تليق بنا وبها. لا يتعلق الأمر مطلقا في هذا المثال بالذات بإنشاء متحف للزعيم بورقيبة، فقد يكون ذلك مكلفا لوزارة الثقافة في بلادنا ونحن لا نريد أن نرهقها بطلبات لم تتوقعها عندما رسمت ميزانيتها. الأمر يتعلق فقط بتنشيط متحف موجود منذ فترة طويلة وهو متحف معقل الزعيم الذي يجهل وجوده كثير من الناس وقد يمرون أمام ذلك المبنى ويتساءلون عما يكون داخله دون أن يجرؤ معظمهم على الولوج داخله. وبالمناسبة فحتى العملة المكلفون بحراسة هذا المتحف نسوا أنه متحف مجعول ليزوره التونسيون مثل غيره من المتاحف، لذلك يسألونك عندما تطرق عليهم الباب عما تريد !!! قد نختلف في قيمة الدور التاريخي لبورقيبة أو نتفق، قد لا تكون لنا نفس النظرة لمسيرته السياسية سواء في فترة الكفاح من أجل التحرر الوطني أو في فترة بناء الدولة الوطنية، قد نترحم عليه عندما يذكر اسمه أو قد نرفض ذلك مطلقين العنان لأحاسيس الشماتة في خصم أعيانا أمره ردحا من الزمن، قد نعترف له ببعض المزايا أو ننكرها عليه، ولكن لا أحد يجرؤ على الشك في أنه كان محور الحياة في تونس لحوالي الخمسين عاما. أليس ذلك مبررا كافيا ليعتبر من مواطن الذاكرة؟
أما ابن خلدون فهو أكثر حظا، فقد شيد له تمثال ضخم في قلب العاصمة، وأطلق اسمه على أحد أكبر أنهجها وعلى دار ثقافة وعلى حي سكني وعلى عشرات المدارس والمعاهد، واحتفي في السنة المنصرمة بالذكرى المئوية السادسة لوفاته. وأكثر من ذلك فإن بإمكانه أن يختار بين تونس ومصر "وطنا" له، فهما تتنازعانه وربما مكنه ذلك من هامش جيد للمساومة!!! ليس من المفيد أن ننكر قيمة الجهد الذي خصصته وزارة الثقافة في بلادنا لإحياء "سنة ابن خلدون"، لقد أحدث ذلك بعض الحركية على دور الثقافة وهذا في حد ذاته مدعاة للإحساس بالرضى. غير أن تصوير أحد فاقدي الخيال له في مشهد اللاهث وراء البسكويت لا يعتبر إهانة للثقافة ولمجهودات المسئولين عنها فحسب، بل هو إهانة لأحد رموز ذاكرتنا وتاريخنا الذي حقق للبشرية فتحا في الفكر والمعرفة. قد تسأل العبقري الذي أبدع تلك الومضة الإشهارية عمن يكون ابن خلدون، ربما ادعى معرفته بالرجل وبرمزيته حتى لا يبدو في صورة الجاهل، ولكننا نرى أن من مصلحته أن يقر بأنه جاهل، لأنه سيكون في منزلة المجتهد الذي أخطأ، وهذا يسمح له بالمطالبة بأجر واحد على الأقل. ولكن إذا ما كان هو جاهلا لقدر الرجل، فما عذر الذي أشر بالموافقة على عرض الومضة، ومدير تلك القناة العتيدة، إلى آخر السلسلة؟
إن انعكاسات هذا الإسفاف على ثقافتنا وعلى نظرة الأجيال المتعلمة لرمزية الهرم الخلدوني ستكون وخيمة ما لم تضبط معايير واضحة في التعامل مع هذا النوع من المسائل. كان بإمكان بعض الذين قيض لهم أن يتحكموا في ما نشاهده أن يسألوا أهل الذكر وما أكثرهم، عمن يكون ابن خلدون، وأن يصلحوا خطأهم الفادح، حتى لا نفجع بإبداعات أخرى قد تتجرأ على حنبعل أو على عليسة أو على أسد بن الفرات أو على ابن الجزار أو على أي مصباح آخر من مصابيح ثقافتنا الجمعية.
إن المسألة تتعلق بالطريقة التي ننظر بها إلى تاريخنا وإلى فرادة المزيج الذي أنتج ثقافتنا الحاضرة. فنحن شئنا ذلك أم أبينا حلقة في سلسلة عمرها آلاف السنين، ومن حق الإنسانية كما من حق الأجيال المقبلة علينا أن نحسن التصرف في هذا التراث مهما اختلفنا في تقييم مرحلة من مراحله. هل قمنا بالواجبات التي تحتمها علينا هذه المسؤولية؟ الأمر يحتاج بالتأكيد إلى تفكير. لنقارن بمصر على سبيل المثال، صحيح أنه ليست لنا أهرامات ولا أبو الهول، ولكن كان بالإمكان توجيه السياحة في بلادنا وجهة ثقافية وإنشاء مسالك سياحية جديدة بالاعتماد على ثراء موروثنا الثقافي بدرجة أساسية، عوضا عن بناء سياحة لا تقدم للسائح سوى ما لا نملك فيه تصرفا: الصحراء والشمس والبحر. لا يعني ذلك أن السياحة الثقافية غير موجودة، فنحن نصطدم بالسياح في متحف باردو وفي السقيفة الكحلاء وفي بلريجيا وحمامات أنطونينوس... نصطدم بهم فحسب لأنهم لا يأتون خصيصا لزيارة تلك المعالم. وفي المقابل ما هو مصير مئات المواقع الأخرى التي تكاد تنهار من جراء الإهمال. لننظر على سبيل المثال إلى قصور البايات، قصر المرسى يكاد يتهاوى وقصر حمام الأنف تحول إلى وكالة لسكن المعوزين، مساكن المستوطنين الإيطاليين والفرنسيين في الوطن القبلي وغيره تعاني من ظلم غير مبرر وهي التي بإمكانها لوحدها أن تشكل مسلكا سياحيا. وإذا ما تواصل ذلك فإنه لن يمضي وقت طويل حتى تزول علامات فترة كاملة من تاريخنا القريب.
بل إن القضية قبل ذلك قضية ذاكرة، وفي ذاكرتنا من الثقوب ما قد يعجز الراتق عن إصلاحه. ومرة أخرى فلا يجب في رأينا التعويل على الدولة ومصالحها لتنجز ما يجب إنجازه في هذا المجال. فالمسألة تتجاوز القرار السياسي وإن كان ذلك ضروريا باستمرار. في البلدان العريقة في التاريخ تتكون الجمعيات لحماية شجرة أو جسر أو طريق قديمة أو للتعريف بمفكر أو شاعر، وفي بلدان أخرى يصبح الآباء والأجداد آلهة تعبد ويستنجد بحكمتها، أما نحن فنعتقد دائما أننا ولدنا البارحة وأنه يتحتم علينا أن نبدأ في كل مرة من جديد. بديهي أن ذلك يجعل منا عاجزين عن إدراك ثراء الموروث الذي قيض له أن يضع مصيره بين أيدينا، وبديهي أن تكون النتيجة انبتاتا للأجيال الجديدة برغم مجهودات المدرسة، وضياعا في عالم تكاد تنقرض فيه القيم. بل لعلنا اليوم بحاجة إلى أن نبدأ من جديد بالفعل، إلى أن نجد للثقافة والفكر مكانا يقيهما غائلة الاضطهاد الذي تمارسه عليهما "قيم" الإسفاف والربح السهل، إلى أن نعيد اكتشاف تاريخنا وثقافتنا، إلى أن نعود إلى المدرسة من جديد حتى نتذكر أبسط الأشياء: لون وشكل العلم الوطني[1][1].
[1][1] - بمناسبة تنظيم الدورة السابقة لبطولة العالم لكرة اليد في تونس شاهد كثير من التونسيين مترو نقل تونس يتهادى في شوارع العاصمة حاملا علم تركيا خطأ عوضا عن علم تونس ولم يتفطن لذلك أحد لأكثر من أسبوع !!!!
واحد وخمسون عاما على دولة الاستقلال
متى تقوم دولة المواطنة؟
عدنان المنصر
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 23 مارس 2007
تمر هذا الأسبوع الذكرى الواحدة والخمسون على نيل تونس "استقلالها التام"، ففي يوم 20 مارس 1956 قطعت البلاد خطوة إضافية، ولكنها لن تكون الأخيرة، في سبيل الإنعتاق من الهيمنة الاستعمارية الفرنسية، تلك الهيمنة التي استمرت 75 عاما. وقد جاء إمضاء بروتوكول الاستقلال التام ليضع، بشكل رسمي، حدا لواقع ازدواجية السيادة التي أسستها اتفاقيات الاستقلال الداخلي حيث كان للفرنسيين إلى حد ذلك التاريخ القول الفصل في معظم الميادين الحساسة.
لا شك أن الحدث كان هاما بالنسبة لمن عاش تلك الفترة، ولا شك أنه يبقى ذا قيمة هامة أيضا لنا اليوم، غير أن ذلك ليس داعيا لتقديسه إلى الحد الذي ينسينا ما رافقه وتلاه من مآس لازلنا نتجرع مرارتها إلى اليوم. فبين الحدثين حصلت أعمال رهيبة من القتل والترهيب في إطار ما سمي "بالفتنة اليوسفية" ، وغاصت البلاد في هوة التقاتل الأهلي زمنا ليس بالقصير، وتواجه رفاق السلاح السابقين في معارك طاحنة سخر لها كل طرف ما استطاع من حلفاء ومساندين، تحت قيادة إخوة أعداء فرقتهم سبل السياسة . لن نتوقف هنا عند مراحل هذا الصراع الذي كتب وسيكتب حوله الكثير، ولن نضع نصب أعيننا تحميل المسؤولية عنه إلى طرف دون غيره، فالجميع كان مسؤولا وإن بدرجات متفاوتة. إنما همنا هنا أن نؤكد على أن حدث الاستقلال لم يكن الحدث الذي نعتقد اليوم أنه كان، فقد غطت عليه آنذاك أخبار المداهمات والاختطافات والاغتيالات والمحاكمات والإعدامات... وأن الوضع الذي ستنشأ في خضمه دولة الاستقلال سيكون محددا أساسيا لطبيعة السلطة الجديدة. لقد كانت سلطة نشأت في خضم الصراع الأهلي، على يد زعامات مؤمنة شديد الإيمان بأنها مهددة في صميم دورها التاريخي بل وفي وجودها المادي. وغني عن التوضيح هنا أن التهديد اليوسفي الذي كان جديا إلى أبعد الحدود قد استعمل من الجانب البورقيبي "كفزاعة" لإقناع الفرنسيين بتجنيد أكبر جهد ممكن لمقارعة الخصم المشترك، مما يجعل من "اليوسفيين" ضمنيا شركاء في تحقيق "الاستقلال التام". غير أن ما سيحدث لاحقا كان مختلفا. فقد اعتبر اليوسفيون مغلوبين يجدر الانتقام منهم والتنكيل بهم، فتواصلت المحاكمات والتتبعات بل والإعدامات والاغتيالات، وكانت تلك فرصة استغلها بعض الأتباع للإفصاح عن مهاراتهم المكنونة.
من هنا لم يكن هناك بد من اعتبار البورقيبيين أنفسهم منتصرين، فشرعوا في بناء الدولة الجديدة بكثير من التشفي قي خصومهم الحقيقيين والمفترضين. وليس من الوارد هنا أن ننكر وطنية الزعامات التي وضعت على عاتقها مهمة بناء الدولة كما مهمة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهذه الزعامات وبخاصة بورقيبة ظلت تعتقد أن الاستقلال التام مجرد مرحلة على طريق بناء بعيد المدى سخرت له كل إمكانيات الكيان الفتي. كان التحديث هو الهدف النهائي لهذه النخبة الوطنية، وكان سعيها نحو هذا الهدف حثيثا، في إطار حماس شعبي فياض. كان التحديث يهدف إلى إنشاء إنسان جديد في وطن جديد، فكان إصلاح التعليم وإصلاح القضاء والأحوال الشخصية... إلى غير ذلك مما نتنعم اليوم ببعض ثماره. غير أن هذا التحديث لم تصاحبه حريات حقيقية تسمح للتونسيين بهامش ولو ضيق من الاختلاف مع الإيديولوجيا المنتصرة. فحكمت النخبة الجديدة على "الثقافة التقليدية" بالزوال، واستحوذت على صلاحيات كانت باستمرار عصية على الحاكمين، فنصب بورقيبة نفسه مفتيا ومعلما وإماما بل ورسولا. وبالموازاة مع ذلك انطلق مسار من التأليه لبورقيبة ستسخر له إمكانيات الدولة جميعها، كما ستسخر له ماكينة حزبية فعالة. ولن تعيق عملية بناء المؤسسات الجمهورية، بما في ذلك الدستور والبرلمان، هذا المسار، حيث نجح بورقيبة في بناء نمط من النفوذ يخترق كل المؤسسات، بل نجح في إقناع جانب من التونسيين بأن وجوده ضمانة لحسن سير المؤسسات. لذلك فقد كان التونسيون مستعدين ليغفروا له هفواته، فقد كان أباهم الذي على الأرض. لذلك فلم يكن من الصعب عليه أن يقنعهم أن وجودهم وفرحة حياتهم مرتبطة به، وأن "القائد في الكفاح هو الضامن للنجاح". كانوا سيصبحون أيتاما لو قيض لبعض "المعتوهين" أو "المارقين" أن يضعوا حياته تحت التهديد. وفي المقابل كان هو يحسن استغلال الفرص للتخلص من مزيد من المناوئين. ففي أواخر 1962 أكتشف أمر المحاولة الانقلابية الشهيرة التي دبرها بعض قدماء المقاومين وبعض العسكريين بتعاون مع بعض اليوسفيين. كانت الفرصة مواتية للقضاء على آخر قلاع المعارضة للبورقيبية وإحكام السيطرة على المجتمع وعلى الفضاء السياسي بالخصوص عن طريق احتكار النشاط السياسي الشرعي وإخراج ما بقي من تنظيمات مستقلة من دائرة الشرعية (حل الحزب الشيوعي). كما مكنت المناسبة من تصفية اللوبي الذي كان يشكله المقاومون القدامى حيث سيصار إلى إقصائهم المنهجي من التاريخ الرسمي.
لقد ولدت الدولة الوطنية، دولة الاستقلال، من رحم إيديولوجيا تحديثية لا تستند على المؤسسات مثلما تقتضي ذلك الحداثة، بل على وجود زعيم مفعم بالنرجسية. وبديهي أن تكون لهذه الولادة المشوهة لمشروع الدولة الوطنية انعكاسات بعيدة المدى على مسارها. لقد اعتقد بورقيبة باستمرار أنه الروح التي نفخت في جسد اسمه الشعب التونسي، وأن خروج الروح من الجسد يتبعها موته وتحلله لا محالة. وقد قيض له أن يجد من يسانده في تثبيت هذه الفكرة، خوفا أو طمعا. من هنا فقد ظل هو والمؤمنون به يعتقدون في قصور هذا الشعب الذي يفترض أنهم المعبرون عن إرادته الحرة، فأصبحوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون يفكرون ويقررون ويحلمون عوضا عنه، يدركون مصالحه ويعطفون عليه أكثر منه. أما المارقون العاقون ، رؤوس الفتنة والمغرر بهم، فإلى المحاكم والسجون والمنافي يقادون، ومن الأمة يقصون. لم يكن غريبا أن يؤدي هذا المسار إلى مزيد من انغلاق الحكم وفساد وتكلس المؤسسات وترهل الدعاية وتهرم الزعامة، في مواجهة هدير الفئات الجديدة المثقفة والمتعلمة والجائعة والمتنمرة لتحقيق إنسانيتها ومواطنتها. بل إن ما كان بالإمكان تقديمه كذريعة للتأمل ثم الانفتاح فالتجدد (1968، 1969، 1972، 1978، 1981، 1984)، لن يكون في الحقيقة سوى مناسبة لزيادة التقوقع ودس الرأس أعمق في الرمل.
قد نختلف في معنى الاستقلال وتعريفه وقد نتفق، قد يرى البعض أنه لم يعد له من معنى في عالم اليوم المفعم بالعولمة وقد يصر البعض الآخر على أن في العولمة من الحسنات ما يغطي على السيئات. ولكن أين الإنسان من كل ذلك؟ أليس مفترضا أن يكون هو أصل الأشياء وغاية العمل؟ لقد كان هدف الاستقلال بناء دولة وإنشاء أمة، غير أن ذلك تم على غير النحو المراد وبإتباع أيسر السبل، فأصبحت الدولة هي الغاية وما عداها الأداة. وإمعانا في الاختزال أصبح الحكم هو الدولة، وأصبحت للحكم مسالك معينة لا يقوى على الخروج منها. وفي المقابل حافظت المؤسسات على الخطيئة الأصلية، لقد أنشئت لتعاضد الحكم لا لتبني دولة الحداثة، أما الإنسان فكان يتوجب عليه أن يتجمل دوما بصبر لا ينفذ، أن ينتظر دوره على لائحة أهداف الدولة الوطنية، وأن يزيد إيمانا بأن الأهم يسبق دائما المهم، وبأنه ليس الأهم. لقد أسست نرجسية بورقيبة وتزلف الذين في قلوبهم مرض لواقع لن يكون تجاوزه هينا: واقع أن "المواطن" أفضل بدون المواطنة. لكن التاريخ، قريبه وبعيده، ماثل أمامنا ليعلمنا أن دولة لا تقوم على المواطنة مشروع تعوزه أهم عوامل الاستمرار.
متى تقوم دولة المواطنة؟
عدنان المنصر
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 23 مارس 2007
تمر هذا الأسبوع الذكرى الواحدة والخمسون على نيل تونس "استقلالها التام"، ففي يوم 20 مارس 1956 قطعت البلاد خطوة إضافية، ولكنها لن تكون الأخيرة، في سبيل الإنعتاق من الهيمنة الاستعمارية الفرنسية، تلك الهيمنة التي استمرت 75 عاما. وقد جاء إمضاء بروتوكول الاستقلال التام ليضع، بشكل رسمي، حدا لواقع ازدواجية السيادة التي أسستها اتفاقيات الاستقلال الداخلي حيث كان للفرنسيين إلى حد ذلك التاريخ القول الفصل في معظم الميادين الحساسة.
لا شك أن الحدث كان هاما بالنسبة لمن عاش تلك الفترة، ولا شك أنه يبقى ذا قيمة هامة أيضا لنا اليوم، غير أن ذلك ليس داعيا لتقديسه إلى الحد الذي ينسينا ما رافقه وتلاه من مآس لازلنا نتجرع مرارتها إلى اليوم. فبين الحدثين حصلت أعمال رهيبة من القتل والترهيب في إطار ما سمي "بالفتنة اليوسفية" ، وغاصت البلاد في هوة التقاتل الأهلي زمنا ليس بالقصير، وتواجه رفاق السلاح السابقين في معارك طاحنة سخر لها كل طرف ما استطاع من حلفاء ومساندين، تحت قيادة إخوة أعداء فرقتهم سبل السياسة . لن نتوقف هنا عند مراحل هذا الصراع الذي كتب وسيكتب حوله الكثير، ولن نضع نصب أعيننا تحميل المسؤولية عنه إلى طرف دون غيره، فالجميع كان مسؤولا وإن بدرجات متفاوتة. إنما همنا هنا أن نؤكد على أن حدث الاستقلال لم يكن الحدث الذي نعتقد اليوم أنه كان، فقد غطت عليه آنذاك أخبار المداهمات والاختطافات والاغتيالات والمحاكمات والإعدامات... وأن الوضع الذي ستنشأ في خضمه دولة الاستقلال سيكون محددا أساسيا لطبيعة السلطة الجديدة. لقد كانت سلطة نشأت في خضم الصراع الأهلي، على يد زعامات مؤمنة شديد الإيمان بأنها مهددة في صميم دورها التاريخي بل وفي وجودها المادي. وغني عن التوضيح هنا أن التهديد اليوسفي الذي كان جديا إلى أبعد الحدود قد استعمل من الجانب البورقيبي "كفزاعة" لإقناع الفرنسيين بتجنيد أكبر جهد ممكن لمقارعة الخصم المشترك، مما يجعل من "اليوسفيين" ضمنيا شركاء في تحقيق "الاستقلال التام". غير أن ما سيحدث لاحقا كان مختلفا. فقد اعتبر اليوسفيون مغلوبين يجدر الانتقام منهم والتنكيل بهم، فتواصلت المحاكمات والتتبعات بل والإعدامات والاغتيالات، وكانت تلك فرصة استغلها بعض الأتباع للإفصاح عن مهاراتهم المكنونة.
من هنا لم يكن هناك بد من اعتبار البورقيبيين أنفسهم منتصرين، فشرعوا في بناء الدولة الجديدة بكثير من التشفي قي خصومهم الحقيقيين والمفترضين. وليس من الوارد هنا أن ننكر وطنية الزعامات التي وضعت على عاتقها مهمة بناء الدولة كما مهمة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهذه الزعامات وبخاصة بورقيبة ظلت تعتقد أن الاستقلال التام مجرد مرحلة على طريق بناء بعيد المدى سخرت له كل إمكانيات الكيان الفتي. كان التحديث هو الهدف النهائي لهذه النخبة الوطنية، وكان سعيها نحو هذا الهدف حثيثا، في إطار حماس شعبي فياض. كان التحديث يهدف إلى إنشاء إنسان جديد في وطن جديد، فكان إصلاح التعليم وإصلاح القضاء والأحوال الشخصية... إلى غير ذلك مما نتنعم اليوم ببعض ثماره. غير أن هذا التحديث لم تصاحبه حريات حقيقية تسمح للتونسيين بهامش ولو ضيق من الاختلاف مع الإيديولوجيا المنتصرة. فحكمت النخبة الجديدة على "الثقافة التقليدية" بالزوال، واستحوذت على صلاحيات كانت باستمرار عصية على الحاكمين، فنصب بورقيبة نفسه مفتيا ومعلما وإماما بل ورسولا. وبالموازاة مع ذلك انطلق مسار من التأليه لبورقيبة ستسخر له إمكانيات الدولة جميعها، كما ستسخر له ماكينة حزبية فعالة. ولن تعيق عملية بناء المؤسسات الجمهورية، بما في ذلك الدستور والبرلمان، هذا المسار، حيث نجح بورقيبة في بناء نمط من النفوذ يخترق كل المؤسسات، بل نجح في إقناع جانب من التونسيين بأن وجوده ضمانة لحسن سير المؤسسات. لذلك فقد كان التونسيون مستعدين ليغفروا له هفواته، فقد كان أباهم الذي على الأرض. لذلك فلم يكن من الصعب عليه أن يقنعهم أن وجودهم وفرحة حياتهم مرتبطة به، وأن "القائد في الكفاح هو الضامن للنجاح". كانوا سيصبحون أيتاما لو قيض لبعض "المعتوهين" أو "المارقين" أن يضعوا حياته تحت التهديد. وفي المقابل كان هو يحسن استغلال الفرص للتخلص من مزيد من المناوئين. ففي أواخر 1962 أكتشف أمر المحاولة الانقلابية الشهيرة التي دبرها بعض قدماء المقاومين وبعض العسكريين بتعاون مع بعض اليوسفيين. كانت الفرصة مواتية للقضاء على آخر قلاع المعارضة للبورقيبية وإحكام السيطرة على المجتمع وعلى الفضاء السياسي بالخصوص عن طريق احتكار النشاط السياسي الشرعي وإخراج ما بقي من تنظيمات مستقلة من دائرة الشرعية (حل الحزب الشيوعي). كما مكنت المناسبة من تصفية اللوبي الذي كان يشكله المقاومون القدامى حيث سيصار إلى إقصائهم المنهجي من التاريخ الرسمي.
لقد ولدت الدولة الوطنية، دولة الاستقلال، من رحم إيديولوجيا تحديثية لا تستند على المؤسسات مثلما تقتضي ذلك الحداثة، بل على وجود زعيم مفعم بالنرجسية. وبديهي أن تكون لهذه الولادة المشوهة لمشروع الدولة الوطنية انعكاسات بعيدة المدى على مسارها. لقد اعتقد بورقيبة باستمرار أنه الروح التي نفخت في جسد اسمه الشعب التونسي، وأن خروج الروح من الجسد يتبعها موته وتحلله لا محالة. وقد قيض له أن يجد من يسانده في تثبيت هذه الفكرة، خوفا أو طمعا. من هنا فقد ظل هو والمؤمنون به يعتقدون في قصور هذا الشعب الذي يفترض أنهم المعبرون عن إرادته الحرة، فأصبحوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون يفكرون ويقررون ويحلمون عوضا عنه، يدركون مصالحه ويعطفون عليه أكثر منه. أما المارقون العاقون ، رؤوس الفتنة والمغرر بهم، فإلى المحاكم والسجون والمنافي يقادون، ومن الأمة يقصون. لم يكن غريبا أن يؤدي هذا المسار إلى مزيد من انغلاق الحكم وفساد وتكلس المؤسسات وترهل الدعاية وتهرم الزعامة، في مواجهة هدير الفئات الجديدة المثقفة والمتعلمة والجائعة والمتنمرة لتحقيق إنسانيتها ومواطنتها. بل إن ما كان بالإمكان تقديمه كذريعة للتأمل ثم الانفتاح فالتجدد (1968، 1969، 1972، 1978، 1981، 1984)، لن يكون في الحقيقة سوى مناسبة لزيادة التقوقع ودس الرأس أعمق في الرمل.
قد نختلف في معنى الاستقلال وتعريفه وقد نتفق، قد يرى البعض أنه لم يعد له من معنى في عالم اليوم المفعم بالعولمة وقد يصر البعض الآخر على أن في العولمة من الحسنات ما يغطي على السيئات. ولكن أين الإنسان من كل ذلك؟ أليس مفترضا أن يكون هو أصل الأشياء وغاية العمل؟ لقد كان هدف الاستقلال بناء دولة وإنشاء أمة، غير أن ذلك تم على غير النحو المراد وبإتباع أيسر السبل، فأصبحت الدولة هي الغاية وما عداها الأداة. وإمعانا في الاختزال أصبح الحكم هو الدولة، وأصبحت للحكم مسالك معينة لا يقوى على الخروج منها. وفي المقابل حافظت المؤسسات على الخطيئة الأصلية، لقد أنشئت لتعاضد الحكم لا لتبني دولة الحداثة، أما الإنسان فكان يتوجب عليه أن يتجمل دوما بصبر لا ينفذ، أن ينتظر دوره على لائحة أهداف الدولة الوطنية، وأن يزيد إيمانا بأن الأهم يسبق دائما المهم، وبأنه ليس الأهم. لقد أسست نرجسية بورقيبة وتزلف الذين في قلوبهم مرض لواقع لن يكون تجاوزه هينا: واقع أن "المواطن" أفضل بدون المواطنة. لكن التاريخ، قريبه وبعيده، ماثل أمامنا ليعلمنا أن دولة لا تقوم على المواطنة مشروع تعوزه أهم عوامل الاستمرار.
dimanche 29 avril 2007
عندما تصاب الدولة بمرض باركنسون
مزالي ينشر مذكراته:
عندما تصاب الدولة بمرض باركنسون
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 27 أفريل 2007
عندما تصاب الدولة بمرض باركنسون
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 27 أفريل 2007
عدنان المنصر
"هذا الكتاب مزج سيرتي الذاتية بمحطات رحلتي الإنسانية، أكدت من خلالها نظرياتي وقناعاتي والصراع الذي لم يهدأ في أعمق أعماقي بين الإيمان والفعل، إنه يندرج إذن في صلب تواصل عملي النضالي من أجل تونس، من أجل الإنسان، وهو بمثابة المرحلة الختامية لحياتي". هكذا صدر الوزير الأول التونسي الأسبق محمد مزالي النسخة العربية من مذكراته التي صدرت منذ بضعة أسابيع تحت عنوان "نصيي من الحقيقة" عن دار الشروق المصرية بحجم تجاوز الستمائة صفحة من القطع المتوسط. وهذا النص وإن كان في معظمه تعريبا للنسخة الفرنسية الصادرة في وقت سابق بفرنسا فإن صاحبها قد أدخل عليها بعض الإضافات وضمنها وثائق وشهادات.
وقارئ النص العربي يجد في لغته وأسلوبه من السلاسة والعذوبة ما يذكره بأن صاحبه أديب وفيلسوف قبل أن يكون سياسيا وهو أمر يؤكده في مقدمة نصه عندما يعرض إلى علاقته بالكتابة. غير أن مزالي لا يكتب هنا لمجرد المتعة، فقد أراد من نصه غايتين تتضحان لكل من يقرأه. فقد سعى في البداية إلى تقديم شهادة عن الفترة التي ارتبطت فيها حياته بالمسؤولية السياسية منذ فجر الاستقلال، وفي خضم ذلك يقدم صورة لطبيعة سير الدولة وطريقة اتخاذ القرار في العهد البورقيبي، كما يوضح انجازاته الشخصية في مختلف مواقع المسؤولية، من وزارة التربية إلى وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع إلى الشباب والرياضة إلى الإعلام وأخيرا الوزارة الأولى. أما الغرض الثاني الذي من أجله كتب هذه المذكرات فهو الدفاع عن نفسه إزاء ما تعرض له من تشويه وهجوم غير مبرر حاول خصومه من خلاله إلغاء دوره وتاريخه، وهنا يأخذ النص مسحة مختلفة تماما. من هنا فإن الكتاب لا يقدم لقارئه مزالي السياسي فحسب بل أيضا مزالي الإنسان الذي يبدي ألمه لما يعتقد أنه ظلم وقع عليه، وقد خصص جزءا كبيرا من مذكراته لرد "الاتهامات" ودحض "الافتراءات" رغم تأكيده في بداية النص "عدم حاجته إلى الدفاع عن صدق وطنيته وأصالة كفاحه السياسي والثقافي أمام أصحاب الذاكرة المثقوبة ولا التدليل على استقامته وبراءته إزاء الإشاعات الفجة والأكاذيب السمجة والاتهامات الباطلة التي لا تستحق سوى السخرية" (ص 14) انطلاقا من مقولة أن "من عرف نفسه لا يضيره ما قاله بعض الناس فيه".
قسم محمد مزالي مذكراته إلى فصول خمسة تناول فيها مسيرته السياسية التي دامت أكثر من 30 عاما، حيث يمكن القول أنه عاصر عملية ناء الدولة وكل تجاربها وتحولاتها وأزماتها إلى حدود إعفائه من مهام الوزارة الأولى في 1986. من هنا فإن قربه من دوائر صنع القرار طيلة جانب من هذه المسيرة بل ومشاركته الفعلية في صياغة السياسة الحكومية طيلة القسم الأكبر منها يجعل من شهادته ذات قيمة خاصة لكل من أراد دراسة تاريخ دولة الاستقلال. وبالفعل فإن الكاتب يتوجه بشهادته إلى "المؤرخين الذين ستؤهلهم أمانتهم العلمية لمزيد البحث الموضوعي والتنقيب العلمي قصد إعطاء صورة ناصعة، وفية، لتاريخ تونس منذ الإستقلال" (ص15).
غير أن متن الكتاب لا يؤكد أن هذه الصورة المراد رسمها لدولة الاستقلال كانت دائما ناصعة، وهذا لا يمس في شيء من صدق النوايا والرغبة في تحقيق ازدهار الشعب التونسي وتحقيق نهضته التي كانت تحدو مؤسسي الدولة الوطنية في تونس. فقد تراجعت النوايا الطيبة أمام ضغوطات مراكز القوى داخل القصر وفي دوائر الحكم وسرعان ما أفسح المجال لصراع أجنحة داخل الدولة عطل اضطلاعها بمهامها الأصلية. هذا الصراع لم يكن يجد تبريره سوى في رغبة الاستئثار بالمواقع القريبة من الصانع الحقيقي لسياسة الدولة وهو الزعيم بورقيبة الذي أتقن بفعالية التحكم في تلك الصراعات وطوعها إلى حد كبير لمصلحة سلطته الشخصية.
قد يكون ذلك مقبولا في بعض أنظمة الحكم وربما في أغلبها، غير أن "النموذج التونسي" كان قد تفتق على بدعة قل العثور عن شبيه لها من ناحية الفعالية وشدة التأثير. هذه البدعة كانت شجرة الدر الجديدة، "الماجدة" زوجة الرئيس التي كانت تحكم البلاد من خلف ستار، متقنة كافة أساليب الاستقطاب داخل أوساط الحكومة ومكونة قطبها الخاص. كان "حزب الماجدة" كبيرا وقوي التأثير. وربما تعارض أحيانا مع "حزب الرئيس"، ولا غرابة في ذلك فقد ذكر أحد رموز المعارضة الديمقراطية في عهد بورقيبة أن "المعارضة الحقيقية لبورقيبة موجودة في فراشه". وفي مذكرات مزالي شهادة على هذا الواقع الذي زاد استفحالا مع تقدم بورقيبة في السن. ولعل أهم مناسبتين يوردهما مزالي في هذا الاتجاه هو أن أكبر الأحداث التي شهدتها تونس في تاريخها القريب قد وقعت نتيجة مؤامرة حبكت "الماجدة" خيوطها واستهدفت في كل مرة الوزير الأول (نويرة في جانفي 1978 ومزالي في 1984) الذي كان بوصفه دستوريا الخليفة المحتمل لرئيس الدولة، يتلقى كل السهام وتحبك لتحطيمه كل "المؤامرات". ربما أضاءت هذه الشهادة جانبا من الحقيقة غير أنها تبقى قاصرة عن تفسير تلك الأحداث. فأحداث "الخميس الأسود" في 26 جانفي 1978 وقعت لأن كل الظروف كانت تنبئ بوقوعها ولم يكن من الممكن في ظننا منعها. ربما كان عاشور بالفعل عضوا في "حزب الماجدة"، ولكنه ما كان ليجر وراءه كل النقابيين والشغالين لو أن هدفه كان يتلخص فحسب في الإطاحة بنويرة. كذلك الأمر بالنسبة لأحداث الخبز، فربما سهلت انفجارها كما يؤكد مزالي "مؤامرة" نسجت خيوطها بإحكام لكنها ما كانت لتقع لو أن الشعب كان راضيا عن النظام الذي يحكمه. لقد كان الحاكمون يعرفون حقيقة ما يعتمل داخل المجتمع من نقمة على سياسات لم تحقق طموحات شرائح واسعة في حياة كريمة، فسعى بعضهم إلى الاستفادة من تلك الطاقة الهائلة لتصفية حسابات ضيقة لا تكاد آفاقها تتجاوز أسوار القصر. وفي المناسبتين انتفض ذلك المارد ليفرض نفسه في واقع لم يكن يحقق فيه الإنسان إنسانيته برغم أساليب الدعاية والتعمية التي سخر لها النظام كل قدراته. إن المسألة، كما لا يوضحها صاحب المذكرات، مسألة انفصام عميق في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ذلك الانفصام الذي أدى إلى غربة ثم إلى تنافر ثم إلى تحين كليهما الفرصة للانقضاض على الآخر. وفي المناسبتين كانت الكلمة الأخيرة للحاكمين الذين لم يفوتوا فرصتهم لترسيخ عبودية الجماهير بقمع طال الأخضر واليابس. من هنا فإن حصر المسألة برمتها في مقولة "المؤامرة" يبقى قاصرا عن تفسير العمق الحقيقي لذلك الصراع وإن مكن في نهاية الأمر من توضيح بعض جوانبه.
والمتمعن في مذكرات مزالي يلاحظ أن الكاتب يضع نفسه كتواصل لسياسات الذين تقلدا منصب الوزير الأول من قبله، الباهي الأدغم والهادي نويرة. وهو لا يجد حرجا في الاعتراف لهما بالفضل على مسيرة التنمية الاقتصادية وعلى مشروع بناء الدولة، وهذا الموقف في حد ذاته موجب للاحترام حيث أننا تعودنا من كتاب المذكرات من كبار رجال الدولة ذلك المسعى المرضي لنسف إنجازات أسلافهم ومحاولة السطو على ما حققوه للبلاد وهو وجه آخر من وجوه العلاقة بين عناصر نخبة الدولة. غير أننا نفهم من ذلك أيضا أن محمد مزالي قد نظر دائما إلى دوره السياسي كمكمل لدور عناصر أخرى سبقته أو عاصرته في العمل الحكومي تحت قيادة بورقيبة. كما أن مزالي يحتفظ باحترام شديد للزعيم بورقيبة وهو من هذه الناحية أيضا يقطع مع تلك الممارسة التي تتمثل في التحمس لتسديد الطعنات كلما كانت "الضحية" عاجزة عن الرد.
وهنا لب القضية في نظرنا. فمزالي كان جزءا من نظام، وبغض النظر عن سعيه لتقديم ممارسة مختلفة للشأن العام، فإن ذلك كان عاجزا عن تحقيق تحول فعلي في مسيرة ذلك النظام. ذلك أن القرار لم يكن له، كما لم يكن لغيره مهما علت مرتبته في سلم الدولة. ومرد ذلك في الحقيقة إلى تحول النظام من نظام مصغ لصوت شعبه ساع لخدمته برغم ما وقع من أخطاء، إلى نظام همه الوحيد الإبقاء على سيطرته على المجتمع وإن أخل بأهم مقومات العقد الاجتماعي. ذلك ما نفهمه من التجربة الديمقراطية التي دشنها مزالي في 1981 والتي قتلت في مهدها لأن النظام تهيأ له أن تلك كانت بداية النهاية بالنسبة إليه وبخاصة بالنسبة لأصحاب المصالح في بقائه منغلقا على نفسه ومنعزلا عن الجماهير.
هل كان النظام عاجزا بالفعل عن انتهاز تلك الفرصة التي قدمها له مزالي لتجديد نفسه وبناء شرعية جديدة تمنحه نفسا جديدا؟ لقد كان عاجزا عن ذلك ليس لقصور في إدراك مراكز القوى لمصلحتها الحقيقية من تغيير تدريجي وسلمي لا يفقدها سيطرتها على الوضع، بل لأن بعض عناصرها كانت تتصرف بغير حرص على مصلحة النظام العامة. من هنا فإن الإشكال الحقيقي ليس في عدم حرص تلك المراكز على مصلحة الشعب أو مصلحة الدولة، لأن ذلك كان معلوما للسواد الأعظم، بل في عدم حرصها على مصلحة النظام التي كانت تقتضي انفتاحا مدروسا يقيه غائلة التحركات العنيفة. وهذا يعيدنا إلى الطبيعة الارتجالية لصنع القرار التي اتضحت في العشرية الأخيرة من حكم بورقيبة والتي لا ينبغي تبريرها بتقدمه في السن فحسب. فالمسألة تعود في نظرنا إلى عامل هيكلي يتمثل في الطبيعة الرئاسوية للنظام من ناحية، وإلى فشل مسار بناء مؤسسات قادرة على تصويب أخطاء السلطة التنفيذية. من هنا فلا مزالي ولا غيره كان قادرا على تحقيق تحول جذري في طبيعة النظام، ذلك أن مراكز القوى كانت ترى في أي تغيير مهما بدا بسيطا خطرا يهددها مباشرة. ذلك أن بناء مؤسسات حقيقية يعني فقدان تلك المراكز لغاية وجودها. فما هي المكانة الحقيقية التي يعطيها دستور دولة، مهما بلغت العبثية، لزوجة الزعيم حتى تغدو "الماجدة" صاحبة القول الفصل في تعيين الوزير الأول أو عزله؟ وأي نظام يشرف فيه وزير الداخلية (1981)على تزوير إرادة الشعب دون محاسبة أو عقاب؟ وأية دولة تلك التي تملأ الدنيا صراخا حول إصلاحات اجتماعية تجعل للطلاق ضوابط معلومة ثم يكون مؤسسها وبانيها أول من يخترقها؟
لا نشك أن مزالي وغيره كانوا مدركين لعمق الهوة التي تردى فيها مشروع الدولة في تونس، ولعلهم أرادوا تجديد شباب ذلك النظام بعد أن رأوا توغله في الاتجاه الخاطئ. فهم في نهاية الأمر تلك النخبة الشابة والمثقفة التي بنت على الاستقلال كل أحلامها في تأسيس مشروع وطني يعيد للشعب كرامته ويحقق فيه رشده السياسي.غير أن قوانين الهندسة، وليست قوانين السن والتهرم فحسب، أفشلت مساعي الصادقين منهم، ومضمونها أنك لا تستطيع إنجاز بناء صلب على أسس هاوية. وهكذا أدى تجاهل هذه القاعدة إلى إصابة كامل الدولة، وليس بورقيبة فحسب، بذلك المرض الذي يطلق عليه اسم مرض باركنسون، فبدا مرتعشا، متخشبا، فاقدا للإتزان ومكتئبا.
"هذا الكتاب مزج سيرتي الذاتية بمحطات رحلتي الإنسانية، أكدت من خلالها نظرياتي وقناعاتي والصراع الذي لم يهدأ في أعمق أعماقي بين الإيمان والفعل، إنه يندرج إذن في صلب تواصل عملي النضالي من أجل تونس، من أجل الإنسان، وهو بمثابة المرحلة الختامية لحياتي". هكذا صدر الوزير الأول التونسي الأسبق محمد مزالي النسخة العربية من مذكراته التي صدرت منذ بضعة أسابيع تحت عنوان "نصيي من الحقيقة" عن دار الشروق المصرية بحجم تجاوز الستمائة صفحة من القطع المتوسط. وهذا النص وإن كان في معظمه تعريبا للنسخة الفرنسية الصادرة في وقت سابق بفرنسا فإن صاحبها قد أدخل عليها بعض الإضافات وضمنها وثائق وشهادات.
وقارئ النص العربي يجد في لغته وأسلوبه من السلاسة والعذوبة ما يذكره بأن صاحبه أديب وفيلسوف قبل أن يكون سياسيا وهو أمر يؤكده في مقدمة نصه عندما يعرض إلى علاقته بالكتابة. غير أن مزالي لا يكتب هنا لمجرد المتعة، فقد أراد من نصه غايتين تتضحان لكل من يقرأه. فقد سعى في البداية إلى تقديم شهادة عن الفترة التي ارتبطت فيها حياته بالمسؤولية السياسية منذ فجر الاستقلال، وفي خضم ذلك يقدم صورة لطبيعة سير الدولة وطريقة اتخاذ القرار في العهد البورقيبي، كما يوضح انجازاته الشخصية في مختلف مواقع المسؤولية، من وزارة التربية إلى وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع إلى الشباب والرياضة إلى الإعلام وأخيرا الوزارة الأولى. أما الغرض الثاني الذي من أجله كتب هذه المذكرات فهو الدفاع عن نفسه إزاء ما تعرض له من تشويه وهجوم غير مبرر حاول خصومه من خلاله إلغاء دوره وتاريخه، وهنا يأخذ النص مسحة مختلفة تماما. من هنا فإن الكتاب لا يقدم لقارئه مزالي السياسي فحسب بل أيضا مزالي الإنسان الذي يبدي ألمه لما يعتقد أنه ظلم وقع عليه، وقد خصص جزءا كبيرا من مذكراته لرد "الاتهامات" ودحض "الافتراءات" رغم تأكيده في بداية النص "عدم حاجته إلى الدفاع عن صدق وطنيته وأصالة كفاحه السياسي والثقافي أمام أصحاب الذاكرة المثقوبة ولا التدليل على استقامته وبراءته إزاء الإشاعات الفجة والأكاذيب السمجة والاتهامات الباطلة التي لا تستحق سوى السخرية" (ص 14) انطلاقا من مقولة أن "من عرف نفسه لا يضيره ما قاله بعض الناس فيه".
قسم محمد مزالي مذكراته إلى فصول خمسة تناول فيها مسيرته السياسية التي دامت أكثر من 30 عاما، حيث يمكن القول أنه عاصر عملية ناء الدولة وكل تجاربها وتحولاتها وأزماتها إلى حدود إعفائه من مهام الوزارة الأولى في 1986. من هنا فإن قربه من دوائر صنع القرار طيلة جانب من هذه المسيرة بل ومشاركته الفعلية في صياغة السياسة الحكومية طيلة القسم الأكبر منها يجعل من شهادته ذات قيمة خاصة لكل من أراد دراسة تاريخ دولة الاستقلال. وبالفعل فإن الكاتب يتوجه بشهادته إلى "المؤرخين الذين ستؤهلهم أمانتهم العلمية لمزيد البحث الموضوعي والتنقيب العلمي قصد إعطاء صورة ناصعة، وفية، لتاريخ تونس منذ الإستقلال" (ص15).
غير أن متن الكتاب لا يؤكد أن هذه الصورة المراد رسمها لدولة الاستقلال كانت دائما ناصعة، وهذا لا يمس في شيء من صدق النوايا والرغبة في تحقيق ازدهار الشعب التونسي وتحقيق نهضته التي كانت تحدو مؤسسي الدولة الوطنية في تونس. فقد تراجعت النوايا الطيبة أمام ضغوطات مراكز القوى داخل القصر وفي دوائر الحكم وسرعان ما أفسح المجال لصراع أجنحة داخل الدولة عطل اضطلاعها بمهامها الأصلية. هذا الصراع لم يكن يجد تبريره سوى في رغبة الاستئثار بالمواقع القريبة من الصانع الحقيقي لسياسة الدولة وهو الزعيم بورقيبة الذي أتقن بفعالية التحكم في تلك الصراعات وطوعها إلى حد كبير لمصلحة سلطته الشخصية.
قد يكون ذلك مقبولا في بعض أنظمة الحكم وربما في أغلبها، غير أن "النموذج التونسي" كان قد تفتق على بدعة قل العثور عن شبيه لها من ناحية الفعالية وشدة التأثير. هذه البدعة كانت شجرة الدر الجديدة، "الماجدة" زوجة الرئيس التي كانت تحكم البلاد من خلف ستار، متقنة كافة أساليب الاستقطاب داخل أوساط الحكومة ومكونة قطبها الخاص. كان "حزب الماجدة" كبيرا وقوي التأثير. وربما تعارض أحيانا مع "حزب الرئيس"، ولا غرابة في ذلك فقد ذكر أحد رموز المعارضة الديمقراطية في عهد بورقيبة أن "المعارضة الحقيقية لبورقيبة موجودة في فراشه". وفي مذكرات مزالي شهادة على هذا الواقع الذي زاد استفحالا مع تقدم بورقيبة في السن. ولعل أهم مناسبتين يوردهما مزالي في هذا الاتجاه هو أن أكبر الأحداث التي شهدتها تونس في تاريخها القريب قد وقعت نتيجة مؤامرة حبكت "الماجدة" خيوطها واستهدفت في كل مرة الوزير الأول (نويرة في جانفي 1978 ومزالي في 1984) الذي كان بوصفه دستوريا الخليفة المحتمل لرئيس الدولة، يتلقى كل السهام وتحبك لتحطيمه كل "المؤامرات". ربما أضاءت هذه الشهادة جانبا من الحقيقة غير أنها تبقى قاصرة عن تفسير تلك الأحداث. فأحداث "الخميس الأسود" في 26 جانفي 1978 وقعت لأن كل الظروف كانت تنبئ بوقوعها ولم يكن من الممكن في ظننا منعها. ربما كان عاشور بالفعل عضوا في "حزب الماجدة"، ولكنه ما كان ليجر وراءه كل النقابيين والشغالين لو أن هدفه كان يتلخص فحسب في الإطاحة بنويرة. كذلك الأمر بالنسبة لأحداث الخبز، فربما سهلت انفجارها كما يؤكد مزالي "مؤامرة" نسجت خيوطها بإحكام لكنها ما كانت لتقع لو أن الشعب كان راضيا عن النظام الذي يحكمه. لقد كان الحاكمون يعرفون حقيقة ما يعتمل داخل المجتمع من نقمة على سياسات لم تحقق طموحات شرائح واسعة في حياة كريمة، فسعى بعضهم إلى الاستفادة من تلك الطاقة الهائلة لتصفية حسابات ضيقة لا تكاد آفاقها تتجاوز أسوار القصر. وفي المناسبتين انتفض ذلك المارد ليفرض نفسه في واقع لم يكن يحقق فيه الإنسان إنسانيته برغم أساليب الدعاية والتعمية التي سخر لها النظام كل قدراته. إن المسألة، كما لا يوضحها صاحب المذكرات، مسألة انفصام عميق في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ذلك الانفصام الذي أدى إلى غربة ثم إلى تنافر ثم إلى تحين كليهما الفرصة للانقضاض على الآخر. وفي المناسبتين كانت الكلمة الأخيرة للحاكمين الذين لم يفوتوا فرصتهم لترسيخ عبودية الجماهير بقمع طال الأخضر واليابس. من هنا فإن حصر المسألة برمتها في مقولة "المؤامرة" يبقى قاصرا عن تفسير العمق الحقيقي لذلك الصراع وإن مكن في نهاية الأمر من توضيح بعض جوانبه.
والمتمعن في مذكرات مزالي يلاحظ أن الكاتب يضع نفسه كتواصل لسياسات الذين تقلدا منصب الوزير الأول من قبله، الباهي الأدغم والهادي نويرة. وهو لا يجد حرجا في الاعتراف لهما بالفضل على مسيرة التنمية الاقتصادية وعلى مشروع بناء الدولة، وهذا الموقف في حد ذاته موجب للاحترام حيث أننا تعودنا من كتاب المذكرات من كبار رجال الدولة ذلك المسعى المرضي لنسف إنجازات أسلافهم ومحاولة السطو على ما حققوه للبلاد وهو وجه آخر من وجوه العلاقة بين عناصر نخبة الدولة. غير أننا نفهم من ذلك أيضا أن محمد مزالي قد نظر دائما إلى دوره السياسي كمكمل لدور عناصر أخرى سبقته أو عاصرته في العمل الحكومي تحت قيادة بورقيبة. كما أن مزالي يحتفظ باحترام شديد للزعيم بورقيبة وهو من هذه الناحية أيضا يقطع مع تلك الممارسة التي تتمثل في التحمس لتسديد الطعنات كلما كانت "الضحية" عاجزة عن الرد.
وهنا لب القضية في نظرنا. فمزالي كان جزءا من نظام، وبغض النظر عن سعيه لتقديم ممارسة مختلفة للشأن العام، فإن ذلك كان عاجزا عن تحقيق تحول فعلي في مسيرة ذلك النظام. ذلك أن القرار لم يكن له، كما لم يكن لغيره مهما علت مرتبته في سلم الدولة. ومرد ذلك في الحقيقة إلى تحول النظام من نظام مصغ لصوت شعبه ساع لخدمته برغم ما وقع من أخطاء، إلى نظام همه الوحيد الإبقاء على سيطرته على المجتمع وإن أخل بأهم مقومات العقد الاجتماعي. ذلك ما نفهمه من التجربة الديمقراطية التي دشنها مزالي في 1981 والتي قتلت في مهدها لأن النظام تهيأ له أن تلك كانت بداية النهاية بالنسبة إليه وبخاصة بالنسبة لأصحاب المصالح في بقائه منغلقا على نفسه ومنعزلا عن الجماهير.
هل كان النظام عاجزا بالفعل عن انتهاز تلك الفرصة التي قدمها له مزالي لتجديد نفسه وبناء شرعية جديدة تمنحه نفسا جديدا؟ لقد كان عاجزا عن ذلك ليس لقصور في إدراك مراكز القوى لمصلحتها الحقيقية من تغيير تدريجي وسلمي لا يفقدها سيطرتها على الوضع، بل لأن بعض عناصرها كانت تتصرف بغير حرص على مصلحة النظام العامة. من هنا فإن الإشكال الحقيقي ليس في عدم حرص تلك المراكز على مصلحة الشعب أو مصلحة الدولة، لأن ذلك كان معلوما للسواد الأعظم، بل في عدم حرصها على مصلحة النظام التي كانت تقتضي انفتاحا مدروسا يقيه غائلة التحركات العنيفة. وهذا يعيدنا إلى الطبيعة الارتجالية لصنع القرار التي اتضحت في العشرية الأخيرة من حكم بورقيبة والتي لا ينبغي تبريرها بتقدمه في السن فحسب. فالمسألة تعود في نظرنا إلى عامل هيكلي يتمثل في الطبيعة الرئاسوية للنظام من ناحية، وإلى فشل مسار بناء مؤسسات قادرة على تصويب أخطاء السلطة التنفيذية. من هنا فلا مزالي ولا غيره كان قادرا على تحقيق تحول جذري في طبيعة النظام، ذلك أن مراكز القوى كانت ترى في أي تغيير مهما بدا بسيطا خطرا يهددها مباشرة. ذلك أن بناء مؤسسات حقيقية يعني فقدان تلك المراكز لغاية وجودها. فما هي المكانة الحقيقية التي يعطيها دستور دولة، مهما بلغت العبثية، لزوجة الزعيم حتى تغدو "الماجدة" صاحبة القول الفصل في تعيين الوزير الأول أو عزله؟ وأي نظام يشرف فيه وزير الداخلية (1981)على تزوير إرادة الشعب دون محاسبة أو عقاب؟ وأية دولة تلك التي تملأ الدنيا صراخا حول إصلاحات اجتماعية تجعل للطلاق ضوابط معلومة ثم يكون مؤسسها وبانيها أول من يخترقها؟
لا نشك أن مزالي وغيره كانوا مدركين لعمق الهوة التي تردى فيها مشروع الدولة في تونس، ولعلهم أرادوا تجديد شباب ذلك النظام بعد أن رأوا توغله في الاتجاه الخاطئ. فهم في نهاية الأمر تلك النخبة الشابة والمثقفة التي بنت على الاستقلال كل أحلامها في تأسيس مشروع وطني يعيد للشعب كرامته ويحقق فيه رشده السياسي.غير أن قوانين الهندسة، وليست قوانين السن والتهرم فحسب، أفشلت مساعي الصادقين منهم، ومضمونها أنك لا تستطيع إنجاز بناء صلب على أسس هاوية. وهكذا أدى تجاهل هذه القاعدة إلى إصابة كامل الدولة، وليس بورقيبة فحسب، بذلك المرض الذي يطلق عليه اسم مرض باركنسون، فبدا مرتعشا، متخشبا، فاقدا للإتزان ومكتئبا.
في ذكرى أحداث أفريل 1938
في ذكرى أحداث أفريل 1938
هل وجد التونسيون ما وعدهم زعماؤهم حقا؟
تمر هذا الأسبوع الذكرى التاسعة والستون لأحداث 8 و 9 أفريل 1938 التي شهدتها بلادنا والتي شكلت مفصلا هاما في مسيرتها التحررية. فانطلاقا من يوم 7 أفريل شهدت مختلف مناطق القطر تنظيم مظاهرات جماهيرية أطرها الحزب الدستوري الجديد للمطالبة ببرلمان تونسي، وقد عرفت هذه التحركات أوجه جماهيريتها بتونس العاصمة في اليوم الموالي عندما خرجت مظاهرتان ضخمتان التقتا أمام مبنى السفارة الفرنسية بوسط العاصمة في تحد واضح لسياسة التضييق الاستعمارية على الوطنيين.
وفي الحقيقة فإن هذه الأحداث شكلت تتويجا لمسار طويل من التعبئة السياسية للجماهير كنتاج لفشل المسار التفاوضي الذي شرعت فيه الحركة الوطنية تحت قيادة الحزب الدستوري الجديد منذ صعود الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا. وفي المقابل كانت أوساط التفوق الاستعماري تدفع في اتجاه حصول صدام بين السلطة والوطنيين من أجل وضع نهاية لمسار تحرري بدا أنه يتجه نحو تهديد المصالح التي يقوم عليها النسق الاستعماري. إن صراع هذين الاتجاهين هو ما أدى إلى اندلاع مصادمات اليوم التالي، يوم 9 أفريل 1938، عندما سرت إشاعة (كان يعوزها المنطق) بإعدام علي البلهوان الذي كان يعتبر، بفعل حماسه الوطني واتساع تأثيره على الشباب المدرسي وخطاباته الملتهبة، محرك تلك الأحداث. من هنا، وفي إطار تلك الظرفية الخاصة من التوتر السياسي والتعبئة الكاملة، لم يكن هناك بد من وقوع ما وقع: سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين قوات حفظ النظام والتونسيين. غير أنه تجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى أن كل طرف حصل في نهاية الأمر على النتيجة التي كان يرومها: فمن ناحية القيادة الوطنية تم إثبات جماهيرية الحزب الدستوري الجديد وقدرته على التجييش والتعبئة واستعداد مناضليه الكثر إلى ولوج أشكال غير متوقعة من التحرك السياسي. أما الأوساط الاستعمارية فقد تحصلت على الذريعة التي ستحسن استغلالها للشروع في عملية قضاء منهجي على الحركة الوطنية التونسية عن طريق اعتقال القيادات الدستورية والمحاصرة الصارمة للعمل الوطني والشروع في عملية إعادة الاعتبار لهيبة النظام الاستعماري.
غير أن تلك الأحداث عبرت من ناحية أخرى على دخول معطيات جديدة إلى الساحة السياسية الوطنية في هذه الفترة الحساسة من تطور المسار التحرري. وأول هذه المعطيات على الإطلاق أن العناصر الشابة شكلت، مثلما هو الشأن في كل التحركات الجماهيرية الكبرى، العمود الفقري للتحرك الوطني. وقد ألحت بعض المصادر على الدور الذي قام به تلاميذ المدرسة الصادقية وطلبة الجامع الأعظم في هذه التحركات، سواء في مظاهرة يوم 8 أفريل التي كان مخططا لها، أو في المصادمات التي جرت في اليوم الموالي بفعل التجمع غير المبرمج أمام المحكمة الفرنسية في شارع باب بنات ومسارعة قوات حفظ النظام إلى إطلاق النار على المتظاهرين مما فجر المصادمات. وقد شكل الحضور الهام للشباب المتعلم في تلك الأحداث ضمانة لاستمرار المسار التحرري في الفترة الموالية حتى في غياب القيادات التاريخية للحركة الوطنية. أما الفئات الشابة غير المتعلمة والتي قدمت إلى مسرح الأحداث لتشارك في تأجيجها فقد كانت هي الأخرى مدفوعة برغبة جامحة في الانتقام من وضع غير عادل حكم عليها بالهامشية والفقر وقد اعتقدت أن الفرصة قد حانت لتصفية حساب قديم مع نظام الهيمنة الاستعماري.
قد تكون هذه المعطيات مشتركة في الواقع مع كل التحركات الجماهيرية ذات الطابع السياسي والاحتجاجي ليس في تاريخ تونس فحسب بل في تاريخ كل الحركات التحررية. غير أن هذه الأحداث، بفعل الشعارات التي رفعتها وخصوصية النضال الوطني الذي قاده الحزب الدستوري، تعبر عن بعد آخر مختلف عما نجده في معظم حركات التحرر. فقد كانت المطالبة ببرلمان تونسي أهم شعار رفعته الجماهير يوم 8 أفريل 1938، وكان ذلك تتويجا لحركة دستورية عريقة طالبت منذ ظهورها بإعادة العمل بدستور 1861 في تمسك واضح بفكرة أن الحماية لا يجب أن تتحول إلى نظام يقضي على سيادة الكيان التونسي.
كان مغزى المطالبة ببرلمان تونسي عميقا: ففي البرلمان يفترض أن يجتمع نواب الأمة الذين انتخبهم الشعب للدفاع عن مصالحه ولوضع حد للاستبداد وللحفاظ على علوية الشعب تجاه أية مرجعيات أخرى. وعلى مستوى آخر فقد كان البرلمان ضمانة لتأسيس نظام يضع كل سلطة في حجمها المفترض. غير أن البرلمان يمكن أن يكون تأسيسيا تقع على عاتقه مهمة صياغة دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد وينتج مشروعا جديدا للدولة، أو أن يكون برلمانا عاديا ينتخب وينشط في إطار دستور موجود. لم يرهق الوطنيون أنفسهم كثيرا في تحديث النموذج المراد إتباعه. كانوا يطالبون فحسب ببرلمان تونسي، وكانوا مصرين على وضع أنفسهم كتواصل للحركة الدستورية مثلما يشير إلى ذلك الاسم الذي اختاروه منذ 1920 لحركتهم. ذلك أن مجرد المطالبة ببرلمان تعني الاستناد إلى دستور أو إلى مشروع دستور، والمؤسستان ضمانة لسيادة الشعب في مواجهة الاستبداد سواء كان استعماريا أو غير ذلك. وفي المقابل فإن نظام الهيمنة الاستعمارية كان مقتنعا أن التنازل للوطنيين يعني بداية النهاية للمسار الاستعماري برمته، لأن الفرنسيين كانوا، بحكم تجربتهم التاريخية، يعرفون أكثر من غيرهم أن الإقرار بمبدأ السيادة الشعبية لا يمكن أن يؤدي سوى إلى وضع نهاية لنظام الاستبداد والمصالح والفئات التي يستند إليها.
لكن التجربة التونسية ستبين وجود إمكانية أخرى: برلمان ودستور واستبداد في الوقت نفسه. فقد نجح الزعيم بورقيبة، تسانده في ذلك نخبة من الوطنيين المؤمنين به وبالوطن، في وضع الأسس لنظام رئاسوي ضخم من صلاحيات السلطة التنفيذية وجعل بقية السلطات في وضع غلب عليه الضعف وغياب الاستقلالية. وسبب ذلك أنه من وراء المؤسسات الجديدة، كالبرلمان والدستور، كانت النخبة التي أناطت بنفسها مهمة إنجاز الدولة الوطنية تعتبر أن الحزب الذي قاد عملية التحرر هو الممثل الحقيقي للسيادة الشعبية. من هنا فإن تنازل الشعب عن "سيادته" لا يتم لصالح المؤسسات الحديثة مثل البرلمان، بل في إطار تلك المؤسسات لصالح "حزب الأمة" الذي يصبح بإمكانه الحصول على أداة شرعية لاتخاذ القرار. كما أن انتشار الأمية وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يجعل من غير الصائب في نظر تلك النخبة الوثوق بقدرة الجماهير على الاختيار السليم في نظام ديمقراطي عادي. وهكذا أصبح تخلف الوضع الاجتماعي مبررا في يد النخبة الوطنية الحاكمة لعدم العودة للإرادة الشعبية واعتبار الشعب قاصرا إلى ما لا نهاية، وعوضا عن أن تكون سيطرة الدولة الوطنية مقدمة لتحديث عميق للممارسة السياسية في إطار المؤسسات الحديثة، تصاعدت الممارسة الاستبدادية للدولة مما يثير التساؤل عن الغاية من خلق المؤسسات الجديدة ومن تأسيس نظام على النمط الجمهوري.
هل حقق التونسيون والدستوريون منهم بالخصوص ما أرادوه عندما رفعوا شعار "برلمان تونسي" في أفريل 1938 ؟ لقد عادت النخبة الوطنية التي وصلت السلطة بعد كفاح مرير ضد الحضور الاستعماري إلى مربع البداية، وبعد أن قاومت ذلك الحضور من منطلق بلوغ التونسيين الرشد وقدرتهم على تسيير شؤونهم بنفسهم، اعتمدت منطقا عكسيا فبدأتا بالتشكيك في نضج الشعب وفي قدرته على التعامل مع المؤسسات الحديثة وفي تحمل تبعات الممارسة الديمقراطية. وبعد أن كان البرلمان والدستور مطلبا شعبيا أمكن للوطنيين بواسطته تكتيل جانب كبير من الأمة خلفهم، أصبحا تعبيرا عن طموحات النخبة وإستراتيجيتها في السيطرة على المجتمع.
يكاد يكون مسلما به أن تونس أضاعت من البداية فرصة بناء دولة حديثة تقوم على مؤسسات فاعلة ومستقلة عن الأحزاب والأهواء والمصالح. لذلك فإن آفاق أي تطور تبقى محكومة بالضيق ما لم يعد الجميع التفكير في المنطلقات: ما هي الحداثة التي نريد؟ وما هي الغاية من كل عمل بما في ذلك التحديث؟ وكيف تنظر النخبة إلى دورها في مجتمع يتوق إلى تحقيق إنسانيته؟ سيؤدي ذلك حتما إلى إعادة تقييم نصف قرن من تجربة الدولة في تونس. فما بدا تحديثا قد لا يتجاوز القشرة الخارجية، أما اللب فبقي فيما يبدو مستعصيا. وطيلة نصف قرن من الزمان، وهي فترة ليست بالقصيرة مثلما قد يتوهم البعض، كانت الدولة تدعي الحداثة وتمارس نقيضها، تزعم بناء مؤسسات الحداثة وتعرقل نموها، تمتدح نضج الرعية وتغتال عقلها. لقد أضحت الحداثة، بهذا المنطق، مجرد إيديولوجيا للحكم وخطابا لا يقنع ولا يغني من جوع. وفي المقابل فإن عملا بطيئا وعميقا ومؤثرا لم يسنح له أن يبدأ: ترسيخ فكرة المواطنة، والتربية على احترام الاختلاف في الرأي، وتعميق فكرة أن الإنسان غاية كل مجهود وأن الإنسانية هدف كل فرد. أن يصبح الإنسان مؤسسة والرأي الحر مؤسسة واحترام الآخر مؤسسة، هو المسار الذي يمكن أن يبني مؤسسات حقيقية، مؤسسات للمجتمع وليس للدولة، فتلك ضمانة لهذه وهي، فوق ذلك، أهم وأكثر دواما.
هل وجد التونسيون ما وعدهم زعماؤهم حقا؟
تمر هذا الأسبوع الذكرى التاسعة والستون لأحداث 8 و 9 أفريل 1938 التي شهدتها بلادنا والتي شكلت مفصلا هاما في مسيرتها التحررية. فانطلاقا من يوم 7 أفريل شهدت مختلف مناطق القطر تنظيم مظاهرات جماهيرية أطرها الحزب الدستوري الجديد للمطالبة ببرلمان تونسي، وقد عرفت هذه التحركات أوجه جماهيريتها بتونس العاصمة في اليوم الموالي عندما خرجت مظاهرتان ضخمتان التقتا أمام مبنى السفارة الفرنسية بوسط العاصمة في تحد واضح لسياسة التضييق الاستعمارية على الوطنيين.
وفي الحقيقة فإن هذه الأحداث شكلت تتويجا لمسار طويل من التعبئة السياسية للجماهير كنتاج لفشل المسار التفاوضي الذي شرعت فيه الحركة الوطنية تحت قيادة الحزب الدستوري الجديد منذ صعود الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا. وفي المقابل كانت أوساط التفوق الاستعماري تدفع في اتجاه حصول صدام بين السلطة والوطنيين من أجل وضع نهاية لمسار تحرري بدا أنه يتجه نحو تهديد المصالح التي يقوم عليها النسق الاستعماري. إن صراع هذين الاتجاهين هو ما أدى إلى اندلاع مصادمات اليوم التالي، يوم 9 أفريل 1938، عندما سرت إشاعة (كان يعوزها المنطق) بإعدام علي البلهوان الذي كان يعتبر، بفعل حماسه الوطني واتساع تأثيره على الشباب المدرسي وخطاباته الملتهبة، محرك تلك الأحداث. من هنا، وفي إطار تلك الظرفية الخاصة من التوتر السياسي والتعبئة الكاملة، لم يكن هناك بد من وقوع ما وقع: سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين قوات حفظ النظام والتونسيين. غير أنه تجدر الإشارة من ناحية أخرى إلى أن كل طرف حصل في نهاية الأمر على النتيجة التي كان يرومها: فمن ناحية القيادة الوطنية تم إثبات جماهيرية الحزب الدستوري الجديد وقدرته على التجييش والتعبئة واستعداد مناضليه الكثر إلى ولوج أشكال غير متوقعة من التحرك السياسي. أما الأوساط الاستعمارية فقد تحصلت على الذريعة التي ستحسن استغلالها للشروع في عملية قضاء منهجي على الحركة الوطنية التونسية عن طريق اعتقال القيادات الدستورية والمحاصرة الصارمة للعمل الوطني والشروع في عملية إعادة الاعتبار لهيبة النظام الاستعماري.
غير أن تلك الأحداث عبرت من ناحية أخرى على دخول معطيات جديدة إلى الساحة السياسية الوطنية في هذه الفترة الحساسة من تطور المسار التحرري. وأول هذه المعطيات على الإطلاق أن العناصر الشابة شكلت، مثلما هو الشأن في كل التحركات الجماهيرية الكبرى، العمود الفقري للتحرك الوطني. وقد ألحت بعض المصادر على الدور الذي قام به تلاميذ المدرسة الصادقية وطلبة الجامع الأعظم في هذه التحركات، سواء في مظاهرة يوم 8 أفريل التي كان مخططا لها، أو في المصادمات التي جرت في اليوم الموالي بفعل التجمع غير المبرمج أمام المحكمة الفرنسية في شارع باب بنات ومسارعة قوات حفظ النظام إلى إطلاق النار على المتظاهرين مما فجر المصادمات. وقد شكل الحضور الهام للشباب المتعلم في تلك الأحداث ضمانة لاستمرار المسار التحرري في الفترة الموالية حتى في غياب القيادات التاريخية للحركة الوطنية. أما الفئات الشابة غير المتعلمة والتي قدمت إلى مسرح الأحداث لتشارك في تأجيجها فقد كانت هي الأخرى مدفوعة برغبة جامحة في الانتقام من وضع غير عادل حكم عليها بالهامشية والفقر وقد اعتقدت أن الفرصة قد حانت لتصفية حساب قديم مع نظام الهيمنة الاستعماري.
قد تكون هذه المعطيات مشتركة في الواقع مع كل التحركات الجماهيرية ذات الطابع السياسي والاحتجاجي ليس في تاريخ تونس فحسب بل في تاريخ كل الحركات التحررية. غير أن هذه الأحداث، بفعل الشعارات التي رفعتها وخصوصية النضال الوطني الذي قاده الحزب الدستوري، تعبر عن بعد آخر مختلف عما نجده في معظم حركات التحرر. فقد كانت المطالبة ببرلمان تونسي أهم شعار رفعته الجماهير يوم 8 أفريل 1938، وكان ذلك تتويجا لحركة دستورية عريقة طالبت منذ ظهورها بإعادة العمل بدستور 1861 في تمسك واضح بفكرة أن الحماية لا يجب أن تتحول إلى نظام يقضي على سيادة الكيان التونسي.
كان مغزى المطالبة ببرلمان تونسي عميقا: ففي البرلمان يفترض أن يجتمع نواب الأمة الذين انتخبهم الشعب للدفاع عن مصالحه ولوضع حد للاستبداد وللحفاظ على علوية الشعب تجاه أية مرجعيات أخرى. وعلى مستوى آخر فقد كان البرلمان ضمانة لتأسيس نظام يضع كل سلطة في حجمها المفترض. غير أن البرلمان يمكن أن يكون تأسيسيا تقع على عاتقه مهمة صياغة دستور ينظم الحياة السياسية في البلاد وينتج مشروعا جديدا للدولة، أو أن يكون برلمانا عاديا ينتخب وينشط في إطار دستور موجود. لم يرهق الوطنيون أنفسهم كثيرا في تحديث النموذج المراد إتباعه. كانوا يطالبون فحسب ببرلمان تونسي، وكانوا مصرين على وضع أنفسهم كتواصل للحركة الدستورية مثلما يشير إلى ذلك الاسم الذي اختاروه منذ 1920 لحركتهم. ذلك أن مجرد المطالبة ببرلمان تعني الاستناد إلى دستور أو إلى مشروع دستور، والمؤسستان ضمانة لسيادة الشعب في مواجهة الاستبداد سواء كان استعماريا أو غير ذلك. وفي المقابل فإن نظام الهيمنة الاستعمارية كان مقتنعا أن التنازل للوطنيين يعني بداية النهاية للمسار الاستعماري برمته، لأن الفرنسيين كانوا، بحكم تجربتهم التاريخية، يعرفون أكثر من غيرهم أن الإقرار بمبدأ السيادة الشعبية لا يمكن أن يؤدي سوى إلى وضع نهاية لنظام الاستبداد والمصالح والفئات التي يستند إليها.
لكن التجربة التونسية ستبين وجود إمكانية أخرى: برلمان ودستور واستبداد في الوقت نفسه. فقد نجح الزعيم بورقيبة، تسانده في ذلك نخبة من الوطنيين المؤمنين به وبالوطن، في وضع الأسس لنظام رئاسوي ضخم من صلاحيات السلطة التنفيذية وجعل بقية السلطات في وضع غلب عليه الضعف وغياب الاستقلالية. وسبب ذلك أنه من وراء المؤسسات الجديدة، كالبرلمان والدستور، كانت النخبة التي أناطت بنفسها مهمة إنجاز الدولة الوطنية تعتبر أن الحزب الذي قاد عملية التحرر هو الممثل الحقيقي للسيادة الشعبية. من هنا فإن تنازل الشعب عن "سيادته" لا يتم لصالح المؤسسات الحديثة مثل البرلمان، بل في إطار تلك المؤسسات لصالح "حزب الأمة" الذي يصبح بإمكانه الحصول على أداة شرعية لاتخاذ القرار. كما أن انتشار الأمية وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي، يجعل من غير الصائب في نظر تلك النخبة الوثوق بقدرة الجماهير على الاختيار السليم في نظام ديمقراطي عادي. وهكذا أصبح تخلف الوضع الاجتماعي مبررا في يد النخبة الوطنية الحاكمة لعدم العودة للإرادة الشعبية واعتبار الشعب قاصرا إلى ما لا نهاية، وعوضا عن أن تكون سيطرة الدولة الوطنية مقدمة لتحديث عميق للممارسة السياسية في إطار المؤسسات الحديثة، تصاعدت الممارسة الاستبدادية للدولة مما يثير التساؤل عن الغاية من خلق المؤسسات الجديدة ومن تأسيس نظام على النمط الجمهوري.
هل حقق التونسيون والدستوريون منهم بالخصوص ما أرادوه عندما رفعوا شعار "برلمان تونسي" في أفريل 1938 ؟ لقد عادت النخبة الوطنية التي وصلت السلطة بعد كفاح مرير ضد الحضور الاستعماري إلى مربع البداية، وبعد أن قاومت ذلك الحضور من منطلق بلوغ التونسيين الرشد وقدرتهم على تسيير شؤونهم بنفسهم، اعتمدت منطقا عكسيا فبدأتا بالتشكيك في نضج الشعب وفي قدرته على التعامل مع المؤسسات الحديثة وفي تحمل تبعات الممارسة الديمقراطية. وبعد أن كان البرلمان والدستور مطلبا شعبيا أمكن للوطنيين بواسطته تكتيل جانب كبير من الأمة خلفهم، أصبحا تعبيرا عن طموحات النخبة وإستراتيجيتها في السيطرة على المجتمع.
يكاد يكون مسلما به أن تونس أضاعت من البداية فرصة بناء دولة حديثة تقوم على مؤسسات فاعلة ومستقلة عن الأحزاب والأهواء والمصالح. لذلك فإن آفاق أي تطور تبقى محكومة بالضيق ما لم يعد الجميع التفكير في المنطلقات: ما هي الحداثة التي نريد؟ وما هي الغاية من كل عمل بما في ذلك التحديث؟ وكيف تنظر النخبة إلى دورها في مجتمع يتوق إلى تحقيق إنسانيته؟ سيؤدي ذلك حتما إلى إعادة تقييم نصف قرن من تجربة الدولة في تونس. فما بدا تحديثا قد لا يتجاوز القشرة الخارجية، أما اللب فبقي فيما يبدو مستعصيا. وطيلة نصف قرن من الزمان، وهي فترة ليست بالقصيرة مثلما قد يتوهم البعض، كانت الدولة تدعي الحداثة وتمارس نقيضها، تزعم بناء مؤسسات الحداثة وتعرقل نموها، تمتدح نضج الرعية وتغتال عقلها. لقد أضحت الحداثة، بهذا المنطق، مجرد إيديولوجيا للحكم وخطابا لا يقنع ولا يغني من جوع. وفي المقابل فإن عملا بطيئا وعميقا ومؤثرا لم يسنح له أن يبدأ: ترسيخ فكرة المواطنة، والتربية على احترام الاختلاف في الرأي، وتعميق فكرة أن الإنسان غاية كل مجهود وأن الإنسانية هدف كل فرد. أن يصبح الإنسان مؤسسة والرأي الحر مؤسسة واحترام الآخر مؤسسة، هو المسار الذي يمكن أن يبني مؤسسات حقيقية، مؤسسات للمجتمع وليس للدولة، فتلك ضمانة لهذه وهي، فوق ذلك، أهم وأكثر دواما.
Inscription à :
Commentaires (Atom)