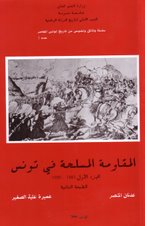ديمقراطية الفتوى
عدنان المنصر
مقال صادر بصحيفة الموقف التونسية بتاريخ 25 أفريل 2009
لعل المتابع للساحة الإسلامية يلاحظ منذ بعض الوقت شيوع ممارسة جديدة يبدو أن الإنفجار الإعلامي الذي نشهده منذ عشرية على الأقل قد شجع عليه: لقد أصبح المفاتي في كل مكان.حتما هناك حاجة للإفتاء، وهي حاجة ملحة أحيانا لكثير من المسلمين الذين عادة ما يتوجهون إلى علماء الشريعة بأسئلة محددة يطلبون إجابات واضحة عليها بما يسمح لهم بتحقيق حالة معينة من التوازن بين ضرورات الحياة المعاصرة ومقتضيات التمسك بالتعاليم الإسلامية المنظمة للعبادات والمعاملات.
لقد أصبح الإفتاء ظاهرة مثيرة للإنتباه منذ وقت غير بعيد. ورغم أن الممارسة قديمة قدم الإسلام نفسه فإن تحولها إلى ظاهرة ملفتة إنما يبدو رهين تطور وسائل الإتصال الحديثة التي أصبح بمقدورها ليس نشر نصوص الفتاوى فحسب وإنما أيضا ربط صلة مباشرة بين المفتي والمستفتي بما يحقق نوعا من "ديمقراطية الفتوى". يمكن اليوم أن يلقي المستفتي بسؤاله إلى الشيخ عبر موقعه الإلكتروني، وكثير من المشايخ قد دخلوا بعد عصر الكمبيوتر على الأقل كأداة نشر، أو برفع سماعة الهاتف والإتصال بالمشايخ الذين أصبحوا يملؤون علينا الشاشات و"يبدعون" في إيجاد الحلول، سعيدها وشقيها، للمسلمين الحائرين. لا نناقش في هذا المقال جدوى الفتوى من عدمها، فالمسألة وإن لم تكن فقهية فحسب فإنها تحقق استجابة لدى حاجة واقعية لقسم كبير من الناس. ما سنحاول تناوله بالخصوص يتعلق بجدوى ومغزى اتجاه معين في الإفتاء نعتقد أنه يرمي إلى تحقيق حاجات بعيدة عن المشاغل الفقهية الحقيقية للمسلمين ويحول "مؤسسة الإفتاء" إلى خادم أمين وطيع في يد مراكز قوى بعينها لا يهمها الفقه ولا الشرع ولا الإسلام بقدر ما يهمها استغلال ذلك كله وما يسمح به من سيطرة على مجموع الناس المعنيين به من أجل السيطرة على مساحة واسعة في الوعي الجمعي.
والحقيقة أن ما نعني به من عبارة "مراكز قوى" يتجاوز الحكومات والأنظمة ليصل إلى كل الهياكل القادرة على بلورة فهم معين للإسلام يحقق لها فائدة مباشرة، سواء كانت تلك الفائدة سياسية، إقتصادية أو حتى معنوية. لم تعد مهمة المفتي سهلة فيما يبدو، بل لعلها لم تكن كذلك أبدا. فهو تحت ضغط دائم ليس من جانب عامة الناس فقط وإنما من تلك المراكز التي تتوجه إليه في مناسبات معينة، من أجل الحصول على غطاء شرعي لقرار اتخذ أو يهيأ لاتخاذه. يذكر الجميع تجربة بورقيبة في هذا الشأن، عندما حاول الحصول على موافقة رجال الشرع، وبخاصة "مفتي الجمهورية" آنذاك على بعض اجتهاداته، وكان ذلك بمناسبة إصلاح الأحوال الشخصية ولاحقا مسألة صوم رمضان للعمال. لمثل تلك الحاجات تقع العودة إلى المفتي، ولمثل تلك الحاجات وجد المفتي أصلا. فالمفتي بهذه الصيغة، صيغة اسم الفاعل، إنما هو موظف كغيره من موظفي الدولة، غير أن مجال اختصاصه مختلف عن بقية الموظفين. لعل المفتي ظهر عندما تبين للدول أن البراغماتية السياسية تقتضي منها إنهاء حالة معينة من "فوضى الإفتاء" التي كانت تجعل من كل المتفقهين، ومن غيرهم، يعتقدون أن بإمكانهم إصدار نصوص فتوى. كانت هناك حاجة لمأسسة الممارسة فظهر المفتي. ولا يهم إن كانت الدولة هي من يوظف المفتي أو أن مؤسسة أخرى، تقع هي ذاتها تحت سيطرة تلك الدولة مثلما هو حال المفتي في بعض بلدان المشرق (الأوقاف)، فالأمر يبدو من هذه الناحية شكليا طالما أن التوظيف يعني إمكانية العزل ودفع الرواتب. ولو عدنا إلى التجربة التونسية لرأينا أن بورقيبة لم يحدث منصب مفتي الجمهورية إلا لتجاوز المعارضة التي لقيتها إصلاحات الأحوال الشخصية، حيث عبر بصراحته المعهودة على طبيعة المهمة المنتظرة من "الممثل الرسمي للإسلام" في تونس.
هكذا إذا فقد كان تركيز الإفتاء كمؤسسة رسمية مرحلة ضرورية في المسيرة نحو تطويع الممارسة التشريعية الدينية وربطها بحاجات الدولة. يظهر ذلك بوضوح كبير اليوم، في كثير من بلاد عالمنا العربي الإسلامي. بل لعل بعض البلدان تضم بالإضافة إلى المفتي موظفين دينيين آخرين لا يقلون عنه نفوذا. فنجد على سبيل المثال أن أكبر وظيفتين دينيتين في مصر هما شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، ويكفي أن يستذكر إسما الرجلين ليفهم الدور الحقيقي الذي يطلب من مثلهما أداءه عادة. أما في المملكة السعودية فإن رئيس هيئة كبار العلماء ومفتي المملكة هو الممثل الرسمي للمؤسسة الدينية، وتعتبر فتاويه أعلى قيمة نظريا من بقية الفتاوى.
إن ما ينبغي التأكيد عليه هنا أنه لا حدود للخدمات التي يمكن أن يقدمها المفتي الرسمي لسلطة محرجة في مجتمع متدين. يمكن العودة إلى ظرفية غزو العراق الأول وسنرى عدد الفتاوي التي صدرت عن ممثلي الإسلام الرسمي في "جواز الإستعانة بالكافر على المسلم الباغي"، وإلى ظرفية اتفاقية كامب دافيد لنلاحظ "الإجتهادات" والقياسات الطريفة عندما أصبحت تلك الإتفاقية شبيهة بصلح الحديبية (يفترض ضمنا أن السادات يعوض، هنا، الرسول). كما يمكن الإطلاع على بعض مواقف نفس الدول من حرب لبنان (2006) والعدوان الأخير على غزة من خلال الفتاوي الرسمية التي صدرت إبانهما، فقد أفتى أحدهم بعدم جواز الدعاء بالنصر لحزب الله، باعتباره من "الشيعة الروافض المارقين عن الدين القويم"، كما أفتى آخر بأن التظاهر من أجل نصرة غزة إنما هو من قبيل الإفساد في الأرض وشغل المسلمين عن أعمالهم، وأخيرا صدرت عن نفس الأوساط فتوى تعتبر "الجهاد الإلكتروني" ضد المواقع الأمريكية والصهيونية على شبكة الأنترنت غير جائز شرعا. لقد أنستنا تلك الإبداعات فتوى الرضاع !
وبقدر ما تعبر تلك "الإجتهادات" عن حد أدنى من البراغماتية (بغض النظر عن "عقلانية" المسلك) فإن بإمكانها أن تعبر أيضا على أقصى درجات الإنغلاق، والمسلكان، على عكس ما يبدو عليه الأمر، متوازيان تماما. نذكر في هذا الإطار "إبداعين" يدلان على حرص أكيد لدى مؤسسة الفتوى، أحيانا وفي بعض البلاد، على الدخول في أدق الخصوصيات الفردية التي لا نعتقد، مع إقرارنا بعدم امتلاكنا لما يعادل قدرة أساطينها على "التفكير السليم"، أنها تتناقض مع السلوك الشرعي. تتعلق الأولى بتحريم الإحتفال بعيد الحب Saint-Valentin من منطلق أنها عادة نصرانية وأن "من تشبه بقوم فهو منهم"، وتغافلا عن مبدأ "تهادوا تحابوا". أي منطق يجعل الإسلام عدوا للحب مترصدا له؟ أما الفتوى الثانية فقد تفتقت عنها قريحة أخرى اعتقدت أن ممارسة العلاقة الزوجية دون ملابس يجعل العلاقة الزوجية غير شرعية.كم وددنا أن يعلمنا سماحته كيف نفعل ذلك بكامل ملابسنا ! تحضرنا في نفس السياق فتوى "على الهواء" بضرورة إنفاذ قسم الطلاق لمجرد أن الزوجة لم تحضر للزوج المتقدم بالإستفسار كوبا من الماء بنفسها متحدية قسمه ومرسلة بالكوب مع أحد أبنائها. بدا الرجل نادما متحرجا، ولكن سيف المفتي سبق عذل المستفتي. كم نرثي لذلك الرجل الذي قد يكون طلق زوجته من أجل كوب ماء، وكم نرثي له حتى وإن لم يطلقها، لأنه ربما كان يعيش على وهم ذنب عظيم لم يرتكبه، غير أن رثاءنا الأكبر يتوجه إلى من يفترض أن يكون أحرص الناس على نشر قيم الحب والعدل والعطف، ماذا عساه يبقى من الإسلام إذا ذهب كل ذلك ؟
هل ندين بنفس الإسلام؟ هل نقدر الحياة الزوجية والعائلة بالقدر نفسه؟ هل نملك نفس المشاعر؟ كم تبدو مريرة تلك الأسئلة التي تنتابنا من حين لآخر فتعكر، على الأقل، صفو نفوسنا وتزيد الإسلام غربة على غربته. قد يحتج العض بأن الحالات المذكورة شاذة من النوع الذي يحفظ، غير أن ما نراه رأي العين هو ذلك المسار المخيف الذي اتفق أنه في زمن ما حول المسيحية من ديانة رقيقة تقوم على شعور متعال بالذات الإنسانية إلى أقسى المعتقدات وأكثرها قهرا لمعتنقيها. كم هي بشعة تلك الصور التي تنتشر هنا وهناك عن عمليات الرجم الجماعي لبعض النساء بشبهة الزنا في العراق وغيره، غير أن الأبشع هو تحول الإسلام إلى ذريعة لوحشية الدهماء المستفزة. كم هي مؤلمة صور قطع الأيدي والأطراف بدعوى تطبيق أحكام الشريعة، غير أن الأكثر إيلاما هو تحول الإسلام من دين رحمة ومحبة إلى دين حدود لا يقتص سوى من المساكين.
لا يجب أن نسغرب بعد ذلك أن ينتشر إستعمال الفتوى خارج مجال سيطرة الدولة ويصبح أداة في يد الجماعات المتطرفة المسلحة، ذلك أن المنطق الكامن وراء السلوكين هو نفسه. هناك حاجة إلى تقنين التعليمة الدينية ومركزتها واستغلالها من طرف دولة أو مشروع دولة. ولكن في المقابل هناك قبول كبير لدى مجموع المحكومين بذلك طالما كان العنوان هو "تطبيق الشريعة". من الجانبين، لا يبدو أن الوضع يبرر، لسوء الحظ، أي إحساس إشكالي. ما ينسى، في خضم ذلك كله، أن الإسلام رحمة ومحبة، وأن الله لا يمكن أن يحتكر أو يسجن، وأن ما يقال لا يغني عن فهم ما يراد وما يحدث.