مزالي ينشر مذكراته:
عندما تصاب الدولة بمرض باركنسون
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 27 أفريل 2007
عندما تصاب الدولة بمرض باركنسون
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 27 أفريل 2007
عدنان المنصر
"هذا الكتاب مزج سيرتي الذاتية بمحطات رحلتي الإنسانية، أكدت من خلالها نظرياتي وقناعاتي والصراع الذي لم يهدأ في أعمق أعماقي بين الإيمان والفعل، إنه يندرج إذن في صلب تواصل عملي النضالي من أجل تونس، من أجل الإنسان، وهو بمثابة المرحلة الختامية لحياتي". هكذا صدر الوزير الأول التونسي الأسبق محمد مزالي النسخة العربية من مذكراته التي صدرت منذ بضعة أسابيع تحت عنوان "نصيي من الحقيقة" عن دار الشروق المصرية بحجم تجاوز الستمائة صفحة من القطع المتوسط. وهذا النص وإن كان في معظمه تعريبا للنسخة الفرنسية الصادرة في وقت سابق بفرنسا فإن صاحبها قد أدخل عليها بعض الإضافات وضمنها وثائق وشهادات.
وقارئ النص العربي يجد في لغته وأسلوبه من السلاسة والعذوبة ما يذكره بأن صاحبه أديب وفيلسوف قبل أن يكون سياسيا وهو أمر يؤكده في مقدمة نصه عندما يعرض إلى علاقته بالكتابة. غير أن مزالي لا يكتب هنا لمجرد المتعة، فقد أراد من نصه غايتين تتضحان لكل من يقرأه. فقد سعى في البداية إلى تقديم شهادة عن الفترة التي ارتبطت فيها حياته بالمسؤولية السياسية منذ فجر الاستقلال، وفي خضم ذلك يقدم صورة لطبيعة سير الدولة وطريقة اتخاذ القرار في العهد البورقيبي، كما يوضح انجازاته الشخصية في مختلف مواقع المسؤولية، من وزارة التربية إلى وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع إلى الشباب والرياضة إلى الإعلام وأخيرا الوزارة الأولى. أما الغرض الثاني الذي من أجله كتب هذه المذكرات فهو الدفاع عن نفسه إزاء ما تعرض له من تشويه وهجوم غير مبرر حاول خصومه من خلاله إلغاء دوره وتاريخه، وهنا يأخذ النص مسحة مختلفة تماما. من هنا فإن الكتاب لا يقدم لقارئه مزالي السياسي فحسب بل أيضا مزالي الإنسان الذي يبدي ألمه لما يعتقد أنه ظلم وقع عليه، وقد خصص جزءا كبيرا من مذكراته لرد "الاتهامات" ودحض "الافتراءات" رغم تأكيده في بداية النص "عدم حاجته إلى الدفاع عن صدق وطنيته وأصالة كفاحه السياسي والثقافي أمام أصحاب الذاكرة المثقوبة ولا التدليل على استقامته وبراءته إزاء الإشاعات الفجة والأكاذيب السمجة والاتهامات الباطلة التي لا تستحق سوى السخرية" (ص 14) انطلاقا من مقولة أن "من عرف نفسه لا يضيره ما قاله بعض الناس فيه".
قسم محمد مزالي مذكراته إلى فصول خمسة تناول فيها مسيرته السياسية التي دامت أكثر من 30 عاما، حيث يمكن القول أنه عاصر عملية ناء الدولة وكل تجاربها وتحولاتها وأزماتها إلى حدود إعفائه من مهام الوزارة الأولى في 1986. من هنا فإن قربه من دوائر صنع القرار طيلة جانب من هذه المسيرة بل ومشاركته الفعلية في صياغة السياسة الحكومية طيلة القسم الأكبر منها يجعل من شهادته ذات قيمة خاصة لكل من أراد دراسة تاريخ دولة الاستقلال. وبالفعل فإن الكاتب يتوجه بشهادته إلى "المؤرخين الذين ستؤهلهم أمانتهم العلمية لمزيد البحث الموضوعي والتنقيب العلمي قصد إعطاء صورة ناصعة، وفية، لتاريخ تونس منذ الإستقلال" (ص15).
غير أن متن الكتاب لا يؤكد أن هذه الصورة المراد رسمها لدولة الاستقلال كانت دائما ناصعة، وهذا لا يمس في شيء من صدق النوايا والرغبة في تحقيق ازدهار الشعب التونسي وتحقيق نهضته التي كانت تحدو مؤسسي الدولة الوطنية في تونس. فقد تراجعت النوايا الطيبة أمام ضغوطات مراكز القوى داخل القصر وفي دوائر الحكم وسرعان ما أفسح المجال لصراع أجنحة داخل الدولة عطل اضطلاعها بمهامها الأصلية. هذا الصراع لم يكن يجد تبريره سوى في رغبة الاستئثار بالمواقع القريبة من الصانع الحقيقي لسياسة الدولة وهو الزعيم بورقيبة الذي أتقن بفعالية التحكم في تلك الصراعات وطوعها إلى حد كبير لمصلحة سلطته الشخصية.
قد يكون ذلك مقبولا في بعض أنظمة الحكم وربما في أغلبها، غير أن "النموذج التونسي" كان قد تفتق على بدعة قل العثور عن شبيه لها من ناحية الفعالية وشدة التأثير. هذه البدعة كانت شجرة الدر الجديدة، "الماجدة" زوجة الرئيس التي كانت تحكم البلاد من خلف ستار، متقنة كافة أساليب الاستقطاب داخل أوساط الحكومة ومكونة قطبها الخاص. كان "حزب الماجدة" كبيرا وقوي التأثير. وربما تعارض أحيانا مع "حزب الرئيس"، ولا غرابة في ذلك فقد ذكر أحد رموز المعارضة الديمقراطية في عهد بورقيبة أن "المعارضة الحقيقية لبورقيبة موجودة في فراشه". وفي مذكرات مزالي شهادة على هذا الواقع الذي زاد استفحالا مع تقدم بورقيبة في السن. ولعل أهم مناسبتين يوردهما مزالي في هذا الاتجاه هو أن أكبر الأحداث التي شهدتها تونس في تاريخها القريب قد وقعت نتيجة مؤامرة حبكت "الماجدة" خيوطها واستهدفت في كل مرة الوزير الأول (نويرة في جانفي 1978 ومزالي في 1984) الذي كان بوصفه دستوريا الخليفة المحتمل لرئيس الدولة، يتلقى كل السهام وتحبك لتحطيمه كل "المؤامرات". ربما أضاءت هذه الشهادة جانبا من الحقيقة غير أنها تبقى قاصرة عن تفسير تلك الأحداث. فأحداث "الخميس الأسود" في 26 جانفي 1978 وقعت لأن كل الظروف كانت تنبئ بوقوعها ولم يكن من الممكن في ظننا منعها. ربما كان عاشور بالفعل عضوا في "حزب الماجدة"، ولكنه ما كان ليجر وراءه كل النقابيين والشغالين لو أن هدفه كان يتلخص فحسب في الإطاحة بنويرة. كذلك الأمر بالنسبة لأحداث الخبز، فربما سهلت انفجارها كما يؤكد مزالي "مؤامرة" نسجت خيوطها بإحكام لكنها ما كانت لتقع لو أن الشعب كان راضيا عن النظام الذي يحكمه. لقد كان الحاكمون يعرفون حقيقة ما يعتمل داخل المجتمع من نقمة على سياسات لم تحقق طموحات شرائح واسعة في حياة كريمة، فسعى بعضهم إلى الاستفادة من تلك الطاقة الهائلة لتصفية حسابات ضيقة لا تكاد آفاقها تتجاوز أسوار القصر. وفي المناسبتين انتفض ذلك المارد ليفرض نفسه في واقع لم يكن يحقق فيه الإنسان إنسانيته برغم أساليب الدعاية والتعمية التي سخر لها النظام كل قدراته. إن المسألة، كما لا يوضحها صاحب المذكرات، مسألة انفصام عميق في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ذلك الانفصام الذي أدى إلى غربة ثم إلى تنافر ثم إلى تحين كليهما الفرصة للانقضاض على الآخر. وفي المناسبتين كانت الكلمة الأخيرة للحاكمين الذين لم يفوتوا فرصتهم لترسيخ عبودية الجماهير بقمع طال الأخضر واليابس. من هنا فإن حصر المسألة برمتها في مقولة "المؤامرة" يبقى قاصرا عن تفسير العمق الحقيقي لذلك الصراع وإن مكن في نهاية الأمر من توضيح بعض جوانبه.
والمتمعن في مذكرات مزالي يلاحظ أن الكاتب يضع نفسه كتواصل لسياسات الذين تقلدا منصب الوزير الأول من قبله، الباهي الأدغم والهادي نويرة. وهو لا يجد حرجا في الاعتراف لهما بالفضل على مسيرة التنمية الاقتصادية وعلى مشروع بناء الدولة، وهذا الموقف في حد ذاته موجب للاحترام حيث أننا تعودنا من كتاب المذكرات من كبار رجال الدولة ذلك المسعى المرضي لنسف إنجازات أسلافهم ومحاولة السطو على ما حققوه للبلاد وهو وجه آخر من وجوه العلاقة بين عناصر نخبة الدولة. غير أننا نفهم من ذلك أيضا أن محمد مزالي قد نظر دائما إلى دوره السياسي كمكمل لدور عناصر أخرى سبقته أو عاصرته في العمل الحكومي تحت قيادة بورقيبة. كما أن مزالي يحتفظ باحترام شديد للزعيم بورقيبة وهو من هذه الناحية أيضا يقطع مع تلك الممارسة التي تتمثل في التحمس لتسديد الطعنات كلما كانت "الضحية" عاجزة عن الرد.
وهنا لب القضية في نظرنا. فمزالي كان جزءا من نظام، وبغض النظر عن سعيه لتقديم ممارسة مختلفة للشأن العام، فإن ذلك كان عاجزا عن تحقيق تحول فعلي في مسيرة ذلك النظام. ذلك أن القرار لم يكن له، كما لم يكن لغيره مهما علت مرتبته في سلم الدولة. ومرد ذلك في الحقيقة إلى تحول النظام من نظام مصغ لصوت شعبه ساع لخدمته برغم ما وقع من أخطاء، إلى نظام همه الوحيد الإبقاء على سيطرته على المجتمع وإن أخل بأهم مقومات العقد الاجتماعي. ذلك ما نفهمه من التجربة الديمقراطية التي دشنها مزالي في 1981 والتي قتلت في مهدها لأن النظام تهيأ له أن تلك كانت بداية النهاية بالنسبة إليه وبخاصة بالنسبة لأصحاب المصالح في بقائه منغلقا على نفسه ومنعزلا عن الجماهير.
هل كان النظام عاجزا بالفعل عن انتهاز تلك الفرصة التي قدمها له مزالي لتجديد نفسه وبناء شرعية جديدة تمنحه نفسا جديدا؟ لقد كان عاجزا عن ذلك ليس لقصور في إدراك مراكز القوى لمصلحتها الحقيقية من تغيير تدريجي وسلمي لا يفقدها سيطرتها على الوضع، بل لأن بعض عناصرها كانت تتصرف بغير حرص على مصلحة النظام العامة. من هنا فإن الإشكال الحقيقي ليس في عدم حرص تلك المراكز على مصلحة الشعب أو مصلحة الدولة، لأن ذلك كان معلوما للسواد الأعظم، بل في عدم حرصها على مصلحة النظام التي كانت تقتضي انفتاحا مدروسا يقيه غائلة التحركات العنيفة. وهذا يعيدنا إلى الطبيعة الارتجالية لصنع القرار التي اتضحت في العشرية الأخيرة من حكم بورقيبة والتي لا ينبغي تبريرها بتقدمه في السن فحسب. فالمسألة تعود في نظرنا إلى عامل هيكلي يتمثل في الطبيعة الرئاسوية للنظام من ناحية، وإلى فشل مسار بناء مؤسسات قادرة على تصويب أخطاء السلطة التنفيذية. من هنا فلا مزالي ولا غيره كان قادرا على تحقيق تحول جذري في طبيعة النظام، ذلك أن مراكز القوى كانت ترى في أي تغيير مهما بدا بسيطا خطرا يهددها مباشرة. ذلك أن بناء مؤسسات حقيقية يعني فقدان تلك المراكز لغاية وجودها. فما هي المكانة الحقيقية التي يعطيها دستور دولة، مهما بلغت العبثية، لزوجة الزعيم حتى تغدو "الماجدة" صاحبة القول الفصل في تعيين الوزير الأول أو عزله؟ وأي نظام يشرف فيه وزير الداخلية (1981)على تزوير إرادة الشعب دون محاسبة أو عقاب؟ وأية دولة تلك التي تملأ الدنيا صراخا حول إصلاحات اجتماعية تجعل للطلاق ضوابط معلومة ثم يكون مؤسسها وبانيها أول من يخترقها؟
لا نشك أن مزالي وغيره كانوا مدركين لعمق الهوة التي تردى فيها مشروع الدولة في تونس، ولعلهم أرادوا تجديد شباب ذلك النظام بعد أن رأوا توغله في الاتجاه الخاطئ. فهم في نهاية الأمر تلك النخبة الشابة والمثقفة التي بنت على الاستقلال كل أحلامها في تأسيس مشروع وطني يعيد للشعب كرامته ويحقق فيه رشده السياسي.غير أن قوانين الهندسة، وليست قوانين السن والتهرم فحسب، أفشلت مساعي الصادقين منهم، ومضمونها أنك لا تستطيع إنجاز بناء صلب على أسس هاوية. وهكذا أدى تجاهل هذه القاعدة إلى إصابة كامل الدولة، وليس بورقيبة فحسب، بذلك المرض الذي يطلق عليه اسم مرض باركنسون، فبدا مرتعشا، متخشبا، فاقدا للإتزان ومكتئبا.
"هذا الكتاب مزج سيرتي الذاتية بمحطات رحلتي الإنسانية، أكدت من خلالها نظرياتي وقناعاتي والصراع الذي لم يهدأ في أعمق أعماقي بين الإيمان والفعل، إنه يندرج إذن في صلب تواصل عملي النضالي من أجل تونس، من أجل الإنسان، وهو بمثابة المرحلة الختامية لحياتي". هكذا صدر الوزير الأول التونسي الأسبق محمد مزالي النسخة العربية من مذكراته التي صدرت منذ بضعة أسابيع تحت عنوان "نصيي من الحقيقة" عن دار الشروق المصرية بحجم تجاوز الستمائة صفحة من القطع المتوسط. وهذا النص وإن كان في معظمه تعريبا للنسخة الفرنسية الصادرة في وقت سابق بفرنسا فإن صاحبها قد أدخل عليها بعض الإضافات وضمنها وثائق وشهادات.
وقارئ النص العربي يجد في لغته وأسلوبه من السلاسة والعذوبة ما يذكره بأن صاحبه أديب وفيلسوف قبل أن يكون سياسيا وهو أمر يؤكده في مقدمة نصه عندما يعرض إلى علاقته بالكتابة. غير أن مزالي لا يكتب هنا لمجرد المتعة، فقد أراد من نصه غايتين تتضحان لكل من يقرأه. فقد سعى في البداية إلى تقديم شهادة عن الفترة التي ارتبطت فيها حياته بالمسؤولية السياسية منذ فجر الاستقلال، وفي خضم ذلك يقدم صورة لطبيعة سير الدولة وطريقة اتخاذ القرار في العهد البورقيبي، كما يوضح انجازاته الشخصية في مختلف مواقع المسؤولية، من وزارة التربية إلى وزارة الصحة إلى وزارة الدفاع إلى الشباب والرياضة إلى الإعلام وأخيرا الوزارة الأولى. أما الغرض الثاني الذي من أجله كتب هذه المذكرات فهو الدفاع عن نفسه إزاء ما تعرض له من تشويه وهجوم غير مبرر حاول خصومه من خلاله إلغاء دوره وتاريخه، وهنا يأخذ النص مسحة مختلفة تماما. من هنا فإن الكتاب لا يقدم لقارئه مزالي السياسي فحسب بل أيضا مزالي الإنسان الذي يبدي ألمه لما يعتقد أنه ظلم وقع عليه، وقد خصص جزءا كبيرا من مذكراته لرد "الاتهامات" ودحض "الافتراءات" رغم تأكيده في بداية النص "عدم حاجته إلى الدفاع عن صدق وطنيته وأصالة كفاحه السياسي والثقافي أمام أصحاب الذاكرة المثقوبة ولا التدليل على استقامته وبراءته إزاء الإشاعات الفجة والأكاذيب السمجة والاتهامات الباطلة التي لا تستحق سوى السخرية" (ص 14) انطلاقا من مقولة أن "من عرف نفسه لا يضيره ما قاله بعض الناس فيه".
قسم محمد مزالي مذكراته إلى فصول خمسة تناول فيها مسيرته السياسية التي دامت أكثر من 30 عاما، حيث يمكن القول أنه عاصر عملية ناء الدولة وكل تجاربها وتحولاتها وأزماتها إلى حدود إعفائه من مهام الوزارة الأولى في 1986. من هنا فإن قربه من دوائر صنع القرار طيلة جانب من هذه المسيرة بل ومشاركته الفعلية في صياغة السياسة الحكومية طيلة القسم الأكبر منها يجعل من شهادته ذات قيمة خاصة لكل من أراد دراسة تاريخ دولة الاستقلال. وبالفعل فإن الكاتب يتوجه بشهادته إلى "المؤرخين الذين ستؤهلهم أمانتهم العلمية لمزيد البحث الموضوعي والتنقيب العلمي قصد إعطاء صورة ناصعة، وفية، لتاريخ تونس منذ الإستقلال" (ص15).
غير أن متن الكتاب لا يؤكد أن هذه الصورة المراد رسمها لدولة الاستقلال كانت دائما ناصعة، وهذا لا يمس في شيء من صدق النوايا والرغبة في تحقيق ازدهار الشعب التونسي وتحقيق نهضته التي كانت تحدو مؤسسي الدولة الوطنية في تونس. فقد تراجعت النوايا الطيبة أمام ضغوطات مراكز القوى داخل القصر وفي دوائر الحكم وسرعان ما أفسح المجال لصراع أجنحة داخل الدولة عطل اضطلاعها بمهامها الأصلية. هذا الصراع لم يكن يجد تبريره سوى في رغبة الاستئثار بالمواقع القريبة من الصانع الحقيقي لسياسة الدولة وهو الزعيم بورقيبة الذي أتقن بفعالية التحكم في تلك الصراعات وطوعها إلى حد كبير لمصلحة سلطته الشخصية.
قد يكون ذلك مقبولا في بعض أنظمة الحكم وربما في أغلبها، غير أن "النموذج التونسي" كان قد تفتق على بدعة قل العثور عن شبيه لها من ناحية الفعالية وشدة التأثير. هذه البدعة كانت شجرة الدر الجديدة، "الماجدة" زوجة الرئيس التي كانت تحكم البلاد من خلف ستار، متقنة كافة أساليب الاستقطاب داخل أوساط الحكومة ومكونة قطبها الخاص. كان "حزب الماجدة" كبيرا وقوي التأثير. وربما تعارض أحيانا مع "حزب الرئيس"، ولا غرابة في ذلك فقد ذكر أحد رموز المعارضة الديمقراطية في عهد بورقيبة أن "المعارضة الحقيقية لبورقيبة موجودة في فراشه". وفي مذكرات مزالي شهادة على هذا الواقع الذي زاد استفحالا مع تقدم بورقيبة في السن. ولعل أهم مناسبتين يوردهما مزالي في هذا الاتجاه هو أن أكبر الأحداث التي شهدتها تونس في تاريخها القريب قد وقعت نتيجة مؤامرة حبكت "الماجدة" خيوطها واستهدفت في كل مرة الوزير الأول (نويرة في جانفي 1978 ومزالي في 1984) الذي كان بوصفه دستوريا الخليفة المحتمل لرئيس الدولة، يتلقى كل السهام وتحبك لتحطيمه كل "المؤامرات". ربما أضاءت هذه الشهادة جانبا من الحقيقة غير أنها تبقى قاصرة عن تفسير تلك الأحداث. فأحداث "الخميس الأسود" في 26 جانفي 1978 وقعت لأن كل الظروف كانت تنبئ بوقوعها ولم يكن من الممكن في ظننا منعها. ربما كان عاشور بالفعل عضوا في "حزب الماجدة"، ولكنه ما كان ليجر وراءه كل النقابيين والشغالين لو أن هدفه كان يتلخص فحسب في الإطاحة بنويرة. كذلك الأمر بالنسبة لأحداث الخبز، فربما سهلت انفجارها كما يؤكد مزالي "مؤامرة" نسجت خيوطها بإحكام لكنها ما كانت لتقع لو أن الشعب كان راضيا عن النظام الذي يحكمه. لقد كان الحاكمون يعرفون حقيقة ما يعتمل داخل المجتمع من نقمة على سياسات لم تحقق طموحات شرائح واسعة في حياة كريمة، فسعى بعضهم إلى الاستفادة من تلك الطاقة الهائلة لتصفية حسابات ضيقة لا تكاد آفاقها تتجاوز أسوار القصر. وفي المناسبتين انتفض ذلك المارد ليفرض نفسه في واقع لم يكن يحقق فيه الإنسان إنسانيته برغم أساليب الدعاية والتعمية التي سخر لها النظام كل قدراته. إن المسألة، كما لا يوضحها صاحب المذكرات، مسألة انفصام عميق في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ذلك الانفصام الذي أدى إلى غربة ثم إلى تنافر ثم إلى تحين كليهما الفرصة للانقضاض على الآخر. وفي المناسبتين كانت الكلمة الأخيرة للحاكمين الذين لم يفوتوا فرصتهم لترسيخ عبودية الجماهير بقمع طال الأخضر واليابس. من هنا فإن حصر المسألة برمتها في مقولة "المؤامرة" يبقى قاصرا عن تفسير العمق الحقيقي لذلك الصراع وإن مكن في نهاية الأمر من توضيح بعض جوانبه.
والمتمعن في مذكرات مزالي يلاحظ أن الكاتب يضع نفسه كتواصل لسياسات الذين تقلدا منصب الوزير الأول من قبله، الباهي الأدغم والهادي نويرة. وهو لا يجد حرجا في الاعتراف لهما بالفضل على مسيرة التنمية الاقتصادية وعلى مشروع بناء الدولة، وهذا الموقف في حد ذاته موجب للاحترام حيث أننا تعودنا من كتاب المذكرات من كبار رجال الدولة ذلك المسعى المرضي لنسف إنجازات أسلافهم ومحاولة السطو على ما حققوه للبلاد وهو وجه آخر من وجوه العلاقة بين عناصر نخبة الدولة. غير أننا نفهم من ذلك أيضا أن محمد مزالي قد نظر دائما إلى دوره السياسي كمكمل لدور عناصر أخرى سبقته أو عاصرته في العمل الحكومي تحت قيادة بورقيبة. كما أن مزالي يحتفظ باحترام شديد للزعيم بورقيبة وهو من هذه الناحية أيضا يقطع مع تلك الممارسة التي تتمثل في التحمس لتسديد الطعنات كلما كانت "الضحية" عاجزة عن الرد.
وهنا لب القضية في نظرنا. فمزالي كان جزءا من نظام، وبغض النظر عن سعيه لتقديم ممارسة مختلفة للشأن العام، فإن ذلك كان عاجزا عن تحقيق تحول فعلي في مسيرة ذلك النظام. ذلك أن القرار لم يكن له، كما لم يكن لغيره مهما علت مرتبته في سلم الدولة. ومرد ذلك في الحقيقة إلى تحول النظام من نظام مصغ لصوت شعبه ساع لخدمته برغم ما وقع من أخطاء، إلى نظام همه الوحيد الإبقاء على سيطرته على المجتمع وإن أخل بأهم مقومات العقد الاجتماعي. ذلك ما نفهمه من التجربة الديمقراطية التي دشنها مزالي في 1981 والتي قتلت في مهدها لأن النظام تهيأ له أن تلك كانت بداية النهاية بالنسبة إليه وبخاصة بالنسبة لأصحاب المصالح في بقائه منغلقا على نفسه ومنعزلا عن الجماهير.
هل كان النظام عاجزا بالفعل عن انتهاز تلك الفرصة التي قدمها له مزالي لتجديد نفسه وبناء شرعية جديدة تمنحه نفسا جديدا؟ لقد كان عاجزا عن ذلك ليس لقصور في إدراك مراكز القوى لمصلحتها الحقيقية من تغيير تدريجي وسلمي لا يفقدها سيطرتها على الوضع، بل لأن بعض عناصرها كانت تتصرف بغير حرص على مصلحة النظام العامة. من هنا فإن الإشكال الحقيقي ليس في عدم حرص تلك المراكز على مصلحة الشعب أو مصلحة الدولة، لأن ذلك كان معلوما للسواد الأعظم، بل في عدم حرصها على مصلحة النظام التي كانت تقتضي انفتاحا مدروسا يقيه غائلة التحركات العنيفة. وهذا يعيدنا إلى الطبيعة الارتجالية لصنع القرار التي اتضحت في العشرية الأخيرة من حكم بورقيبة والتي لا ينبغي تبريرها بتقدمه في السن فحسب. فالمسألة تعود في نظرنا إلى عامل هيكلي يتمثل في الطبيعة الرئاسوية للنظام من ناحية، وإلى فشل مسار بناء مؤسسات قادرة على تصويب أخطاء السلطة التنفيذية. من هنا فلا مزالي ولا غيره كان قادرا على تحقيق تحول جذري في طبيعة النظام، ذلك أن مراكز القوى كانت ترى في أي تغيير مهما بدا بسيطا خطرا يهددها مباشرة. ذلك أن بناء مؤسسات حقيقية يعني فقدان تلك المراكز لغاية وجودها. فما هي المكانة الحقيقية التي يعطيها دستور دولة، مهما بلغت العبثية، لزوجة الزعيم حتى تغدو "الماجدة" صاحبة القول الفصل في تعيين الوزير الأول أو عزله؟ وأي نظام يشرف فيه وزير الداخلية (1981)على تزوير إرادة الشعب دون محاسبة أو عقاب؟ وأية دولة تلك التي تملأ الدنيا صراخا حول إصلاحات اجتماعية تجعل للطلاق ضوابط معلومة ثم يكون مؤسسها وبانيها أول من يخترقها؟
لا نشك أن مزالي وغيره كانوا مدركين لعمق الهوة التي تردى فيها مشروع الدولة في تونس، ولعلهم أرادوا تجديد شباب ذلك النظام بعد أن رأوا توغله في الاتجاه الخاطئ. فهم في نهاية الأمر تلك النخبة الشابة والمثقفة التي بنت على الاستقلال كل أحلامها في تأسيس مشروع وطني يعيد للشعب كرامته ويحقق فيه رشده السياسي.غير أن قوانين الهندسة، وليست قوانين السن والتهرم فحسب، أفشلت مساعي الصادقين منهم، ومضمونها أنك لا تستطيع إنجاز بناء صلب على أسس هاوية. وهكذا أدى تجاهل هذه القاعدة إلى إصابة كامل الدولة، وليس بورقيبة فحسب، بذلك المرض الذي يطلق عليه اسم مرض باركنسون، فبدا مرتعشا، متخشبا، فاقدا للإتزان ومكتئبا.





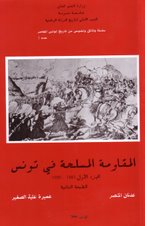



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire