
في الحاجة إلى الرموز
يقظة الذاكرة
عدنان المنصر
أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة سوسة
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 12 مارس 2010
أحدث شريط "اغتيال حشاد" الذي بثته قناة الجزيرة بعض الضجة في معظم الأوساط المهتمة بالسياسة والتاريخ
والذاكرة، وهي ضجة يمكن تفهم أسبابها بالنظر إلى أهمية القضية من ناحية وكذلك لعلاقتها بملفات عديدة لم تحسم لعل أهمها قضية التورط الرسمي الفرنسي في التخطيط والتنفيذ. ما يثير الإهتمام هو أن أكثر المتفاجئين بهذه الضجة هم المؤرخون أنفسهم الذين تفطنوا إلى أن ما يعرفونه حول المسألة ليس أمرا شائعا وأن هناك حاجة متعاظمة إليهم يتجاوز أفقها قاعات التدريس والمجلات العلمية والمناقشات الأكاديمية.
ليس ماهو أهم في قضايا الذاكرة من مسألة الرمز التاريخي، وهذا الرمز وإن تجسد في غالب الأحيان في شخصية أو حادثة فإن الأمر، في المطلق، يمكن أن يشمل أيضا بعض مواقع الذاكرة الأخرى كمعلم تاريخي على سبيل المثال. إن قيمة الرمز تتمثل الخصوص في خلقه نوعا من الرابطة المعنوية لدى مجموعة ما ومساهمته في تأسيس وصياغة وترسيخ هوية تاريخية معينة. تأخذ عملية تأسيس الرمز في الذاكرة بعدا جديدا في حضور عوامل مخصوصة، مثل التحدي الأجنبي وانخراط الشخصية المعنية في الصراع ضد الظلم وارتقائه إلى مصاف البطولة في الوعي الجمعي. ليس البطل هو ذلك الذي ينتصر بالضرورة ماديا في معركة مادية، بل ذلك الذي يقارع الباطل ويواجه الظلم بغض النظر عن تفاوت الإمكانيات الموضوعية، ذلك أن المعركة ضد الباطل ليست معركة مادية بالضرورة، كما أن الانتصار فيها لا يقاس حتما بما ينجز على ساحة معركة أو فضاء مواجهة. فصراع الحق ضد الباطل إنما هو بالأساس صراع مبادئ وتقارع إرادات.
إن عملية بناء الرمز-البطل في الذاكرة عملية متكررة في الغالب لا تختلف نماذجها إلا في التفاصيل الصغيرة الناتجة عن خصوصية الظرف. المبدأ القار في عملية البناء تلك أن الرمز يصبح فكرة توحد حولها إرادة مجموعة معينة، فيصبح الرمز بذلك تجسيدا لتوق جماعي للتحرر، بغض النظر عن إنجاز التحرر أو درجة تحقيقه. ذلك أن الانتصار الحقيقي في المعارك ضد الباطل يتحقق عندما تترسخ فكرة التحرر لدى مجموعة أفرغها الإستبداد والظلم من كل قوة وطاقة. إنها عملية إعادة بناء للإنسان بوصفه كائنا حرا بالقوة. يعج التاريخ بالأمثلة عن مثل هذه المسارات: من الحسين بن علي الكربلائي، إلى جان دارك الفرنسية، إلى غاندي الهندي، إلى نلسون مانديلا الإفريقي، إلى أحمد ياسين الغزاوي تتعدد النماذج عن نفس المسار الخلاق، مسار الإنسان الصاعد من رحم إرادة مقدسة، إرادة أن يكون حرا بغض النظر عن تفاوت مقاييس القوة والجدل حول جدوى الصمود أمام غطرسة المستبدين، أفرادا كانوا أو مجموعات. إن انتصار هؤلاء في معركة البطولة قد تم حتى قبل المواجهة المادية، تم عندما ترسخت حولهم رمزية الإرادة في الإنعتاق من حكم القوة المدججة بالظلم والسلاح والاقتصاد. لو تساءل غاندي عن جدوى مواجهة الاستعمار الأنقليزي أو ياسين عن جدوى مقارعة القوة الصهيونية، لماتت البشرية منذ زمن طويل. كم في ذلك من عبرة، لمن يريد أن يعتبر.
يضيف أهمية لقيمة البطل عدم امتلاكه لقوة خارقة، فأن يكون البطل نابعا من عمق المجموعة التي ينتمي إليها، من فقرها وقهرها وأحلامها في الحياة، أمر أساسي لأنه يعطي النموذج والقدوة لمن حوله. لم يأت غاندي سوى من طائفة المنبوذين المقهورة، لم يأت نلسون مانديلا سوى من أحياء السود الفقيرة، لم تكن جان دارك إلا فلاحة، ولم يكن أحمد ياسين، ذلك الفاقد لحركة الأعضاء، سوى رجل فقير من عائلة معدمة لاجئة إلى غزة. كذلك حشاد. فقد جاء الرجل من وسط الصيادين الفقراء المكافح والأصيل. ليس أقوى من رمزية صياد يقارع البحر كل يوم ليفتك منه رزقه، من قرأ همينغواي أو سمع عنه يدرك قيمة هذا الرمز. كان بإمكان حشاد وقد حصل على الشهادة الابتدائية (وكانت ذات قيمة في تلك الظرفية) أن يترشح لوظيفة رسمية أو شبه رسمية مثلما فعل الكثيرون ممن لم يفكروا سوى في ذواتهم، لكنه خير على ذلك النضال الاجتماعي والالتزام بالدفاع عن المسحوقين ممن يطحنهم رأس المال في اليوم ألف مرة ويقتلهم الاستبداد في نفس اليوم ألف مرة أخرى. لم تكن للرجل مؤهلات خاصة تسمح له بالتميز ضرورة، سوى عصاميته وإرادته النافذة لخدمة فكرة ومبدأ. أكثر من غيره كان الرجل قد نجح في إيجاد الحلقة المفقودة بين النضال السياسي والكفاح الاجتماعي. كم كانت ثورية فكرة أن لا معنى للكفاح العمالي من أجل الحقوق المادية دون إنسان حر. أصبح حشاد يرمز في الذاكرة الجمعية إلى ما يوحد التونسيين ويجمع شملهم، ولعل مقتله الغادر قد زاد في الهالة التي أصبح يحظى بها لدى أجيال التونسيين والأحرار في العالم. لا يمكن للقهر أن لا يخطئ أخطاء قاتلة، فالأمر متضمن في منطق القهر ذاته.
لا يهمنا موضوع البحث عن قتلة حشاد سوى من زاوية أنه استعادة الذاكرة لفضائها الطبيعي في الوعي الجمعي، فالقتلة معروفون والمسؤوليات واضحة، منذ زمن ليس بالقصير. ما يهمنا هو الطريقة التي تفاعل بها الناس مع عودة هذا المعلم إلى التداول. ففي حين فهم معظمهم أن القضية أبعد من تحقيق جنائي أو اعتراف بمسؤولية سياسية، تهاوى قسم آخر في محاولة استثمار رخيصة للقضية وتصاعدت أصواتهم المبحوحة لكثرة صراخهم في الساحات الفارغة، مطالبين بالجزئي ومتناسين المسألة الأساسية: ما نحتاجه هو ترسيخ ثقافة الرمز، وثقافة البطولة، وهوية الإنسان بوصفه ذلك الكائن المكافح من أجل إنسانية لا تكتمل سوى بقيمة الحرية. تطرح قضية حشاد مسألة أعمق من الشكل القانوني للصراع أو من جزئيات تنفيذ العملية الغادرة: تضع المسألة أمامنا وضعية صراع على الذاكرة وتؤسس لمسار تحريرها. لا يتم ذلك في نظرنا إلا بإخراج حشاد من قبره ووضعه رمزا تحت تصرف الذاكرة. منذ نصف قرن يستأثر الرسمي بالذاكرة، يصوغها كما يريد ويبغي، يبقي البطل أسيرا لبناية جميلة ولكنها باردة، معلما شبه رسمي بجوار معالم الإدارة الأخرى. هل يدرك الناس أن الضجة التي يفتعلها بعض مهنيي النضال الاجتماعي حول متابعة قضية الاغتيال ليست سوى مفتعلة وأنها لا تعدو سوى أن تكون خطوة أخرى على نفس درب الاستثمار السياسي لمناسبات قادمة؟ ليس من معلم أكثر من التجربة، كما يقولون !
في المقابل، يبدأ مسار آخر سيتسنى ملاحظة عمقه بعد جيل أو جيلين، مسألة استعادة المجموعة لذاكرتها وهوية تاريخها الأصيل. بديهي أنه على المؤرخ اليوم أن ينخرط في هذا المسار وأن يخرج عن جفاف دوره الأكاديمي، وأن يذهب للبحث عن جمهوره المتعطش لاستعادة روحه وتنقية رئة الذاكرة من شوائب النسيان والنكران. ليس أكثر قداسة من هذه المهمة، فالناس في حاجة إلى رموز وأساطير. أجدى بالأساطير أن تكون مؤسسة لفكرة، وليس من فكرة أرقى وأسمى من فكرة الإنسان.





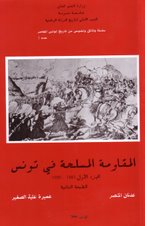



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire