
في استعمالات الدين:
دقائق حرجة جدا مر بها زعماء 9 دول افريقية يوم الأربعاء 19 جانفي في مراسم افتتاح "مسجد القذافي الوطني" بالعاصمة الأوغندية كامبالا عندما أدى تدافع بين الحراس الشخصيين للزعيم الليبي والرئيس الأوغندي إلى اندلاع شجار كاد يتحول إلى مجزرة بعد سحب الحراس لمسدساتهم، وهو ما كان سيؤدي، لا قدر الله، إلى فقدان قارتنا العزيزة لأكثر زعمائها ديمقراطية وشفافية وتفانيا في خدمة شعوبهم.
كانت المناسبة التي تداعى بسببها ذلك الحشد الإستثنائي من الزعماء إلى العاصمة الأوغندية بالغة الأهمية. فقد كان الأمر يتعلق بتدشين أكبر مساجد أوغندا الذي شرع في بنائه منذ سبعينات القرن المنصرم الديكتاتور عيدي أمين دادا، ولم يتسن الفراغ منه سوى بمساعدة ليبيا الحثيثة. غير أن مجهودات أكثر من عقود ثلاثة كادت تضيع في دقائق ست وهي مدة "المعركة" التي اندلعت بين الحراس الشخصيين للزعيمين الليبي والأوغندي. وفيما يبدو فإن "المعركة" اندلعت عندما حاول حراس العقيد منع الرئيس موسيفيني من دخول المسجد قبل العقيد أو بالتزامن معه، رغم أنه رئيس البلد المضيف الذي يقع المسجد على أراضيه. ولكن من جهة أخرى، كيف يمكن أن يكافأ العقيد على ما أنفقه من أموال إذا لم يكن الداخل الأول للمسجد، إضافة إلى ذلك فإن الزعيم الذي يقدم نفسه كزعيم للقارة ومؤسس لوحدتها العظيمة وداعية للإسلام لا يمكن أن يقبل بوجود أحد معه في الصورة، وهذا منطقي بالنظر إلى كل تلك الإعتبارات. تلك بعض أسباب "سوء التفاهم" التدشيني، ولكنها ليست كل أبعاده حتما.
العقيد زعيم إفريقي، لا يفتأ يتنقل في ربوعها بمناسبة ودون مناسبة، يلقي خطبة جمعة هناك، يفتتح مسجدا هنا، يتوسط لحل نزاع في مكان ثالث، ويؤنب الفرقاء على خلافاتهم التي تؤخر تحقيق الحلم العظيم بوحدة القارة. نتفهم هذا التوجه الإفريقي للعقيد، لأننا أفارقة أولا، ولأننا لمسنا الخيبات المتتالية التي منيت بها السياسة العربية للزعيم الليبي وقسوة الحظر الإقتصادي الذي سلطه الغرب والكثير من العرب على ليبيا. لم يبق أمام العقيد، فعلا، سوى إفريقيا. هذه القارة مهيأة، كما يقول البعض، لتقبل الزعامة الليبية. فليس هناك من ينافسها عليها أولا، كما أن الجميع فيما يبدو قد نسيها وأهمل مشاكلها، إضافة إلى أن الطفرة النفطية مكنت ليبيا من موارد ضخمة لا بأس أن ينفق بعضها على الإخوة السمر. لا عائق أمام زعامة القارة إذا فهمنا من ذلك حرصا، يبدو واضحا، على حل الخلافات وتهدئة الصراعات التي لا تفتأ مشتعلة بين الدول وداخل الكثير منها، على هذا المستوى يحقق الزعيم الليبي نجاحات كثيرة باستعمال تأثيره المعنوي والمالي على الأفرقاء. بديهي أن الوساطة، حتى عندما لا تنجح، فإنها تضع الوسيط فوق الخلافات وتجعله في منزلة الحكم، وهو ما يحصل مع العقيد. العقيد يستخدم ذلك ولكنه لا يكتفي به، فهو يقدم نفسه أيضا كداعية إسلامي حيث لا يفتأ يحرص على نشر تعاليم الإسلام داخل القارة، بطريقته. هنا جانب آخر من هذه الزعامة لا ينبغي إغفاله. وبما أن الإسلام يتجاوز في حدوده القارة الإفريقية فإن ذلك المسار يضع الزعيم الليبي في موضع يبدو أنه يحبذه كثيرا منذ فترة، موضع المنافس لدور السعودية في هذا الخصوص. قد نفهم جانبا من حرص الزعيم الليبي على اختتام أشغال بناء المسجد من هذا المنطلق، فالسعودية هي التي بدأت المشروع مع عيدي أمين دادا في 1972، لكن الإطاحة بالدكتاتور الأوغندي عطلت المشروع، وها هو ينجز اليوم على يد ليبيا. نفهم ذلك أيضا من خلال النقد الذي ما فتئ العقيد يوجهه للسعودية التي تحتكر، حسب قوله، الحج والكعبة وتوجههما لخدمة سياستها في حين أنهما مشاع للمسلمين.
لماذا يأخذ الإسلام كل هذه الأهمية في الدعاية الرسمية للدول؟ سيجيب الجميع أن المسألة متعلقة بقضية الشرعية، وهو ما نعتقد فيه أيضا. لا يحتاج هذا الجانب من الموضوع إلى بيان كثير. ولكن هذا هو الجزء الممتلئ من الكأس، فأين الجزء الفارغ؟ لعله يتمثل في عدم استناد هذه الأنظمة إلى المنبع الحقيقي للشرعية السياسية في عالم اليوم، وهي الديمقراطية. فالشرعية الدينية، مهما بلغت نسبة مطابقتها لواقع قناعة الدول والأنظمة، لا تكفي. إنها لا تكفي فقط، بل إنه عادة ما يقع الإستناد إليها للإيهام بأنها أهم وأفضل من الشرعيات الأخرى وأنها تبيح جميع السياسات التي قد يفهم منها تضييق على الحريات أو مصادرة لحقوق الشعوب في الحياة الكريمة. من يحتاج الحكام أكثر من غيره، بديهي أن الله لا يحتاج إليهم، وأنه لا يغنيه أو يفقره ما يفعلون. في هذا المستوى النظري، الشعوب هي التي تحتاج حكامها لقيادتها في معاركها ضد الفقر والأمراض والفساد. الله لا يحتاج إلى الحكام، ولكن الحكام يحتاجون إلى الله. لذلك نراهم ركعا سجدا، حاجين ومعتمرين، متزاحمين على "المبرات"، متمسكين ببعض الألقاب التي عفا عليها الزمن والتي لا تفتأ تصيبنا بالغثيان. هل يغني تأسيس مسجد عن تأسيس برلمان؟ وهل تعوض صلاة الجمعة الإنتخابات الديمقراطية؟ وهل تستطيع الإمامة أن تحل محل الزعامة السياسية؟ قد لا يكون أولوا الأمر مقتنعين في قرارة أنفسهم بأن ذلك ممكن، لكنهم يعرفون جدواه جيدا في وسط يسيطر فيه الشكل على المضمون. ماذا تستفيد تلك الشعوب من إيمان زعيم ما إذا كان إيمانه أو عدمه لا يغيران من حياتها البائسة شيئا؟ هذا يجرنا حتما إلى طرح السؤال المفزع: هل الديمقراطية مطلب حقيقي، بمفهوم الحاجة الواقعية، للشعوب؟ بمفهوم ما، يجب أن يكون كذلك، أما الواقع فأحكامه مختلفة.
من نفس مفهوم الواقع، لا يبدو أن الحكام في البلاد الإسلامية يؤسسون لممارسة جديدة. هم ينخرطون في نفس المنظومة الجاهزة التي صاغها السابقون، وإن كان بعضهم يبالغ أكثر من غيره في الإستناد إليها. بذلك ينتقل الصراع السياسي إلى ميدان ليس من المفترض أن يكون ميدانه. اقتناعا أو انتهازية يشكك جانب من المعارضين في حقيقة تقوى الزعماء ويقدمون، في خطابهم، الهم الديني على الهم الديمقراطي. وأكثر من ذلك، يكفر بعضهم بالديمقراطية التي جاءت بهؤلاء الزعماء، وكأنها هي التي جاءت بهم فعلا. وعندما يصلون إلى الموقع المراد الوصول إليه يستأنفون المسيرة ذاتها، يقفون على الأرضية ذاتها، يلتقط الإستبداد أنفاسه ويواصل طريقه بنفس العزم. يسبح الجميع إذا في ملكوت البنى الفوقية، وتبقى الديمقراطية والممارسة الشفافة للحكم والتصدي للمشاكل الواقعية للشعوب في الدرك الأسفل من النار.الديمقراطية تعني المحاسبة، أما حقيقة التقوى وزيفها، فأمر مختلف تماما لا يمكن التثبت منهما إلا خارج حدود الزمان. وطالما أن "بعض الظن إثم"، فالمتقي مؤمن حتى يثبت نفاقه.
كم يجب أن تتكرر المأساة حتى نفهم أن للحداثة السياسية ضوابطها وحقيقتها الخاصة، وأنها، إذا أرادت أن تكون حداثة فعلا، يجب أن تكون أدواتها مما ينفع الناس. إن أبشع الديكتاتوريات تلك التي تستند إلى عقيدة. المشكل ليس في العقيدة مطلقا. يمكن أن تكون المسيحية أو الإسلام أو حتى الوثنيات، يمكن أن تكون دينا أو إيديولوجيا وضعية، هذا ثانوي. نفس العقيدة يمكن أن تسند حكما مستبدا وأن تشرع لأكثر الحركات ثورية. لذلك فإن التعويل عليها في حكم الشعوب لا يبدو ذا طائل. من يستعمل الدين أكثر من غيره يربح أخيرا، ذلك ما يبدو عليه الوضع في البلاد المتخلفة، ليس هذا مجرد وصف لحالة معينة، بل قاعدة يبدو أن الجميع، أو بالأحرى الأكثر تأثيرا، يعولون عليها. من كلا المنظورين، الحاكم والمعارض، يبدو الدين كتلك الدجاجة التي تبيض ذهبا. وفي خضم ذلك كله يقع تناسي ما هو حقيقي. لماذا تثير السياسة الدينية اللغط أكثر مما تثيره السياسة الإقتصادية والإجتماعية؟ سيقول البعض لأن الشعوب لا تعرف مصلحتها، جواب سهل وجاهز لكنه لا يتقدم بنا أية مسافة إلى الأمام. الأمر يحتاج إلى كثير من الجهد والتربية حتى تفهم الشعوب أن الحلول يجب أن تكون من جنس المشاكل التي تسحقها وأن تتفطن إلى الخداع الذي تتعرض إليه كل يوم من أجل صرفها عما ينفعها. هل يعني ذلك إلغاء الديني تماما، هذا أمر لا يمكن بلوغه مهما تنافس في ذلك المتنافسون. المراد هو العودة بالسياسة لمربعها الأول، وكسر عملية الإحتكار التي يقوم بها كل طرف، حسب غاياته، للشرعية الدينية. في هذا المسار لا يبدو أن الحركات الدينية، أو ما اصطلح عليه بحركات الإسلام السياسي، هي العائق الوحيد أو الأكبر. من منطلقها، تبدو تلك الحركات في موقع من يرد الفعل على استغلال الأنظمة المفرط للحقل الديني حتى عندما لا يتطلب الأمر ذلك. ولكن أن تكون في موقع من يرد الفعل لا يعفيك من المسؤولية عن انعكاسات ما تأتيه. من جهتها فإن الأنظمة، عندما تحرم على بعض الأحزاب والحركات ولوج ذلك الحقل والإستقرار في ربوعه الوارفة، فإنها لا تمارس غير النفاق السياسي. هل تستطيع الأنظمة المذكورة، وبعضها كان إلى حد ليس بالبعيد ثوريا تقدميا، أن تتحمل تبعات الخروج من الحقل الديني ومواجهة خصومها ومعارضيها على حقول أخرى؟ ستتعرى تماما وستظهر عوراتها البشعة. بين الاستبداد المتلبس بالشرعية الدينية وبين الدين المتدثر بالسياسة لا يبدو أن الفارق كبير جدا. من هذا المنطلق يبدو أن الجميع منخرطون في المنظومة ذاتها، كل طرف يمول الآخر بعوامل بقائه. لذلك فلا مخرج من المنظومة إلا بكسرها وبالولوج إلى العالم الحقيقي الوحيد الممكن، عالم ما ينفع الناس. ليس في ذلك أي حط من قيمة الدين ولا أي تضخيم من مكانة السياسة، وإنما عودة بالأشياء إلى أصولها. ولكن في خلال ذلك، يجب تربية الشعوب على التخلص من آثام الدعايات التي تجعل من تسييس السياسة خيانة للدين، وهو مسار طويل لا يمكن توقع بلوغ مداه في جيل أو جيلين. ذلك أنه لا يمكن بتاتا الإقتصاد في التاريخ. كم استغرق الأمر لأوروبا من أجل التخلص من هيمنة الكنيسة على السياسة والولوج إلى الحداثة السياسية التي تمثل الديمقراطية أحد أبرز تجلياتها. قطعا ليست الديمقراطية النظام المثالي الوحيد الممكن، ولكنه أقل النماذج التي جربتها البشرية سلبيات. سيقول البعض أن الأمر لا يتعلق هنا بكنيسة، ففي الإسلام ليست هناك كنيسة ولا لاهوت، شكلا هذا صحيح، أما مضمونا، فالأمر يستدعي لسوء الحظ بعض النظر !





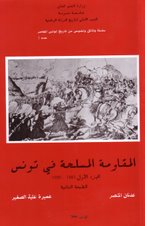



2 commentaires:
شكرا على هذا المقال الممتاز
شكرا على هذا المقال المتميز، وشكرا خاصة على منحي هذه الفرصة لعرض بعض الخواطر التي لم تجد فرصة للظهور ولم تجد من يسمعها أو يعلق عليها...
في البداية أرى أن الدين في نظام استبدادي يتحول إلى أداة لتبرير القمع ومحاربة الفكر ومنع الاجتهاد ومصادرة الحريات...
وأعتقد بان مسؤولية تعطل المسار الديمقراطي والتنموي في العالم العربي تقع على عاتق النخب والتيارات الفكرية والسياسية المختلفة..
فالتيار العلماني في البلاد العربية والإسلامية في أغلبه كان يدعو الى الفصل الكامل بين الدين والسياسة، ليس خدمة لقيام دولة ديمقراطية حديثة تحترم المعتقدات والحقوق الأساسية لمواطنيها والحريات العامة، ولكن بهدف إضعاف دور الدين في المجتمع وتقليص آثاره داخل دائرة ضيقة.فهدا التيار لم يعتبر الإسلام مكونا من مكونات المشروع الحداثي وبالتالي فان التيار العلماني العربي مشارك - بسبب لاديمقراطيته وتطرفه أحيانا واستهانته بالحجم الحقيقي للإسلام في معركة التحديث في ما آلت إليه أوضاع الأمة، كما أن الحركات الإسلامية تبنت في الغالب خطابا دفاعيا قائما على الإحساس بأن الإسلام في خطر، وأنه يتعرض إلى هجمات عدائية من خارج جسم الأمة ومن داخلها ولم تستطع أن تبلور رؤية واضحة للديمقراطية أو لعلاقة الدين بالسياسة أو لشكل الدولة أو للحريات وحقوق الإنسان وبالتالي أبقت على عديد الهواجس لدى بقية الأوساط السياسية والفكرية وهذا ما سمح لأنظمة الاستبداد ان تتستر بالدين عند مواجهة القوى المعارضة العلمانية واليسارية"الملحدة"، وتلبس عباءة التنوير والعقلانية عند مواجهة القوى الاسلامية المعارضة"الظلامية" .. أعتقد ان الحل هو اولا في مواصلة النضال السياسي ومواجهة الاستبداد سلميا وفي موازاة ذلك على النخب الفكرية ان تعمل على بلورة فكر معتدل حداثي مع ضرورة الايمان،حسب رأي، بدور الإسلام في البناء الثقافي والتغيير الاجتماعي لهذه الامة باعتباره اهم مكوناتها الحضارية.....
Enregistrer un commentaire