واحد وخمسون عاما على دولة الاستقلال
متى تقوم دولة المواطنة؟
عدنان المنصر
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 23 مارس 2007
تمر هذا الأسبوع الذكرى الواحدة والخمسون على نيل تونس "استقلالها التام"، ففي يوم 20 مارس 1956 قطعت البلاد خطوة إضافية، ولكنها لن تكون الأخيرة، في سبيل الإنعتاق من الهيمنة الاستعمارية الفرنسية، تلك الهيمنة التي استمرت 75 عاما. وقد جاء إمضاء بروتوكول الاستقلال التام ليضع، بشكل رسمي، حدا لواقع ازدواجية السيادة التي أسستها اتفاقيات الاستقلال الداخلي حيث كان للفرنسيين إلى حد ذلك التاريخ القول الفصل في معظم الميادين الحساسة.
لا شك أن الحدث كان هاما بالنسبة لمن عاش تلك الفترة، ولا شك أنه يبقى ذا قيمة هامة أيضا لنا اليوم، غير أن ذلك ليس داعيا لتقديسه إلى الحد الذي ينسينا ما رافقه وتلاه من مآس لازلنا نتجرع مرارتها إلى اليوم. فبين الحدثين حصلت أعمال رهيبة من القتل والترهيب في إطار ما سمي "بالفتنة اليوسفية" ، وغاصت البلاد في هوة التقاتل الأهلي زمنا ليس بالقصير، وتواجه رفاق السلاح السابقين في معارك طاحنة سخر لها كل طرف ما استطاع من حلفاء ومساندين، تحت قيادة إخوة أعداء فرقتهم سبل السياسة . لن نتوقف هنا عند مراحل هذا الصراع الذي كتب وسيكتب حوله الكثير، ولن نضع نصب أعيننا تحميل المسؤولية عنه إلى طرف دون غيره، فالجميع كان مسؤولا وإن بدرجات متفاوتة. إنما همنا هنا أن نؤكد على أن حدث الاستقلال لم يكن الحدث الذي نعتقد اليوم أنه كان، فقد غطت عليه آنذاك أخبار المداهمات والاختطافات والاغتيالات والمحاكمات والإعدامات... وأن الوضع الذي ستنشأ في خضمه دولة الاستقلال سيكون محددا أساسيا لطبيعة السلطة الجديدة. لقد كانت سلطة نشأت في خضم الصراع الأهلي، على يد زعامات مؤمنة شديد الإيمان بأنها مهددة في صميم دورها التاريخي بل وفي وجودها المادي. وغني عن التوضيح هنا أن التهديد اليوسفي الذي كان جديا إلى أبعد الحدود قد استعمل من الجانب البورقيبي "كفزاعة" لإقناع الفرنسيين بتجنيد أكبر جهد ممكن لمقارعة الخصم المشترك، مما يجعل من "اليوسفيين" ضمنيا شركاء في تحقيق "الاستقلال التام". غير أن ما سيحدث لاحقا كان مختلفا. فقد اعتبر اليوسفيون مغلوبين يجدر الانتقام منهم والتنكيل بهم، فتواصلت المحاكمات والتتبعات بل والإعدامات والاغتيالات، وكانت تلك فرصة استغلها بعض الأتباع للإفصاح عن مهاراتهم المكنونة.
من هنا لم يكن هناك بد من اعتبار البورقيبيين أنفسهم منتصرين، فشرعوا في بناء الدولة الجديدة بكثير من التشفي قي خصومهم الحقيقيين والمفترضين. وليس من الوارد هنا أن ننكر وطنية الزعامات التي وضعت على عاتقها مهمة بناء الدولة كما مهمة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهذه الزعامات وبخاصة بورقيبة ظلت تعتقد أن الاستقلال التام مجرد مرحلة على طريق بناء بعيد المدى سخرت له كل إمكانيات الكيان الفتي. كان التحديث هو الهدف النهائي لهذه النخبة الوطنية، وكان سعيها نحو هذا الهدف حثيثا، في إطار حماس شعبي فياض. كان التحديث يهدف إلى إنشاء إنسان جديد في وطن جديد، فكان إصلاح التعليم وإصلاح القضاء والأحوال الشخصية... إلى غير ذلك مما نتنعم اليوم ببعض ثماره. غير أن هذا التحديث لم تصاحبه حريات حقيقية تسمح للتونسيين بهامش ولو ضيق من الاختلاف مع الإيديولوجيا المنتصرة. فحكمت النخبة الجديدة على "الثقافة التقليدية" بالزوال، واستحوذت على صلاحيات كانت باستمرار عصية على الحاكمين، فنصب بورقيبة نفسه مفتيا ومعلما وإماما بل ورسولا. وبالموازاة مع ذلك انطلق مسار من التأليه لبورقيبة ستسخر له إمكانيات الدولة جميعها، كما ستسخر له ماكينة حزبية فعالة. ولن تعيق عملية بناء المؤسسات الجمهورية، بما في ذلك الدستور والبرلمان، هذا المسار، حيث نجح بورقيبة في بناء نمط من النفوذ يخترق كل المؤسسات، بل نجح في إقناع جانب من التونسيين بأن وجوده ضمانة لحسن سير المؤسسات. لذلك فقد كان التونسيون مستعدين ليغفروا له هفواته، فقد كان أباهم الذي على الأرض. لذلك فلم يكن من الصعب عليه أن يقنعهم أن وجودهم وفرحة حياتهم مرتبطة به، وأن "القائد في الكفاح هو الضامن للنجاح". كانوا سيصبحون أيتاما لو قيض لبعض "المعتوهين" أو "المارقين" أن يضعوا حياته تحت التهديد. وفي المقابل كان هو يحسن استغلال الفرص للتخلص من مزيد من المناوئين. ففي أواخر 1962 أكتشف أمر المحاولة الانقلابية الشهيرة التي دبرها بعض قدماء المقاومين وبعض العسكريين بتعاون مع بعض اليوسفيين. كانت الفرصة مواتية للقضاء على آخر قلاع المعارضة للبورقيبية وإحكام السيطرة على المجتمع وعلى الفضاء السياسي بالخصوص عن طريق احتكار النشاط السياسي الشرعي وإخراج ما بقي من تنظيمات مستقلة من دائرة الشرعية (حل الحزب الشيوعي). كما مكنت المناسبة من تصفية اللوبي الذي كان يشكله المقاومون القدامى حيث سيصار إلى إقصائهم المنهجي من التاريخ الرسمي.
لقد ولدت الدولة الوطنية، دولة الاستقلال، من رحم إيديولوجيا تحديثية لا تستند على المؤسسات مثلما تقتضي ذلك الحداثة، بل على وجود زعيم مفعم بالنرجسية. وبديهي أن تكون لهذه الولادة المشوهة لمشروع الدولة الوطنية انعكاسات بعيدة المدى على مسارها. لقد اعتقد بورقيبة باستمرار أنه الروح التي نفخت في جسد اسمه الشعب التونسي، وأن خروج الروح من الجسد يتبعها موته وتحلله لا محالة. وقد قيض له أن يجد من يسانده في تثبيت هذه الفكرة، خوفا أو طمعا. من هنا فقد ظل هو والمؤمنون به يعتقدون في قصور هذا الشعب الذي يفترض أنهم المعبرون عن إرادته الحرة، فأصبحوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون يفكرون ويقررون ويحلمون عوضا عنه، يدركون مصالحه ويعطفون عليه أكثر منه. أما المارقون العاقون ، رؤوس الفتنة والمغرر بهم، فإلى المحاكم والسجون والمنافي يقادون، ومن الأمة يقصون. لم يكن غريبا أن يؤدي هذا المسار إلى مزيد من انغلاق الحكم وفساد وتكلس المؤسسات وترهل الدعاية وتهرم الزعامة، في مواجهة هدير الفئات الجديدة المثقفة والمتعلمة والجائعة والمتنمرة لتحقيق إنسانيتها ومواطنتها. بل إن ما كان بالإمكان تقديمه كذريعة للتأمل ثم الانفتاح فالتجدد (1968، 1969، 1972، 1978، 1981، 1984)، لن يكون في الحقيقة سوى مناسبة لزيادة التقوقع ودس الرأس أعمق في الرمل.
قد نختلف في معنى الاستقلال وتعريفه وقد نتفق، قد يرى البعض أنه لم يعد له من معنى في عالم اليوم المفعم بالعولمة وقد يصر البعض الآخر على أن في العولمة من الحسنات ما يغطي على السيئات. ولكن أين الإنسان من كل ذلك؟ أليس مفترضا أن يكون هو أصل الأشياء وغاية العمل؟ لقد كان هدف الاستقلال بناء دولة وإنشاء أمة، غير أن ذلك تم على غير النحو المراد وبإتباع أيسر السبل، فأصبحت الدولة هي الغاية وما عداها الأداة. وإمعانا في الاختزال أصبح الحكم هو الدولة، وأصبحت للحكم مسالك معينة لا يقوى على الخروج منها. وفي المقابل حافظت المؤسسات على الخطيئة الأصلية، لقد أنشئت لتعاضد الحكم لا لتبني دولة الحداثة، أما الإنسان فكان يتوجب عليه أن يتجمل دوما بصبر لا ينفذ، أن ينتظر دوره على لائحة أهداف الدولة الوطنية، وأن يزيد إيمانا بأن الأهم يسبق دائما المهم، وبأنه ليس الأهم. لقد أسست نرجسية بورقيبة وتزلف الذين في قلوبهم مرض لواقع لن يكون تجاوزه هينا: واقع أن "المواطن" أفضل بدون المواطنة. لكن التاريخ، قريبه وبعيده، ماثل أمامنا ليعلمنا أن دولة لا تقوم على المواطنة مشروع تعوزه أهم عوامل الاستمرار.
متى تقوم دولة المواطنة؟
عدنان المنصر
مقال صادر بجريدة الموقف بتاريخ 23 مارس 2007
تمر هذا الأسبوع الذكرى الواحدة والخمسون على نيل تونس "استقلالها التام"، ففي يوم 20 مارس 1956 قطعت البلاد خطوة إضافية، ولكنها لن تكون الأخيرة، في سبيل الإنعتاق من الهيمنة الاستعمارية الفرنسية، تلك الهيمنة التي استمرت 75 عاما. وقد جاء إمضاء بروتوكول الاستقلال التام ليضع، بشكل رسمي، حدا لواقع ازدواجية السيادة التي أسستها اتفاقيات الاستقلال الداخلي حيث كان للفرنسيين إلى حد ذلك التاريخ القول الفصل في معظم الميادين الحساسة.
لا شك أن الحدث كان هاما بالنسبة لمن عاش تلك الفترة، ولا شك أنه يبقى ذا قيمة هامة أيضا لنا اليوم، غير أن ذلك ليس داعيا لتقديسه إلى الحد الذي ينسينا ما رافقه وتلاه من مآس لازلنا نتجرع مرارتها إلى اليوم. فبين الحدثين حصلت أعمال رهيبة من القتل والترهيب في إطار ما سمي "بالفتنة اليوسفية" ، وغاصت البلاد في هوة التقاتل الأهلي زمنا ليس بالقصير، وتواجه رفاق السلاح السابقين في معارك طاحنة سخر لها كل طرف ما استطاع من حلفاء ومساندين، تحت قيادة إخوة أعداء فرقتهم سبل السياسة . لن نتوقف هنا عند مراحل هذا الصراع الذي كتب وسيكتب حوله الكثير، ولن نضع نصب أعيننا تحميل المسؤولية عنه إلى طرف دون غيره، فالجميع كان مسؤولا وإن بدرجات متفاوتة. إنما همنا هنا أن نؤكد على أن حدث الاستقلال لم يكن الحدث الذي نعتقد اليوم أنه كان، فقد غطت عليه آنذاك أخبار المداهمات والاختطافات والاغتيالات والمحاكمات والإعدامات... وأن الوضع الذي ستنشأ في خضمه دولة الاستقلال سيكون محددا أساسيا لطبيعة السلطة الجديدة. لقد كانت سلطة نشأت في خضم الصراع الأهلي، على يد زعامات مؤمنة شديد الإيمان بأنها مهددة في صميم دورها التاريخي بل وفي وجودها المادي. وغني عن التوضيح هنا أن التهديد اليوسفي الذي كان جديا إلى أبعد الحدود قد استعمل من الجانب البورقيبي "كفزاعة" لإقناع الفرنسيين بتجنيد أكبر جهد ممكن لمقارعة الخصم المشترك، مما يجعل من "اليوسفيين" ضمنيا شركاء في تحقيق "الاستقلال التام". غير أن ما سيحدث لاحقا كان مختلفا. فقد اعتبر اليوسفيون مغلوبين يجدر الانتقام منهم والتنكيل بهم، فتواصلت المحاكمات والتتبعات بل والإعدامات والاغتيالات، وكانت تلك فرصة استغلها بعض الأتباع للإفصاح عن مهاراتهم المكنونة.
من هنا لم يكن هناك بد من اعتبار البورقيبيين أنفسهم منتصرين، فشرعوا في بناء الدولة الجديدة بكثير من التشفي قي خصومهم الحقيقيين والمفترضين. وليس من الوارد هنا أن ننكر وطنية الزعامات التي وضعت على عاتقها مهمة بناء الدولة كما مهمة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فهذه الزعامات وبخاصة بورقيبة ظلت تعتقد أن الاستقلال التام مجرد مرحلة على طريق بناء بعيد المدى سخرت له كل إمكانيات الكيان الفتي. كان التحديث هو الهدف النهائي لهذه النخبة الوطنية، وكان سعيها نحو هذا الهدف حثيثا، في إطار حماس شعبي فياض. كان التحديث يهدف إلى إنشاء إنسان جديد في وطن جديد، فكان إصلاح التعليم وإصلاح القضاء والأحوال الشخصية... إلى غير ذلك مما نتنعم اليوم ببعض ثماره. غير أن هذا التحديث لم تصاحبه حريات حقيقية تسمح للتونسيين بهامش ولو ضيق من الاختلاف مع الإيديولوجيا المنتصرة. فحكمت النخبة الجديدة على "الثقافة التقليدية" بالزوال، واستحوذت على صلاحيات كانت باستمرار عصية على الحاكمين، فنصب بورقيبة نفسه مفتيا ومعلما وإماما بل ورسولا. وبالموازاة مع ذلك انطلق مسار من التأليه لبورقيبة ستسخر له إمكانيات الدولة جميعها، كما ستسخر له ماكينة حزبية فعالة. ولن تعيق عملية بناء المؤسسات الجمهورية، بما في ذلك الدستور والبرلمان، هذا المسار، حيث نجح بورقيبة في بناء نمط من النفوذ يخترق كل المؤسسات، بل نجح في إقناع جانب من التونسيين بأن وجوده ضمانة لحسن سير المؤسسات. لذلك فقد كان التونسيون مستعدين ليغفروا له هفواته، فقد كان أباهم الذي على الأرض. لذلك فلم يكن من الصعب عليه أن يقنعهم أن وجودهم وفرحة حياتهم مرتبطة به، وأن "القائد في الكفاح هو الضامن للنجاح". كانوا سيصبحون أيتاما لو قيض لبعض "المعتوهين" أو "المارقين" أن يضعوا حياته تحت التهديد. وفي المقابل كان هو يحسن استغلال الفرص للتخلص من مزيد من المناوئين. ففي أواخر 1962 أكتشف أمر المحاولة الانقلابية الشهيرة التي دبرها بعض قدماء المقاومين وبعض العسكريين بتعاون مع بعض اليوسفيين. كانت الفرصة مواتية للقضاء على آخر قلاع المعارضة للبورقيبية وإحكام السيطرة على المجتمع وعلى الفضاء السياسي بالخصوص عن طريق احتكار النشاط السياسي الشرعي وإخراج ما بقي من تنظيمات مستقلة من دائرة الشرعية (حل الحزب الشيوعي). كما مكنت المناسبة من تصفية اللوبي الذي كان يشكله المقاومون القدامى حيث سيصار إلى إقصائهم المنهجي من التاريخ الرسمي.
لقد ولدت الدولة الوطنية، دولة الاستقلال، من رحم إيديولوجيا تحديثية لا تستند على المؤسسات مثلما تقتضي ذلك الحداثة، بل على وجود زعيم مفعم بالنرجسية. وبديهي أن تكون لهذه الولادة المشوهة لمشروع الدولة الوطنية انعكاسات بعيدة المدى على مسارها. لقد اعتقد بورقيبة باستمرار أنه الروح التي نفخت في جسد اسمه الشعب التونسي، وأن خروج الروح من الجسد يتبعها موته وتحلله لا محالة. وقد قيض له أن يجد من يسانده في تثبيت هذه الفكرة، خوفا أو طمعا. من هنا فقد ظل هو والمؤمنون به يعتقدون في قصور هذا الشعب الذي يفترض أنهم المعبرون عن إرادته الحرة، فأصبحوا من حيث يشعرون أو لا يشعرون يفكرون ويقررون ويحلمون عوضا عنه، يدركون مصالحه ويعطفون عليه أكثر منه. أما المارقون العاقون ، رؤوس الفتنة والمغرر بهم، فإلى المحاكم والسجون والمنافي يقادون، ومن الأمة يقصون. لم يكن غريبا أن يؤدي هذا المسار إلى مزيد من انغلاق الحكم وفساد وتكلس المؤسسات وترهل الدعاية وتهرم الزعامة، في مواجهة هدير الفئات الجديدة المثقفة والمتعلمة والجائعة والمتنمرة لتحقيق إنسانيتها ومواطنتها. بل إن ما كان بالإمكان تقديمه كذريعة للتأمل ثم الانفتاح فالتجدد (1968، 1969، 1972، 1978، 1981، 1984)، لن يكون في الحقيقة سوى مناسبة لزيادة التقوقع ودس الرأس أعمق في الرمل.
قد نختلف في معنى الاستقلال وتعريفه وقد نتفق، قد يرى البعض أنه لم يعد له من معنى في عالم اليوم المفعم بالعولمة وقد يصر البعض الآخر على أن في العولمة من الحسنات ما يغطي على السيئات. ولكن أين الإنسان من كل ذلك؟ أليس مفترضا أن يكون هو أصل الأشياء وغاية العمل؟ لقد كان هدف الاستقلال بناء دولة وإنشاء أمة، غير أن ذلك تم على غير النحو المراد وبإتباع أيسر السبل، فأصبحت الدولة هي الغاية وما عداها الأداة. وإمعانا في الاختزال أصبح الحكم هو الدولة، وأصبحت للحكم مسالك معينة لا يقوى على الخروج منها. وفي المقابل حافظت المؤسسات على الخطيئة الأصلية، لقد أنشئت لتعاضد الحكم لا لتبني دولة الحداثة، أما الإنسان فكان يتوجب عليه أن يتجمل دوما بصبر لا ينفذ، أن ينتظر دوره على لائحة أهداف الدولة الوطنية، وأن يزيد إيمانا بأن الأهم يسبق دائما المهم، وبأنه ليس الأهم. لقد أسست نرجسية بورقيبة وتزلف الذين في قلوبهم مرض لواقع لن يكون تجاوزه هينا: واقع أن "المواطن" أفضل بدون المواطنة. لكن التاريخ، قريبه وبعيده، ماثل أمامنا ليعلمنا أن دولة لا تقوم على المواطنة مشروع تعوزه أهم عوامل الاستمرار.





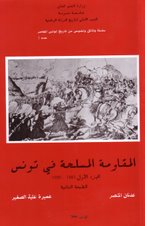



1 commentaire:
اكتشاف سعيد و أمل جديد بمستوى تدوين رائع
تحياتي
Enregistrer un commentaire